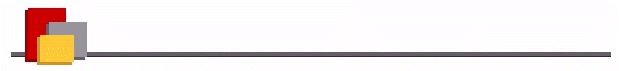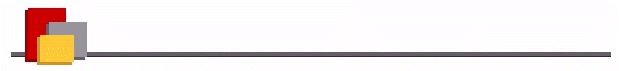
رسالة
إلى أمي
أمي الحبيبة ؛
أكتب إليك هذه الكلمات وأنت تجتازين المنطقة الفاصلة بين الحياة والموت ولدي شعور
قوي بأن ما أكتبه لك سيصلك بطريقة أو بأخرى.
أمي الحنونة ؛
أول ما أريد قوله لك وأنت في محنتك.. أنني أنا نفسي الآن في محنة..
لقد أخطأ من ظنً أن حبل المشيمة ينقطع بعد الولادة.. فأنا أشعر أنني لازلت بداخلك..
وأنك الآن فقط تلفظينني إلى عالمي الجديد.. عالم سأشعر فيه بالبرد،فقد كنت ملاذي
الآمن الوحيد وغطائي الذي بدأ ينحسر عني الآن رويداً رويداً.
معاناتي يا حبيبتي لا تقل عن معاناتك لكنها ستكون أطول بكثير..
لقد هزّني احتضارك كما لم يهزّني حدث آخر..
لماذا المعاناة ؟
ولماذا هذا الألم العنيف ؟
ما هي الحكمة من هذا الاحتضار ؟
ولماذا كلما دخلنا عالماً وودعنا عالماً علينا عبور جسر العذاب هذا ؟
لدى ولادتنا ودعنا عالماً لا أدري عن كنهه شيئا: كل ما أدريه أننا استقبلنا عالمنا
هذا بالبكاء.. غير أنّه كان هناك من يستقبلنا بالزغاريد غير عابئين البتة ببكائنا.
فهل هناك يا أمي من سيكون بانتظارك بالزغاريد عند الطرف الآخر ؟ آمل ذلك وأتمنى أن
تجدي مستقراً جديداً يكون أكثر كرماً معك من المكان الذي تغادريه الآن.
أمي الغالية ؛
سيكون للحياة طعم آخر بدونك, طعم مختلف جداً عما عهدته من قبل..
سأفقد فيك الحب المجنون لدرجة الغيرة والتضحية الكبيرة لدرجة نكران الذات والعزوف
عن الزواج بعد رحيل أبي.. لقد كنت أنا لك كل شيء..
ومما يحز في نفسي أنك لم تكوني كذلك بالنسبة لي: فلقد شاركك أفراد عائلتي وعملي
وأبعدني القدر عنك لبلاد الصقيع لكنك كنت مزروعة بداخلي على الدوام ولم تفارقيني
ولو ليوم واحد.
لقد حاولت يا أمي أن أوفق بين جميع المهام التي أوكلتِها إلي في هذه الحياة..
مبتعداً عن أي من المحرمات التي نهيتني عنها منذ صغري.. فهل يا ترى نجحت في أن أكون
ولداً باراً بأمه مخلصاً لعائلته كما أردت ؟
سامحيني يا حبيبتي عن كل ما بدر مني من إساءة أو تقصير تجاهك، فأنا بشر أبعد ما
أكون عن الكمال وأنت الآن على مشارف التحرر من الرداء البشري فهل يا ترى ستقبلين
اعتذاري ؟
أم جورج ؛
صوتك القادم من نبعة الفجيعة عبر الهاتف يقول لي:
" لقد بركت يا أبني ولم أعد أقوى على الحراك .."
هزّني وأودى بي إلى جحيم من التفكير كنت طوال عمري أرهب من الاقتراب منه.
أين شموعك التي لم تنطفئ يا أمي ؟
أين صلاتك التي لم تنقطع لي ولعائلتي ولجميع أحبائك ؟
هل نسيت نفسك يا حبيبتي أم أن من كنت تضرعين لهم ليس لهم قيمة أكثر من الحبر
المستخدم في رسم صورهم الأسطورية على الورق اللامع ؟
لم أسمعك يوماً إلاّ وأنت تشكرين الله على كل صغيرة وكبيرة: فإن أمطرت السماء شكرت
الله, وإن صحت شكرت الله, وإن نجحتِ في إشعال المدفأة شكرت الله, وإن ظهرت الصورة
على التلفزيون واضحة شكرت الله, فهل هذا الله معك الآن وأنت في سكرات الموت؟
أنا شبه متأكد من أنه هو هو في استقبالك
وأن ملائكته هي هي التي تلقاك بالزغاريد في مستقرك الجديد.
من رحم الألم والأمل أكتب لك هذه الكلمات وتعصف بي هذه الأفكار في هذه اللحظات..
وسيكون بإمكانك خلال ساعات قليلة يا أمي الإجابة على كل هذه التساؤلات وسيهدأ
بالك.. لكن نفسي لن تهدأ أبداً.
يا معلمتي الكبيرة ؛
هل كان تعلقي الشديد بك هو الذي دفعني – بدون أن أخطط – أن أمتهن التدريس مثلك ؟
لقد كانت ولا تزال الحبال التي تشدني بك متينة ولا أعتقد أنها ستضعف يوماً.
تلك هي الحبال التي جعلتني بدون أي سبب أن أهتف إليك فجأة من بلاد الصقيع، وعندما
لم أجدك في منزلك، أهتف إلى خالي وأسأله عنك مما أثار دهشة الجميع الكبيرة.. فقد
كانوا قادمين للتو من زيارة الطبيب الذي أنبأهم أن المرض قد استفحل بك ولا يمكن عمل
شيء.
صُعقت للخبر كما هم صُعقوا لمكالمتي في تلك اللحظة بالذات.. ولم أقوى على الكلام
وأحسست وكأن الزمن قد توقف تماماَ والظلام قد أحاط بي من كل جانب وبدأ طعم من
المرارة ينتشر في فمي ولن يزول هذا الطعم بعد اليوم.
الخميس 10 آذار 1999
" أمك ماتت في غيبوبتها وهي هادئة وادعة كالملاك.."
بتلك الكلمات نقلت لي زوجتي خبر رحيلك والأصح خبر رحيل جزء مني.
بالرغم من أني كنت مهيأ لاستقبال الخبر.. فلم أستوعب الكلمات في البداية وأحسست
برعدة تسري في جسدي وأن الرداء الذي غطّاني لنصف قرن ونيّف وردّ عني البرد قد سقط
عني فجأة، والآن فقط أصبحت وحيداَ.
عندما كان الناس يسألونك عني كنت ترددين الدعاء الدمشقي التقليدي:
" ملائكة السماء والأرض ترضى عليه .."
فيا أمي.. يا حبيبتي.. يا ليندا؛
قولي للملائكة اللذين كلفتهم بحراستي طوال هذه الأعوام أن لا يتركوني لأني بعد
رحيلك أخاف أن أكون وحدي.
جورج خوام
أعلى
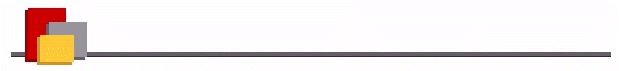
في الثلاثين من شهر نيسان من عام 1997 مات نزار في
لندن.
توقف قلبه عن العمل، كما يتوقف قلب حصان فجأة من شدة
الإعياء وطول المسيرة.
كان نزار أميرا دمشقيا جميلا قتله العشق، فالعلاقة
العاطفية بينه وبين ذبحة القلب قد تأصلت، وكان يعرف أن ذبحة القلب هي
امرأة خبيرة بلعبة الحب، ترسم مخططاتها الهجومية بدقة وأناة وصبر طويل،
ولو استغرق ذلك عشرات السنين.
ذبحة القلب هي امرأة من النوع الزئبقي المتقلب التي لا
تعرف متى تكرهك ومتى تشتهيك، امرأة شهوانية ومجنونة تطارد من تختارهم
من الرجال، وتغتصبهم اغتصابا علنيا أينما تجدهم، في المقهى، في المكتب،
في المصعد، في السيارة أو حتى على سريرهم الزوجي، دون أن يكون لديهم
الوقت للصراخ أو طلب شرطة النجدة.
مات نزار…
ما أن انتشر الخبر، حتى أصيب العالم العربي، كل العالم
العربي بالوجوم. ثم لم تلبث أن بدأت الأقلام التي تجاوزت مرحلة الصدمة
في الكتابة عن نزار.
في دمشق أعطوه شارعا، وفي لبنان نعاه رئيس الجمهورية،
ولم تخل صحيفة عربية في العالم العربي أو ندوة تلفزيونية من حديث عن
رحيل الشاعر العاشق..
لكن العرس الحقيقي كان في دمشق... عرس على الطريقة الدمشقية، بناء على
رغبة العريس..
آه ما أروع الموت بين العرب.. ومع العرب.
آه ما أروع الانتماء إلى القبيلة.
رحيل نزار أعاد العرب إلى بدويتها، وكأن بني هاشم، وبني
تغلب، وبين مخزوم، وبني تميم، وبني شيبان قد أبو إلا أن يشاركوا في
احتفالات رحيل الشاعر العاشق، كما شاركهم هو كل همومهم في رحلته
الخرافية.
يا ليتكم حضرتم عرس نزار في دمشق.
كل المآذن رفعت أعناقها لترى نزار، كل ياسمين دمشق فرش
تحت رأسه وسادة بيضاء، كل قلوب دمشق رافقت طائرته وهي تنزل.. تنزل..
تنزل كالدمعة على خد دمشق.
زغردت النساء وهن يبكين، وأبت إلا أن تكسر التقاليد
وترافق نزار إلى الجامع. أما شبان دمشق، فأبوا إلا أن يحملوه على
أكتافهم في يوم قائظ الحر، وفي طريق طويل طويل اخترقت الشام من شارع
نزار قباني في أحدث أحياء دمشق إلى الباب الصغير في أعتق أحيائها، وطول
الطريق كانت تسمع أصوات الزغاريد تشق عنان السماء المغطاة بالياسمين
المنهمر من الشرفات، بينما راح الشباب يرقصون كزوربا حول العريس
المحمول وهم يهزجون:
زينوا المرجة، والمرجة لينا
شامنا فرجة، وهي مزينة
ما
من جامع مرت أمامه زفة العريس إلا وكبرت مآذنه، وما من كنيسة إلا قرعت
أجراسها.
لقد منح
رحيل الأمير الجميل العالم العربي لحظات من القشعريرة القومية لم
نعهدها منذ حرب تشرين، فجرت كل ينابيعنا، وأضاءت كل القناديل المطفأة
في داخلنا.
لقد ملأ نزار قباني الدنيا حقا وشغل الناس، فترك
بصماته على عصر بكامله وامتلك مساحة أكثر من خمسين سنة من الزمان
العربي، وهي مساحة لم يشغلها أي حاكم أو قائد عربي، وهذا بحد ذاته كاف
لدخوله مادة التاريخ مع أئمة الشعراء العرب.
لقد خرج نزار عن سلطة الماضي بكل أنواعه: الأبوية
والعائلية والقبلية، وأعلن العصيان على كل الصيغ والأشكال الأدبية التي
أخذت - بحكم مرور الزمن – شكل القدر أو شكل الوثن.
لقد كان نزار شاعرا خارج التصنيف، وخارج الوصف
والمواصفات: فلا هو تقليدي ولا هو حداثوي، لا هو كلاسيكي ولا هو
نيوكلاسيكي، لا هو رومانسي ولا هو رمزي، لا هو ماضوي ولا هو مستقبلي.
نزار "خلطة " صعب تحليلها مخبريا، لقد كان "خلطة حرية
"، حرية سمحت له بأن يلبس اللغة التي شاء في الوقت الذي شاء، حرية
الزواج من القافية ذات ليلة… وتطليقها في اليوم التالي، حرية كتابة
قصيدة التفعيلة أو القصيدة الدائرية أو قصيدة النثر.
لقد آمن نزار بأن الشعر موجود في عيون الناس، وفي
أصواتهم، وفي عرقهم ودموعهم وضحكاتهم، وأن وظيفته كشاعر هي أن ينقل
المشهد الشعبي الكبير، وهذا ما فعله خلال خمسين عاما ونيف.
وماذا بعد نزار ؟
إن حدث نزار قباني هو حدث غير عادي، وظاهرة نادرة
الحدوث، ولكنها ليست مستحيلة الحدوث… فرحم الياسمين الذي حبل به قادر
على أن يحبل بغيره، وفل دمشق الذي مازال منذ طفولة الدهر يزهر كل عام
سوف يواصل عبقه في كل موسم.
لقد كتب لنا وعنا نزار الكثير، وسيبقى حيا بيننا يتسلق
عناوين كتبه ويركض بين حروفها كما يركض أرنب بين سنابل القمح:
يا
رُبَّ حـيٍّ.. رخامُ القبرِ مسكنـه
ورُبَّ ميّتٍ.. على أقدامـهِ انتصـبا
وعلينا نحن أخذ الشعلة من بعده ومتابعة المسيرة، لأنه
لو توقفنا عنده، يمكن عندها فقط أن نعتبر أن نزار قد مات.
كلمات نزار ستبقى شعلة لا تطفئ في داخلنا
صرخة نزار للعالم في قصيدته " أنا مع الإرهاب" ستبقى
داوية مجلجلة تهز الظالم أينما وجد:
أنا مع الإرهاب
إن كان مجلس الشيوخ في أمريكا
هو الذي في يده الحساب
وهو الذي يقرر الثواب والعقاب !!
وجع
نزار في قصيدته " المهرولون" ستهز الضمير العربي المسلوب الإرادة في
كل زمان "
ليسَ هذا العرسُ عرسي..
ليسَ هذا الثوبُ ثوبي..
ليسَ هذا العارُ عاري..
أبداً.. يا أمريكا..
أبداً.. يا أمريكا..
أبداً.. يا أمريكا..
مناشدة نزار لخالد ابن الوليد في قصيدته "من مفكرة عاشق
دمشقي" ستظل محركا لأجيال وأجيال من المقاومة:
يا ابنَ الوليـدِ.. ألا سيـفٌ تؤجّرهُ؟
فكلُّ أسيافنا قد أصبحت خشبا
لقد خرج نزار من مساحة بيته عندما رحل، لكنه سكن في
قلوب ملايين العرب وسيبقى هناك طالما عبق الياسمين وحيثما اجتمع
المحبين وأينما صرخ المقهورين.
جورج خوام
أعلى
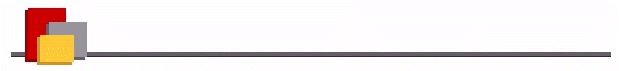
| الاسم
: |
نزار
توفيق قباني
|
|
تاريخ الميلاد : |
آذار
(مارس) 1923
|
| محل
الميلاد: |
حي مئذنة
الشحم ..أحد أحياء دمشق القديمة
|
|
الأسرة: |
أسرة
قباني من الأسر الدمشقية، من أبرز أفرادها أبو خليل القباني،
وهو أحد مؤسسي المسرح العربي في القرن الماضي. |
| |
يقول
نزار عن والده توفيق قباني أنه كان من رجالات الثورة السورية
ومن ميسوري الحال يعمل في صناعة السكاكر وله محل معروف، وكان
نزار يساعده في عملية البيع عندما كان في صباه ..
|
| |
أنجب
توفيق قباني ستة أبناء: نزار، رشيد، هدباء، معتز، صباح ووصال
التي قضت منتحرة في ريعان شبابها.
|
|
الحالة الأجتماعية: |
تزوّج مرتين .
المرة الأولى من سورية تدعى " زهرة " وانجب منها هدباء وتوفيق
وزهراء . |
| |
وقد توفي
توفيق بمرض القلب وعمره 17 سنة، وكان طالباً بكلية الطب جامعة
القاهرة، ورثاه نزار بقصيدة وكتابات مؤثرة وأوصى بأن يدفن
بجواره بعد موته . |
| |
والمرة
الثانية من " بلقيس الراوي"، العراقية .. التي قُتلت في انفجار
السفارة العراقية ببيروت عام 1982، وترك رحيلها أثراً نفسياً
سيئاً عند نزار ورثاها بقصيدة شهيرة تحمل اسمها، حمّل الوطن
العربي كله مسؤولية قتلها .. |
| |
لنزار من
بلقيس ولد اسمه عُمر وبنت اسمها زينب . وبعد وفاة بلقيس رفض
نزار أن يتزوج . |
| |
وعاش
سنوات حياته الأخيرة وحيدا في شقة بالعاصمة الإنجليزية .
|
|
لمؤهلات الدراسية والمناصب: |
حصل نزار
على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق، ثم
التحق بكلية الحقوق بالجامعة السورية وتخرّج فيها عام 1945 .
|
| |
عمل فور
تخرجه بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السورية، وتنقل في
سفاراتها بين مدن عديدة، خاصة القاهرة ولندن وبكين ومدريد،
وبعد إتمام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، تم تعيينه
سكرتيراً ثانياً للجمهورية العربية المتحدة في سفارتها بالصين
.
|
| |
استقال من العمل الدبلوماسي
في ربيع عام 1966، وأسّس دارا للنشر في بيروت باسمه، متفرّغا
بذلك لقدره الوحيد: الشعر.
|
|
قصته مع الشعر: |
ركّز في بداياته على شعر
الحب. وحاول أن يُخرج علاقات الحب في المجتمع العربي من مغائر
القهر، والكبت، والباطنية، إلى ضوء الشمس، ومنحها العلنية
والشرعية.
كسر صورة المرأة الجارية، وحوّل جسد المرأة العربية من وليمة
بدائية، تُستعملُ فيها الأنياب والأظافر، إلى معرض أزهار.
اخترع لنفسه لغة خاصة به، تقترب من لغة الحوار اليومي، واتجه
بشعره إلى جميع طبقات الشعب العربي، كاسرا بذلك جدار الخوف بين
الشعر وبين الناس، بحيث أصبح الشعر على يده خبزا يوميا، وقماشا
شعبيا يرتديه 200 مليون عربي.
يعتبر نزار من أكثرُ شعراء العربية شعبية، وشهرة، وانتشارا.
وأكثرهم تأثيرا في وجدان مواطنيه، وأوّل من (أمّم) الشعر،
وجعله حديقة عامة يدخلها جميع المواطنين، ومطرا يسقط على جميع
النوافذ.
كتب الشعر وهو في السادسة عشرة من عمره (1939)، وكان ديوانه
الأول (قالت لي السمراء) الصادر عام 1944، زلزالا شعريا ضرب
أساسات الشكل والمضمون في القصيدة العربية.
ومنذ هذا الديوان الانقلابي وهو يقاتل حتى يصبح البحر أكثر
زرقة.. والأشجار أكثر ورقا.. وقامة الإنسان أكثر ارتفاعا..
والحرية أكثر حرية..
أمسياته الشعرية التي قدّمها في كل المدائن العربية، اعتبرت من
الظواهر الثقافية النادرة، كما أكدت موقع الشعر الخطير في حياة
العرب، وفي تشكيل وجدان الإنسان العربي.
اضطرته ظروف الحرب اللبنانية وخاصة بعد مقتل "بلقيس" إلى
مغادرة بيروت عام 1982
تنقل نزار في باريس وجنيف حتى استقر به المقام في لندن التي
قضى بها الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من حياته.
ومن لندن كان نزار يكتب أشعاره ويثير المعارك والجدل ..خاصة
قصائده السياسة خلال فترة التسعينات مثل : متى يعلنون وفاة
العرب، والمهرولون، والمتنبي، وأم كلثوم على قائمة التطبيع .
انتقل شعرُهُ بعد هزيمة 1967 نقلة نوعية، من شعر الحب.. إلى
شعر السياسة، واستطاع منذ ذلك التاريخ أن يمسك الوردة والمسدس
بيد واحدة.
أصدر اثنتين وأربعين مجموعة شعرية ونثرية بدءا من مجموعته
الشعرية الأولى (قالت لي السمراء 1944) حتى مجموعته الشعرية
والنثرية الأخيرة (إضاءات الصادرة عام 1998).
|
|
صدمات أثرت في مسيرة شعر نزار: |
انتحار شقيقته الصغرى وصال،
وهي ما زالت في ريعان شبابها.
وفاة أمه التي كان يعشقها .. كان هو طفلها المدلّل وكانت هي كل
النساء عنده.
وفاة ابنه توفيق من زوجته الأولى والذي كان طالباً في كلية
الطب بجامعة القاهرة .. أصيب بمرض القلب وسافر به والده إلى
لندن وطاف به العديد من المستشفيات وأشهر العيادات .. ولكن
قضاء الله نفذ وكان توفيق لم يتجاوز 17 عاماً .
مقتل زوجته "بلقيس الراوي" العراقية في حادث انفجار السفارة
العراقية ببيروت عام 1982 .
نكسة 1967 .. والتي أحدثت شرخاً في نفسه، وكانت حداً فاصلاً في
حياته، جعله يخرج من مخدع المرأة إلى ميدان السياسة .
|
|
معارك نزار: |
سبب له خطابه الشعري – سواء
العاطفي منه أو السياسي – معارك عديدة منذ أن دخل مملكة الشعر
بديوانه الأول " قالت لي السمراء " عام 1944 وانتهاء بقصيدته "
المهرولون" التي حاول الكاتب الكبير نجيب محفوظ أن يتصدى لها..
و أصبحت حياة الشاعر معركة دائمة مع معارضيه. أبرز تلك المعارك
كانت:
معركة قصيدة " خبز وحشيش وقمر " التي أثارت رجال الدين في
سوريا ضده، وطالبوا بطرده من السلك الدبلوماسي، وانتقلت
المعركة إلى البرلمان السوري وكان أول شاعر تناقش قصائده في
البرلمان .
معركة " هوامش على دفتر النكسة " . التي كتبها في أعقاب حرب
عام 1967، ومارس فيها نقدا سياسيا جارحا للتقصير العربي، فأثار
عليه ذلك غضب اليمين واليسار معا. . فقد أثارت القصيدة عاصفة
شديدة في العالم العربي، وأحدثت جدلاً كبيراً بين المثقفين ..
ولعنف القصيدة صدر قرار بمنع إذاعة أغاني نزار وأشعاره في
الإذاعة والتلفزيون .
في عام 1990 صدر قرار من وزارة التعليم المصرية بحذف قصيدته "
عند الجدار " من مناهج الدراسة بالصف الأول الإعدادي لما
تتضمنه من معان غير لائقة .. وقد أثار القرار ضجة في حينها
واعترض عليه كثير من الشعراء في مقدمتهم محمد إبراهيم أبو ستة
..
المعركة الكبيرة التي خاضها ضد الشاعر الكبير "أدونيس" في
أوائل السبعينات. قصة الخلاف تعود إلى حوار مع نزار أجراه،
منير العكش، الصحفي اللبناني ونشره في مجلة مواقف التي يشرف
عليها أدونيس . ثم عاد نزار ونشر الحوار في كتيب دون أن يذكر
اسم المجلة التي نشرت الحوار … فكتب أدونيس مقالاً عنيفاً
يهاجم فيه نزار الذي رد بمقال أعنف .
وتطورت المعركة حتى كادت تصل إلى المحاكم لولا تدخل أصدقاء
الطرفين بالمصالحة .
عام 1990 أقام دعوى قضائية ضد إحدى دور النشر الكبرى في مصر،
لأن الدار أصدرت كتاب " فتافيت شاعر " متضمناً هجوماً حاداً
على نزار على لسان الناقد اللبناني جهاد فاضل .. وطالب نزار بـ
100 ألف جنيه كتعويض وتم الصلح بعد محاولات جاهدة .
آخر تلك المعارك كانت مع الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي تصدى
لقصيدته "المهرولون " فتمنى عليه نزار، بمقال لبق على صفحات
"الحياة"، أن يبقى الكاتب الأول للقصة العربية ويترك نقد
الشعر…
|
|
وافته المنية
في لندن يوم 30/4/1998 عن عمر يناهز 75 عاما قضى منها 50 عاماً
بين الفن والحب والغضب . |
دواوينه الشعرية:
|
قالت لي السمراء |
1944 |
|
طفولة نهد |
1948 |
|
سامبا |
1949 |
|
أنت لي |
1950 |
|
قصائد |
1956 |
|
حبيبتي |
1961 |
|
الرسم بالكلمات |
1966 |
|
يوميات امرأة لا مبالية |
1968 |
|
قصائد متوحشـة |
1970 |
|
كتاب الحب |
1970 |
|
100 رسالة حب |
1970 |
|
أحلى قصائدي |
1972 |
|
أشعار خارجة على القانون |
1972 |
|
أحبك أحبك والبقية تأتي |
1978 |
|
إلى بيروت الأنثى مع حبي |
1978 |
|
كل
عام وأنت حبيبتي |
1978 |
|
أشهد أن لا امرأة إلا أنت |
1979 |
|
هكذا اكتب تاريخ النساء |
1981 |
|
قاموس العاشقين |
1981 |
|
قصيدة بلقيس |
1982 |
|
الحب لا يقف على الضوء الأحمر |
1985 |
|
أشعار مجنونة |
1985 |
|
قصائد مغضوب عليها |
1986 |
|
سيبقى الحب سيدي |
1987 |
|
تزوجتك أيتها الحرية |
1988 |
|
ثلاثية أطفال الحجارة |
1988 |
|
الأوراق السرية لعاشق قرمطي |
1988 |
|
السيرة الذاتية لسياف عربي |
1988 |
|
الكبريت في يدي ودويلاتكم من ورق |
1989 |
|
لا
غالب إلا الحب |
1990 |
|
هل
تسمعين صهيل أحزاني |
1992 |
|
هوامش على دفتر النكسة |
1991 |
|
خمسون عاماً في مديح النساء |
1994 |
|
إضاءات |
1998 |
|
الشعر قنديل أخضر |
|
|
قصتي مع الشعر |
|
|
عن
الشعر والجنس والثورة |
|
|
المرأة في شعري وفي حياتي |
|
| أبجدية الياسمين |
1998 |
|
|
|
|
أمير
الشعر الغنائي:
|
|
|
على
مدى 40 عاماً كان المطربون الكبار يتسابقون للحصول على قصائد نزار
. |
| |
|
|
أم كلثوم : |
|
|
أصبح
عندي الآن بندقية |
ألحان
عبد الوهاب
|
|
رسالة
عاجلة إليك |
ألحان
عبد الوهاب
|
|
عبد
الحليم حافظ : |
|
|
رسالة
من تحت الماء |
ألحان محمد الموجي |
|
قارئة
الفنجان |
ألحان محمد الموجي
|
|
نجاة
الصغيرة: |
|
|
ماذا
أقول له |
لحان عبد الوهاب |
|
كم
أهواك |
ألحان عبد الوهاب |
|
سألك
الرحيلا |
لحان عبد
الوهاب
|
|
فايزة أحمد: |
|
|
رسالة
من امرأة |
ألحان محمد
سلطان
|
|
فيروز: |
|
|
وشاية |
ألحان عاصي الرحباني |
|
لا
تسألوني ما اسمه حبيبي |
ألحان عاصي
الرحباني
|
|
ماجدة
الرومي: |
|
|
بيروت
يا ست الدنيا |
ألحان د. جمال سلامة |
|
مع
الجريدة |
ألحان د. جمال سلامة |
|
كلمات |
ألحان إحسان
المنذر
|
|
كاظم
الساهر: |
|
|
اني
خيّرتك فاختاري |
الحان
كاظم الساهر |
|
زيديني
عشقاً |
الحان
كاظم الساهر |
|
علّمني
حبك |
الحان
كاظم الساهر |
|
مدرسة
الحب |
الحان كاظم الساهر
|
|
أصالة
نصري: |
|
|
اغضب |
الحان حلمي بكر |
أعلى
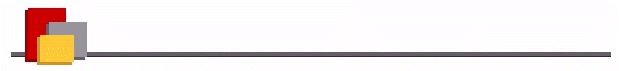
محمد
بغدادي
في بداية الستينيات دخل بيتنا ديوان صغير بحجم الكف.. ذو غلاف لامع..
تتوسط مساحته السوداء الداكنة.. مستطيلات صغيرة غير منتظمة ذات ألوان
زاهية متراصة في تكوين فني بسيط.. وفى أعلى الكتاب كلمة واحدة
"قصائد".. وأسفل الغلاف كتب بخط اليد فيما يشبه التوقيع "نزار قباني"..
كان هذا الديوان اشتراه أخي الأكبر- بعد فترة ادخار طويلة- بثلاثة
جنيهات كاملة.. وما أن دخل هذا الديوان بيتنا حتى صار أحد مقتنياتنا
العائلية الثمينة.. كنت في المرحلة الثانوية- أيامها- حين بدأت رحلة
البحث عن باقي دواوينه السابقة.. إذ كانت قصائده الجديدة جعلتني
أتساءل:
لماذا يفرضون علينا في المدارس أشعار" الصلتان العبدي" و"ابي صخر
الهزلى" و"المهلهل بن أبى ربيعة".. ولدينا كل هذه القصائد الرائعة؟!..
وكان قد دخلت بيتنا قبل هذا الديوان.. دواوين كثيرة هامة لشعراء
آخرين.. فقد سبقه لمنزلنا صلاح عبد الصبور بديوانيه "الناس في بلادي،
وأقول لكم ".. وسبقه أحمد عبد المعطى حجازى بديوانه "مدينة بلاقلب "..
وسبقه جبران خليل جبران.. "رمل وزبد،.. و"حديقة النبي".. وسبقه محمود
أبو الوفا "عنوان النسيد".. وكثيرون غيرهم.. وكانت " شوقيات " أحمد
شوقى تحتل ركنا كبيرا في (رفوف) المكتبة.. وكنت قد قرأت كل هذه
الدواوين التي كان يحضرها أخي.. وكان يكتب شعرا جميلا بالفصحى.. وكنت
أحاول أن أسجل تجاربي الأولى فى شعر العامية.. ورغم عمق وأصالة كل
هؤلاء الشعراء ورؤاهم الشعرية الجديدة.. إلا أن هذا الديوان- قصائد-
كان مختلفا وكأنه كتب لكي يحفظ أو يغنى.. فقرأته مرة.. وفى الثانية كنت
قد حفظت معظم قصائده دون أن أدرى.. واعتبرته يومها أنه شاعر من شعراء
العامية ضل طريقه للفصحى فأقام في منطقة وسطى بين العامية والفصحى !!.
وأصبح نزار قباني من وجهة نظرنا- نحن مثقفي-هذا الجيل -مجرد شاعر ماجن
يكتب عن "الحب والنساء" فقط ومرت السنوات.. واستيقظنا ذات مساء على
المشهد الدرامي الحزين لسقوط أمة بأكملها وربما عصر بأكمله بين أنياب
النكسة.. بمرارتها القاتلة وأظافرها الشرسة.. وبعدها توالت الأحداث ولم
نجد أمامنا متسعا من الوقت لكي نرسل رسائلنا التي سطرناها على ورق معطر
وزيناها بقصائد العشق والغزل التي سرقناها من دواوين نزار قباني سرا
لنرسلها إلى البنات اللاتي أحببناهن.
ألقينا رسائلنا في سلة الذكريات فقد كنا في حاجة للبكاء على حلمنا
الضائع.. فامتنعنا عن قراءة نزار سرا وجهرأ.
واعتبرنا- يومها- أنه من قبيل الخيانة للوطن أن نعود لنقرأ نزار أو
نستمتع به.. فلم يكن أمامنا إلا أن نثور ونتمرد وتحتقن أصواتنا بالهتاف
ضد من باعونا أو خدعونا.. وأسلموا حلمنا الجميل إلى الأيادي المعادية
لتخنق الحلم وتمثل بجثته أمام أعيننا.. فخرجنا غاضبين في مظاهرات 68
نطالب بمزيد من الحزم في محاكمة جنرالات النكسة الذين ضيعونا بلحظة.
وكما أثار نزار حوله العديد من ا لمعارك عندما كتب أشعاره عن الحلمات
والنساء.. أثار أيضا أضعاف هذه المعارك عندما كتب كراسته الصغيرة
"هوامش على دفتر النكسة" وانقسم الناس ما بين قراء ونقاد ومفكرين إلى
مؤيد ومعارض لقصيدة نزار الجديدة.
فقد صدرت "الهوامش " بعد الهزيمة بأقل من شهرين تنكىء الجرح وتضرب على
الوتر المشدود فلقيت رواجا مذهلا سواء من المعارضين أو المؤيدين. إذ
كانت القصيدة لحنا جنائزيا يستهوى الأفئدة. واعتبر معظم النقاد
المعارضين للقصيدة أن "الهوامش " موجة من موجات شعر"التشفي" التي
انتشرت في أعقاب النكسة والتي يعد نزار قباني أبرز وجوهها فكتب د. غإلى
شكرى يقول:
"كيف يتحول كاتب الهوامش بين غمضة عين وانتباهتها من شاعر الحب والحنين
إلى شاعر يكتب بالسكين (!!).. فأغلب الظن أن سكينه أخطأت مكان القلب من
العدو الرابض فوق أرضنا إلى شغاف القلب من الإنسان العربي المهزوم، ولا
تنطلي علينا هذه الخدعة البراقة التي يصدر بها نزار قصيدته لتبدو
وكأنها نقد ذاتي لعقل هذه الأمة ووجدانها بينما هي فى واقع الأمر نوع
من السادية التي يتلذذ فيها صاحبها مع لذاذاته السابقات في شعره
الجنسي، فالنرجسية هناك تقابلها السادية هنا"
ويواصل د. غإلى شكرى هجومه على نزار.. حتى يقول متهكما:
".. وأصبح شاعرنا نجما لامعا يتفوق على النجم الذي كانه في القديم..
واستمرأ اللعبة على نحو مختلف وواصل كتابة قصائده السياسية على نمط
الهوامش ".
وأيا كان موقف المعارضين والمؤيدين لقصيدة نزار. فان الموقف كان مختلفا
تماما بالنسبة لأبناء جيلنا.. فقد كان الكبار يحاسبون أنفسهم ويصفون
حساباتهم القديمة فيما بينهم.. وينصبون المحاكم والمشانق لبعضهم
البعض.. أما نحن أبناء الهزيمة.. فقد استقبلنا القصيدة بمنظور مغاير.
فقد كانت مظاهرات 68 لم تشف غليلنا واعتصامات الطلبة لم ترو عطشنا
للقصاص من قادة الهزيمة.. وخاصة أن الأحداث انتهت باعتقال ثلاثين طالبا
من قيادات الطلبة الغاضبين فجاءت القصيدة تحك الجرح وتشير بحروف مسنونة
كالحراب إلى أوجاعنا، وتجلد الذات والأمة العربية التي ترهل جسدها،
تهاوت فجأة بجوار حلمها الضائع تبكى خيبة أملها.
جاءت "الهوامش "- آنذاك- ونحن بعد صغار ساخطون ومتمردون على كل شئ
فتلقفناها كالعطشى نروى بها ظمأ السنين والحرمان من المشاركة الفعلية
فى الحياة السياسية.
وأول ما قرأت هذه العبارة:
"مالحة فى فمنا القصائد
مالحة ضفائر النساء
والليل والأستار والمقاعد
مالحة أمامنا الأشياء.. "
أحسست لحظتها أنه يتكلم بلساني ولسان جميع أبناء جيلي رغم تحذيرات
زعمائنا والمثقفين الذين نهونا عن تعاطى أشعار نزار قباني..
وفجأة تحول "بستان الاشتراكية" إلى أرض البوار.. والتماثيل الرخام التي
حلمنا بها- يوما- على الترعة والأوبرا.. تحولت إلى بلهارسيا.. ونواد
ليلية وكازينوهات على ذات النيل.. أما الأوبرا فقد احترقت بعد قليل
وأقيم بدلا منها (جراج) للسيارات متعدد الطوابق!!.
فماذا يكتب أي شاعر بعد أن أسدل الستار على هذا المشهد الدرامي
الكئيب؟!
كان كل ما تبقى في القلب غيظ مكتوم.. وأحزان ثقيلة مبهمة.
ووسط هذا الإحباط العام.. تسربت إلى أيدينا أوراق تداولناها فيما بيننا
بغموض وسرية.. كانت قادمة إلينا من بيروت، وكانت تلك الأوراق هي قصيدة
نزار قباني الشهيرة: "هوامش على دفتر النكسة ".
مهما اختلفنا أو اتفقنا مع الرجل.. فقد كانت بالفعل كل الأشياء مالحة..
وفى مرارة العلقم في حلوقنا.. وكنا قد فقدنا براءتنا ولهونا.. وحملنا
السلاح ولم يمض على امتلاكنا لبطاقاتنا الشخصية الجديدة سوى أيام
قليلة.. وكانت القصيدة إعلانا عن مقاطعة نزار للنساء.. فتبعنا خطاه..
وكنا كلما التقينا بفتياتنا نعلن لهن:
لا وقت للحب..
فمالحة في فمنا القصائد.. مالحة ضفائر النساء..
وتحولت مقاطع عديدة من قصيدة "الهوامش " إلى شعارات نرددها.. فقد صدقنا
نزار عندما قال:
يا وطني الحزين.. حولتني بلحظة
من شاعر يكتب شعر الحب والحنين
لشاعر يكتب بالسكين
فقد أحسسنا أن الشاعر قد راجع ذاته وأخذ يجلدها بنفسه.. وأنه نزع
قمصانه المزركشة التي يغوى بها النساء وارتدى سترته العسكرية ونزل معنا
لساحة القتال. لقد صدقناه.. رغم آراء المعارضين.. لأننا كنا بحاجة لأن
نصدق أحدا.. أي أحد.. لأننا فقدنا ثقتنا بكل شئ.. وإن كنت لا أدرى
لماذا اعتبرت جماعة المثقفين- آنذاك- أن قصيدة نزار من شعر التشفي..
والسادية.
لذا لم نعتبر نحن أبناء هذا الجيل أن "الهوامش " خدعة جديدة من نزار
قباني ليسرق من غيره الأضواء.. ليصير أكثر نجومية.. فقد لاقت القصيدة
كثيرا من القبول لدينا وطوعناها وفقا لرؤانا للأوضاع المتردية من
حولنا.
فعلى سبيل المثال.. أصبحنا نردد مقاطع ساخنة من "الهوامش " كلما
اصطدمنا بسلبيات الواقع، ففي مواجهة البيروقراطية.. والتخلف نورد من
"الهوامش ":
خلاصة القضية.. توجز في عبارة
لقد لبسنا قشرة الحضارة.. والروح جاهلية..
ما دخل اليهود من حدودنا
وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا
وظلت "هوامش على دفتر النكسة" تعيش بيننا لفترة طويلة.. نصورها..
ونتبادلها.. ونهـديها لصديقاتنا وأصدقائنا.. وندونها في كراسات
محاضراتنا.. ونستدعى مقاطعها الملائمة وقت الحاجة.. فقد أصبحت لسان حال
سخطنا على كل سلبيات ونواقص الوطن. فعندما قبض على زملائنا الطلبة في
المظاهرات عام 68.. أصبح المقطع رقم (17).. واحدا من أهم أغانينا
السرية.. نردده أينما كنا: إذ يقول نزار فى هذا المقطع:
لو أحد يمنحني الأمان..
لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان
لقلت له ياسيدي السلطان
كلابك ا لمفترسات مزقت ردائي
وجنودك دائما ورائي
عيونهم ورائي.. وأنوفهم ورائي
أقدامهم ورائي..
كالقدر ا لمحتوم كالقضاء
يستجوبون زوجتي، ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي
يا حضرة السلطان..
لأنني اقتربت من أسوارك الصماء
ضربت بالحذاء..
وأرغمني جندك أن آكل من حذائي.
إلى هذا الحد جاءت (الهوامش ) لتلبى احتياجات سياسية لأبناء جيلنا..
واستخدمناها كشعارات.. وعناوين عريضة لخطابنا السياسي بعد قليل.. ففي
مظاهرات عام 1972.. كان ضمن مطالب الطلاب التي رفعوها لمجلس الشعب
"مقابلة الرئيس السادات".. ومقابلة "رئيس مجلس الشعب".. ومقابلة " محمد
حسنين هيكل" وزير الإعلام- آنذاك-.. وربما كانت عبارة نزار:
لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان،..
هي التي دفعتنا- آنذاك- لأن نضع ضمن مطالبنا لقاء رئيس الجمهورية..
توالت بعد ذلك قصائد نزار السياسية.. وتفرغ لمهاجمة التخلف والكذب
والخداع وبنفس الطريقة.. ونفس السياق الشعري.. وبسادية المتهكم.. وجلد
الذات.. وتعرية العورات العربية.. وكشف ا لمستور. ومهاجمة الأنظمة
العربية بشكل (إجمالي) ومباشر ولاذع..
وبعد أن كان نزار يقول عن نفسه أنه:
"مسئولا عن المرأة حتى الموت "
"إنني حارس ليلى على باب المرأة! "
نجده يصرح في لقاء لجريدة الشرق الأوسط.. وكأنه يستغيث ويتبرأ من كل
التهم التي ألصقت به فيقول:
هل من الممكن، إكراما لكل الأنبياء، أن تخرجوني من هذه القارورة
الضيقة، التي وضعتني فيها الصحافة العربية، أي قارورة الحب والمرأة أ
وكأنه يسعى للتطهر من سنوات المجون والمراهقة.
وبعد رحيل نزار. كلفني رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد عبد المنعم..
بإعداد كتاب تذكاري عن نزار قباني.. يصدر ضمن سلسلة الكتاب الذهبي..
فبدأت أبحث عن نزار قباني من جديد.. ووضعته كله أمامي.. بعقل اليوم..
وبوعي مختلف ومغاير لسنوات الستينيات.. فوجدت أن الأمر قد اختلف.. وأن
موقفنا من نزار قباني.. كان فيه قدر كبير من التعالي والتعسف..
والأحكام القاطعة، فشاعر بقامة نزار قباني له كل هذه الشعبية.. وله هذا
الرصيد الهائل من العشاق والمريدين.. في وطن بمثل هذا الاتساع
والاختلاف.. ليس بالأمر السهل ولا البسيط.. وليس من قبيل الصدفة أو
الحظ السعيد.. أن يحتفظ شاعر بهذا القدر من الاحتفاء الجماهيري.. طوال
هذه السنين فلا يستطيع أي شاعر مهما كان بارعا في الاحتيال.. أن يخدع
أمة بأكملها طوال خمسين عاما من الشعر. لذا فالأمر مختلف ويحتاج إلى
إعادة النظر بعين أكثر حيادا وموضوعية. وفى مسار البحث عن الجذور. وجدت
أن نزار قباني شاعر ثائر منذ أن أمسك القلم وخط بيده أول كلمات الشعر.
بغض النظر عن مفهومنا للثورة وللـ (ثورجى) إن جاز التعبير.. ولكنه ثائر
بمعنى أو بآخر. وإن كان بمنظور مختلف عن المعنى التقليدي للثائر
(المناضل).. فنزار ثائر بمعنى أنه كان قادرا، ومنذ وقت مبكر جدا على
كسر الأطر التقليدية للشعر.. رغم أنه في النهاية شاعر تقليدي.. ولكنه
كان متحررا من كل القيود الملزمة لأي شاعر في الأربعينيات.. وقت أن
أصدر ديوانه الأول "قالت لي السمراء".. فقد دافع عن المرأة، وعن كافة
حقوقها رغم اقتحامه السافر لحياتها الخاصة.. ورغم امتهانه لها في كثير
من قصائده.. ورغم أنه تجرأ عليها.. ونزع عنها ملابسها قطعة قطعة في عدد
هائل من قصائده.. وحاول في قصائد عديدة أن يضاجع نساءه أمام قرائه..
وضبط متلبسا في أكثر من ركن من أركان دواوينه، وهو يداعب نهود المرأة
العربية مداعبات جارحة.. ورغم كل هذا المجون.. فهو شاعر تحريضى.. ليس
بمعنى أنه يحرض النساء على الرذيلة.. ولكنه يحرض النساء على الخروج من
عباءة التقاليد، وكسر حواجز التخلف، إنه أراد أن يطلق العنان لنسائه،
فأناب عن كل نساء العرب في التعبير عن مشاعرهن المكبوتة منذ آلاف
السنين.. ولأنه رجل عرف الحرية أقام علاقة متحضرة مع المرأة.. فأراد
لها حريات واسعة بقدر ما يستمتع هو بحرياته الواسعة.. وأراد للمرأة أن
تنتزع حريتها من مجتمع متخلف.. عامر بالرجال المتخلفين في علاقتهم
بالمرأة على وجه الخصوص.
ويبدو أن حادثة أخته الكبرى (وصال) التي انتحرت لأنها لم تتزوج بمن
تحب، وهو صبى صغير. زرعت في صدره منذ وقت مبكر عوامل الثورة ضد سطوة
الرجل على المرأة حتى في أخص مشاعرها.. فهو يحكى لنا في كتابه "قصتي مع
الشعر" فيقول عن أسرته:
" كل أفراد الأسرة يحبون حتى الذبح.. وفى تاريخ الأسرة حادثة استشهاد
مثيرة سببها العشق.. والشهيدة هي أختي الكبرى وصال.. قتلت نفسها بكل
بساطة وشاعرية منقطعة النظير لأنها لم تستطع أن تتزوج حبيبها.. صورة
أختي وهى تموت من أجل الحب.. محفورة في لحمى.. لازلت أذكر وجهها
الملائكي، وقسماتها النورانية وابتسامتها الجميلة، وهى تموت.. كانت في
ميتتها أجمل من رابعة العدوية.. وأروع من كليوباترا المصرية.. وحين
مشيت في جنازة أختي، وأنا في الخامسة عشرة كان الحب يمشى إلى جانبي
ويشد على ذراعي ويبكى.. وحين زرعوا أختي في التراب وعدنا في اليوم
التالي لنزورها لم نجد القبر. وإنما وجدنا مكانه وردة".
بهذه الشاعرية الدافئة.. وهذا الشجن النبيل وهذه الشفافية المرهفة..
يصف لنا نزار مشهد انتحار أخته الذي يطلق عليه (استشهاد) بدلا من
(انتحار) ويستخدم كلمة (الزرع) بدلا من (الدفن) رجل صدمته هذه
الحادثة.. وروعته سطوة الرجال على المرأة التي بلغت حد الانتحار لأخته
التي تكبره.. لابد أن يشب ثائرا على تلك الأوضاع.. وينتزع حريته أولا
حتى يستطيع أن يمنح كل نساء العرب حريتهن.. فتحرر هو أولا من كل محاذير
اللغة وتقاليد الأدب العربي.. وممنوعات التناول الشعري.. ولهذا نجح
نزار في ثورته على كل اللغات القديمة واستطاع أن يفلت من مخالب لغة
القواميس الميتة.. ويقول نزار عن ثورته على اللغة القديمة:
"كانت لغة الشعر متعالية بيروقراطية.. بروتوكولية لا تصافح الناس إلا
بالقفازات، وكل ما فعلته أنني أقنعت الشعر أن يتخلى عن أرستقراطيته،
ويلبس القمصان الضيقة المشجرة.. وينزل إلى الشارع ليلعب مع أولاد
الحارة، ويضحك معهم ويبكى معهم.. وبكلمة واحدة رفعت الكلفة بيني وبين
لغة (لسان العرب) و(القاموس المحيط) وأقنعتها أن تجلس مع الناس في
المقاهي والحدائق العامة وتصادق الأطفال والتلاميذ والعمال والفلاحين
وتقرأ الصحف اليومية.. حتى لا تنسى الكلام ".
ويرى نزار الحل في الاعتماد على لغة ثالثة فيقول:
".. وكان الحل هو اعتماد لغة ثالثة تأخذ من اللغة الأكاديمية منطقها
وحكمتها ورصانتها.. ومن اللغة العامية حرارتها وشجاعتها وفتوحاتها
الجريئة.. وبهذه (اللغة الثالثة) نحن نكتب اليوم، وعلى هذه اللغة
الثالثة يعتمد الشعر العربي الحديث في التعبير عن نفسه دون أن يكون
خارجا عن التاريخ ولاسجينا في زنزانته ".
إذن فنزار كان يدرك أن اللغة أداة اتصال جماهيري.. لتوصيل أفكاره
الملتهبة في الحب والسياسة، ولهذا فهو يكتب قصائده في شكل منشورات
تحريضية ( التثوير )
ورغم كل شئ فإن نزار قباني نتفق أو نختلف معه فهو في النهاية شاعر عربي
كبير عملاق بجماهيره الواسعة العريضة .. وبمحبيه وعشاقه الذين لا حصر
لهم .. وهو شاعر عربي كبير بحجم عطائه وامتداد تجربته عبر خمسين عاما
من الشعر .. وهو شاعر عربي مجدد لأنه استطاع أن يحفر لقصيدته طريقاً
ومساراً مختلفا عمن سبقوه في الشكل والمضمون والصياغة.
أعلى
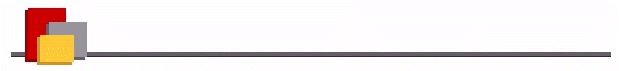
سليم
الحسني
في
(ثلاثية أطفال الحجارة) يعود بنا نزار قباني إلى حملته الشديدة على
الواقع العربي، فيسلط أضواءه بكثافة على مفردات هذا الواقع، محاولا
تجريح مظاهره المتراخية. ورغم قساوة الحملة التي تعبر عن نفور واضح
يبلغ حد الطغيان، إلا أن قباني يترك انطباعاً قوياً بأنه لم يقل كل ما
عنده.. وانه بحاجة أي دعم لغوي جارح فوق العادة ليستكمل أجزاء هجومه
العنيف على الحياة العربية.
لا نشك
أن نزار قباني، انطلق في موقفه المتنفر هذا من فهمه للجو العربي، ورصده
اليومي لمجرياته ووقائعه واحداثه.. فكون قناعة ثابتة حمّل بموجبها
الحكومات العربية مسؤولية ما حدث من تراجع وإخفاق وهزيمة. وقد عبّر عن
هذه القناعة لأول مرة بعد نكسة حزيران القاسية وكانت (هوامش على دفتر
النكسة) نقطة تحول كبيرة في حياته الشعرية، أثارت جدلا نقدياً حول
الشاعر وتوجهاته الجديدة أيام ذاك. باعتباره تناول هموم الساحة بعيداً
عن الهموم العاطفية ومسائل الحب والمرأة التي تميز بها شعره. ولم يسلم
من ملاحظات الإدانة، كما لم ينج في نتاجاته الشعرية السياسية الأخرى من
الملاحظات نفسها.
النقطة
الكبيرة التي سجلها نزار قباني على نفسه، والتي ظلت تمثل الخط المشترك
في قصائده السياسية، هي تضخيمه لحجم النقمة ولدائرتها، فلم تختص
بالجهاز السياسي، إنما وسعها لتشمل الواقع العربي كله.. بماضيه وحاضره.
لقد اصدر حكمه بفساد هذا الواقع، وجعله حكماً نهائياً قطعياً غير قابل
للاستئناف.
ففي
المقطع الرابع عشر من قصيدة (هوامش على دفتر النكسة) كتب يقول:
جلودنا
ميتة الإحساس
أرواحنا تشكو من الإفلاس
أيامنا
تدور بين الزار والشطرنج والنعاس
هل
(نحن خيرُ أمة أخرجت للناس)
انه في
هذا المقطع ينتقد بقسوة المجتمع العربي كله، دون أن يفصل بين الشعب
والسلطة، مع أن عملية الفصل ليست عرضية، إنما هي جوهرية في واقعنا
السياسي، لا يمكن تجاوزها بأي حال. لكن طعم المرارة التي تذوقها الشاعر
جعلته يرفض المحيط العربي بأسره.. ثم يعمم رفضه على الماضي، مشككا
بالدور التاريخي، لأنه ارتبط بالحاضر.
استمر
قباني في نقمته الشديدة، وكان يريد أن يثبت موت الواقع بجزئيه الحكومي
والجماهيري. وهذا ما تحدث عنه في قصيدة (الممثلون) التي كتبها عام
1968:
حين
يصيرُ الحرفُ في مدينة
حشيشةً
يمنعها القانون
ويصبحُ
التفكيرُ كالبغاء، واللواط، والأفيون
جريمة
يطالها القانون
حين
يصيرُ الناسُ في مدينة
ضفادعاً مفقوءة العيون
لا
يثورون ولا يشكون
ولا
يغنون ولا يبكون
ولا
يموتون ولا يحيون
تحترق
الغاباتُ، والأطفال، والأزهار
تحترق
الثمار
ويصبحُ
الإنسان في موطنه
أذلّ
من صرصار..
لا
نريد أن نسير مع قباني في رحلته الطويلة في هذا الاتجاه، لكن الذي
نقرره، انه في تعامله الشعري الموجه ضد الواقع العربي قد ترك لنفسه
المجال مفتوحاً على أوسع قاعدة ممكنة.. وحذف الضوابط واسقط الاستثناءات
بشكل عام، حسب قناعة يؤمن بها.. وسنأتي إليها فيما بعد.
كانت
هذه المقدمة ضرورية، لأننا في قراءتنا لقصائده الثلاث سنجد موقفه
السابق ما يزال على ثباته.. لم يتراجع عنه.. ولم يلجأ إلي تعديله من
حيث الأسس ولو تعديلا شكلياً، رغم أن حدث الحجارة فرض على الكثير من
الشعراء أن يسيروا معه سيراً حماسياً مندفعاً إلى أقصي الحدود،
باعتباره يمثل نهوضاً مشرقاً في جو راكد منذ عقود طويل. مما جعلهم
ينسون الماضي بما يحمله من مفردات مظلمة. وقد فعلوا ذلك لأنهم وجدوا في
الانتفاضة حدثاً كبيراً، اكبر من حقبة التردي والانسحاق.
نزار
قباني لم ينس الماضي. ولا حتى جمّد موقفه منه، بل رفض الهدنة المؤقتة
رفضاً قاطعاً. حيث نجد انه في قصيدة (أطفال الحجارة) خصص الجزء الأعظم
من القصيدة لحديثه الناقم على أجواء الساحة العربية، ولم يحتل حديثه عن
الأطفال سوى ربع مساحة القصيدة.
لقد
حرص الشاعر على أن يعلن مرة أخرى ومن خلال الانتفاضة ثورته العنيفة على
الواقع العربي، مستفيداً من الحدث الفلسطيني ليوظف قناعته بصورة تبدو
منطقية قدر الإمكان، وقد لجأ ضمن هذا السياق إلى اعتماد الأسلوب
المقارن والذي ظهر واضحاً في مقاطع عديدة من قصائده الثلاث.
ففي
قصيدة (أطفال الحجارة) قارن بين الدور الذي قام به الأطفال وبين جمود
سواهم الذين اعتبرهم الشاعر على ما يبدو كل الذين هم خارج الجغرافية
الفلسطينية.
بهروا
الدنيا..
وما في
يدهم إلا الحجارة..
وأضاؤوا كالقناديل، وجاؤوا كالبشارة
قاوموا.. وانفجروا.. واستشهدوا
وبقينا
دبباً قطبية.
صفّحت
أجسادها ضد الحرارة..
وفي
قصيدة (الغاصبون) يبدأ الشاعر بمقارنة تكشف عن الضعف الذي يحسه مسيطراً
على غير الأطفال، فيعطيهم اعترافاً صريحاً بالعجز أمام قوتهم.
يا
تلاميذ غزة علمونا
بعض ما
عندكم، فنحن نسينا
علمونا
بأن نكون رجال
فلدينا
الرجالُ، صاروا عجينا
أما
قصيدة (دكتوراه شرف في كيمياء الحجر) فقد اختلفت عن الآخرتين بقلة هجوم
الشاعر على الواقع العربي. وفيها أعطى المقارنة طابعاً متداخلا. فقد
جعل الفعل الثوري الذي يمارسه الطفل الفلسطيني في حركته المنتفضة،
شاملا لكل الساحة، وفي خط الشمول كانت تظهر السلبيات وهي ساقطة بتأثير
الموقف الثوري.
إن
عملية المقارنة بين أطفال الحجارة وبين غيرهم أفرزت فئتين من الناس:
الثوار، وكان رمزهم الأطفال.. وغير الثوار، وكان رمزهم الأكثر
استخداماً الضمير (نحن)، مما يقول إلى الاعتقاد بأنهم يشملون القطاع
الأوسع من الشعوب العربية إضافة إلى الحكومات. وفي ذلك تأكيد لقناعة
الشاعر المسبقة والدائمة، والتي دعته إلى التمييز بين الفلسطيني الذي
يرمي الحجارة وبين غيره.. تاركاً فجوة واسعة بين الفئتين دون أن يمد
بينهما جسر لقاء.. فجوة بحجم الفاصلة بين ما هو ثوري وبين ما هو غير
ثوري.
إن
الفصل الفئوي الذي صممه نزار قباني، تبعته محاولة أخرى اكثر قسوة،
انطلقت من إحساسه بالألم، حيث رسم حالة متقابلة بينهما تبدأ بمشاعر
متضادة، لتنتهي بما يشبه العداء في دعوة صريحة للاقتصاص.
يتحرك
الشاعر من منطقة البداية، بتأكيد العجز في الفئة غير الثورية، مقابل
عناصر القوة والنضج المتزايدة في الأخرى.
نحن
موتى، لا يملكون ضريح
ويتامى
لا يملكون عيونا
قد
لزمنا حجورنا.. وطلبنا
منكمُ
أن تقاتلوا التنينا
قد
صغرنا أمامكم ألف قرن
وكبرتم
خلال شهر قرونا
عندما
يبتعد قباني عن منطقة البداية، يحاول أن يحقق الفصل بين ثوار الحجارة
وبين الواقع العربي. فيرى فيهم حالة متمردة على قوانين هذا الواقع،
خارجة عن أنماطه المعهودة منذ زمن طويل. وهم أن ينتمون إليه بحكم
الاعتبارات التاريخية والاجتماعية، إلا انهم لا يشتركون معه في مظاهره
السلبية.
في
قصيدة (دكتوراه شرف) يرسم الشاعر من خلال التساؤلات المتتالية صورة
الطفل الفلسطيني الذي تحول إلى ظاهرة مثيرة للإعجاب من قبل كل الذين
يتابعون أحداث الانتفاضة، مهما كانت مواقعهم وهوياتهم.
من هو
هذا الولد الطافش من صور الأجداد..
ومن
كذب الأحفاد..
ومن
سروال بني قحطان..؟
ويعتمد
الشاعر الصراحة في الحديث تاركاً الوصف، وموجهاً نداءه إلى الأطفال
الثوار، في دعوة عالية الصوت، لأن يحدث الفصل بين الفئتين.. وبين
الجيلين.. وبين الحالتين.
يا
تلاميذ غزة..
لا
تعودوا لكتاباتنا، ولا تقرؤونا
نحن
آباؤكم فلا تشبهونا
نحن
أصنامكم فلا تعبدونا
نتعاطى
القات السياسي والقمع
ونبني
مقابراً وسجونا
علمونا
فنّ التشبث بالأرض
ولا
تتركوا المسيح حزينا
عند
هذه النقطة يكون الشاعر قد اقترب من مرحلة اكثر خطورة، تتمثل في ضرورة
التمرد القوي على الأوضاع العربية.. تمرداً جاداً خالياً من العاطفة..
قائماً على أساس الرفض لأجزائه السابقة. لأنه يتصور أن الرفض حالة
ثورية متممة للموقف الذي يصنعه ثوار الحجارة. ولكي يكتمل الهيكل الثوري
كحدث كبير مطلوب، لابد من اقتلاع الماضي بجذوره ورواسبه، باعتباره تركة
غير مرغوب فيها تحوي النحس والانهيار.
وعلى
هذا يبذل الشاعر جهداً استثنائياً لإيصال قناعته إلى الثوار، انه يجد
في هذه القناعة سبيلا للاستمرار على نهجهم الثوري، لذلك يحاول استثمار
الوقت ليكثف نداءاته إليهم بطريقة متواصلة سريعة.
أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من قبحنا..
اغسلونا
انه
يضع دوراً آخر للطفل الفلسطيني، حيث ينيط به مهمة إصلاح الأوضاع
المتردية، بما تنطوي عليه من خزين سيء متراكم عبر الزمن.
ويوشك
الشاعر أن يصل إلى النقطة الأخيرة في برنامجه التربوي الذي أعده
بعناية، عندما يحشر الجيل العربي المسؤول عن الانتكاسات في زاوية ضيقة،
متوعداً إياه بأطفال الحجارة، مما يوحي بإيجاد حالة العداء بين
الجيلين.
آه..
يا جيل الخيانات.. ويا جيل العمولات..
ويا
جيل النفايات.. ويا جيل الدعارة..
سوف
يجتاحكـم مهما أبطأ التاريخ
أطفال
الحجارة
وهكذا
ينظر الشاعر إلى الساحة العربية نظرة استشراقية منبثقة من ثورته
الذاتية المتفجرة، فيبصر النتيجة الحتمية التي سيصنعها أطفال فلسطين
ذات يوم.
ويعطي
قباني دوراً اكبر لثوار الحجارة، في دعوة توحي بالمواجهة. حيث يتصور أن
الجيل السابق والذي ما يزال ممتداً في الساحة، لابد أن يختفي نهائياً،
لتنتهي بواعث الهزيمة وآثارها.
نحن
آهل الحساب والجمع والطرح
فخوضوا
حروبكم واتركونا
إننا
الهاربون من خدمة الجيش
فهاتوا
حبالكم واشنقونا
إن
نزار قباني في دعوته إلى تجريح الأوضاع السائدة، ومن ثم قتلها
وإحراقها، إنما يريد أن يؤكد عدم جدوى المسار الذي تسلكه، بل خطورته
على المستقبل العربي، ويحاول أن يقدم أسسا منطقية تقنع الجو العام
بضرورة رفض ما هو سائد، طالما يتصل زمنياً واجتماعياً بالماضي.
فالتواصل يمثل امتداداً تراجعياً في المواقف، من شأنه أن يعطي نتائج
اشد انهزامية.. وان الأنعتاق منه لا يحدث إلا بخيار واحد، هو الانتقام
الواعي من الواقع المرير، وحذفه كلياً من الخارطة ومن التركيبة
المعاصرة للمجتمع العربي.. ان قباني وصل درجة اليأس من إمكانية إجراء
تعديل عليه يساهم في علاجه. لذلك يحاول أن يستغل اصغر فرصة ليعلن اكبر
قدر من الآراء الغاضبة التي يعتقد أنها متبناة جماهيرياً. وحتى نقده
الذاتي العنيف، يعتبره بمثابة التصريح بالحديث الخفي الذي يحاور به كل
إنسان نفسه في البلاد العربية، وان اختلفت شدة الإحساس بالحزن.
لقد
وجد في انتفاضة فلسطين مناسبة ثمنية ليواصل في أجوائها حملته الغاضبة
الجارحة ضد الساحة بكل مظاهرها واسسها ومعادلاتها. فآثر أن يكرس جهده
في هذا المجال، على حساب التغني بالمجد الذي يصنع داخل الأرض المحتلة.
ولم يكن استغراقه في الحديث عن الجوانب السلبية المعاشة خارج دائرة
الثورة ناجماً عن انفعالات عاطفية حجبت عنه الرؤية. وجرته إلى درب
الرفض الساخن دون شعور منه، إنما اتخذ هذا الموقف استناداً إلى دوافع
يراها منطقية. والى قناعة يعتقدها صائبة. وهذا ما كونه خلال حقبة طويلة
وسار عليه منذ فترة تعود إلى ما يقرب من ربع قرن.
انه
إذن يتحرك وفق منهجية مدروسة واضحة الاتجاهات والمعالم في معالجاته
الشعرية السياسية. وتتأكد هذه المسألة في تقييم نتاجه السياسي، عندما
نرصد إصراره في معالجة قضايا الحب والمرأة. فقد انفق عليها عمره الشعري
الطويل، دون أن يجري تعديلا أساسيا على منطلقاته الشعرية المتعاملة مع
الحب والمرأة، رغم ما واجهه من حملات وانتقادات، وما عاناه من نقص في
وفرة المادة والمحور والأسلوب الشعري بحكم الكثرة الساحقة التي
استخدمها، حتى نظر إليه البعض كعين توشك أن تجف.
لقد
واجه ذلك، لأنه أراد أن يفرض قناعته ورأيه في هذا الجزء من الحياة على
الحياة نفسها. ونجح نجاحاً ملموساً، حيث استطاع أن يربط شعر الحب
والمرأة بإسمه، وان يترك مسافة شاسعة بينه وبين غيره، وللدرجة التي
يمكن من خلالها التنبؤ باستحالة أن يلحق به أحد، مهما كان تعامله مع
الزمن عجولا ومع القصيدة مكثفاً.
إن
نزار قباني، يؤمن بطريقة النفس الطويل في النتاج الأدبي، حتى يتحول
بفعل الزمن إلى رأي جماعي تأخذ به أوسع دائرة شعبية ممكنة. فهو يتعامل
مع الزمن على انه ضروري جداً في بلورة القناعة وفي تحويل الرأي إلى
حقيقة ميدانية.. وإذا طالت فترته فان ذلك يساهم في توسيع دائرة
الأنصار.
وفي
ضوء هذا فان تشديد الشاعر على إظهار عيوب الواقع العربي، إنما هو مشروع
آخر يهدف من ورائه إلى تثبيت قناعته الشخصية في العقل الجماهيري،
بصورتها الصارخة الألوان، من أجل أن يرفض العقل والقلب معاً كل ما هو
طارئ وسلبي.
واكرر.. لم تصدر صرخة نزار قباني من حالة يأس مطلقة.. ولم تنبثق من
إحساس مغلق بالهزيمة، إنما هي صرخة واعية ضمن مخطط طويل، يرمي من ورائه
إلى إثارة الشعور الحماسي الرافض.. انه يسلط أضوائه الكاشفة على نقاط
الضعف والخلل، ويضيف عليها ما يستطيع من أضواء. وقد يبالغ في رسم
الصورة المشوهة للواقع العربي، على أمل أن يتقزز إنسان الواقع، فينتفض
ضده في حركة متمردة مدركة تتجه نحو المنطقة المطلوبة المنسجمة مع
التغيير السياسي والاجتماعي.
وفي
هذا السياق نلاحظ أن نزار قباني وسط أجواء التردي.. وفي اشد مراحل
الهزيمة وحالات الانهيار النفسي التي أعقبت حزيران، يقف ليكتب عام 1970
(منشورات فدائية على جدران إسرائيل).
في تلك
القصيدة ذات السبعة والعشرين مقطعاً بدأ أولا بداية حماسية واثقة صادرة
من نظرة مشرقة للأيام القادمة، نظرة بدت غريبة على الشاعر، وكأن
القصائد السابقة منسوب إليه وليست له.
لن
تجعلوا من شعبنا
شعب
هنود حمُر..
فنحن
باقون هنا..
في هذه
الأرض التي تلبس في معصمها
اسوارةٌ من زهر
فهذه
بلادنا..
فيها
وجدنا منذ فجر العمر
ويواصل
خطابه الحماسي المتحدي مؤكداً اطمئنانه على مستقبله كقضية كبيرة لا
تخضع للنسيان أو التجاوز أو المصادرة. لأن هناك إصرارا متعاظماً على
السير، لا يمكن أن تتعثر خطاه.
من قصب
الغابات
نخرجُ
كالجنّ لكم.. من قصب الغابات
من رزم
البريد، من مقاعد الباصات
من علب
الدخان، من صفائح البنزين، من شواهد الأموات
من
الطباشير، من الألواح، من ضفائر البنات
من خشب
الصلبان، من أوعية البخور، من أغطية الصلاة
من
السطور، والآيات
فنحن
مبثوثون في الريح، وفي الماء، وفي النبات
ونحن
معجونون بالألوان والأصوات..
لن
تُفلتوا.. لن تفلتوا
فكل
بيت فيه بندقية
من ضفة
النيل إلى الفرات.
انه
يمتلك تقييماً مشجعاً للواقع، يبعث في النفس إحساسا عميقاً بالقوة
القدرة على صنع الموقف المطلوب.. فهناك أمة حية من الثوار، يصعب
تحييدها أو محاصرتها، لأنه لا يمكن رصدها. إنها منتشرة في كل المواقع..
متوزعة على كل الجبهات.. مستنفرة لدخول المواجهة في ساعة صفر معلنة.
والشاعر هنا يستند إلى أرقام واقعية مستقاة من السنّة العامة للثورات.
وعلى أساسها لا يحس بالهزيمة ولا يتسرب إليه شعور الضعف، فقد وطّن نفسه
لمعركة طويلة.. طويلة تمتد في الزمن القادم، دون أن يؤثر الحساب الرقمي
على خطه العام في المواجهة، لأنه يدرك أن المعركة ليست واقعة بسيطة
بموقف عسكري على الأرض، إنما هي معركة حضارية شاملة طويل.
ما
بيننا.. وبينكم.. لا ينتهي بعام
لا
ينتهي بخمسة.. أو عشرة.. ولا بألف عام
طويلة
معارك التحرير كالصيام
ونحن
باقون على صدوركم
كالنقش
في الرخام
حسب
هذه الرؤية النافذة في المستقبل، ينظر الشاعر إلى ما حدث على انه جزء
من المساجلة الطويلة، وان نكسة حزيران ليست تراجعاً مصيرياً، بل هي
لحظة انكسار في مسار الزمن.. واقعة ضمن معارك متواصلة.. وأنها لا يمكن
أن تكون سبباً للانكسار والتراجع، إنما هي منطلق للنصر.
ليس
حزيران سوى يوم من الزمان
وأجمل
الورود ما ينبت في حديقة الأحزان
لم
تأخذ منه الهزيمة مأخذاً.. ولم تدخل آثارها إلى قلبه بعمق، فقد ظل
يحتفظ بأمل كبير، ولعله اكبر مما كان في السابق. حيث وجد أن ما خسرته
الجبهة العربية، خلق محفزات انتقام هائلة في كل أجزاء الساحة، بإمكانها
أن تتحول إلى قوة عملاقة متعددة الأغراض.. متجهة نحو هدف مشخص أمام كل
العيون. وان الذي حدث من مآسي يمثل الجو الصالح لولادة الإرادة
المتفجرة.
للحزن
أولاد سيكبرون..
للوجع
الطويل أولاد سيكبرون
للأرض،
للحارات، للأبواب، أولاد سيكبرون
وهؤلاء
كُلهم
تجمعوا
منذ ثلاثين سنة
في غرف
التحقيق، في مراكز البوليس، في السجون
تجمعوا
كالدمع في العيون
وهؤلاء
كلهم
في
أي.. أي لحظة
من كل
أبواب فلسطين سيدخلون
حين
نسير مع قصيدة نزار قباني ذات النفس الثوري الملتهب، فإننا نجد أنفسنا
على محطات ثورية متزايدة الأوضاع.. متعاظمة الطموح.. خالية من كل مشاعر
الضعف. إننا إزاء قصيدة حماسية مرتفعة الحرارة كتبها شاعر يعيش في
داخله ثورة عارمة تتفجر عبر الكلمات.. تتدفق في كل الاتجاهات، بحيث لا
يمكن أن نتصور أنها ستهدأ ذات يوم أو تنطفئ جذوتها بعد اليوم، مهما
واجهت من تضييق أو اصطدمت بعوامل كابحة. فالشاعر الذي يكتب يؤمن إيمانا
كاملا بقدرة شعبه على صنع المعجزة الثورية. هذه القادرة التي ولدت دفعة
واحدة بتأثير الانتكاسة كرد فعل عنيف لما حدث.
العرب
الذين كانوا عندكم مصدرّي أحلام
تحولوا
بعد حزيران إلى حقل من الألغام
وانتقلت (هانوي) من مكانها..
وانتقلت فيتنام..
حدائق
التاريخ دوماً تزهرُ
ففي
ذُرى الأوراس قد ماج الشقيق الأحمر
وفي
صحارى ليبيا.. أوراق غصنٌ أخضرُ
والعرب
الذين قلتم عنهمُ: تحجرّوا
تغيروّا..
تغيروّا..
في هذه
القصيدة الطويلة تختفي مظاهر اليأس تتلاشى معالم الهزيمة، وتظهر
برسومات كبيرة واضحة الألوان، صورة متفائلة جميلة للمستقبل العربي.
إنها حالة لم يألفها القراء عند نزار قباني.. وهي تبدو استثنائية حين
نجده يعود إلى أسلوبه الأول. فهذه القصيدة تمثل نقطة غريبة في الغالبية
الساحقة لنتاجه الشعري السياسي.
هل أحس
بخطأ الأسلوب الأول، فكتب هذه القصيدة ليصحح خطأ؟
لكن
هذا الرأي يسقط بسرعة عندما تواجهنا دفعة كبيرة من قصائده اللاحقة،
وفيها يعود إلى حملته السابقة وبنقمة أشد.
هل
أراد أن يساير حركة الشعر حتى لا يتخلف عنها ولا ينعزل في إطاره الخاص؟
الجواب
منفي للسب السابق.
هل
واجه نزار قباني حالة طارئة فكتب قصيدته تلك فكانت طارئة كحالته.. ثم
عاد إلى سبيله الأول؟
ربما
يبدو هذا الرأي مقبولا في البداية، لكن الحشد الهائل من الصور والمواقف
والأفكار التي ضمنها في قصيدته، تكشف عن انطلاقه من رؤية مبنية على أسس
واستنتاجات واقعية تضعه في العديد ـ من مقاطع القصيدة، بعيداً عن
الحماس الساذج.
ويتراجع هذا الرأي عندما نقرأ بتأمل القصائد اللاحقة للشاعر. فقد حوى
بعضها نفساً مشابهاً في اندفاعه الثوري. ففي قصيدة (عرس الخيول
الفلسطينية) التي كتبها عن قادة المقاومة الفلسطينية الذين اغتالتهم
إسرائيل في نيسان 1973 ببيروت، تحدث الشاعر في معظم القصيدة بنفس
متفائل رغم أن الحدث كان حزيناً كئيباً.
لماذا
يسمونه مأتماً؟
لقد
كان أروع عرس رأتهُ المدينة
ويا
أمّ يوسف أنت العروسُ..
ونحن
شهودك ليل زففت لزين الشباب،
ونحنُ
رشقناكما بالملبّس، والورد،
نحن
رقصنا أمامكما رقصة السيف والترس
نحن
وضعناك فوق حصان العريس
وثوبُ
زفافك،
كان
يلامسُ أشجار غزّة والناصرة..
لماذا
يقولون: إنّ الخيول.. إذا قتلت تفقدُ الذاكرة؟
وفي
قصيدة (ملاحظات في زمن الحب والحرب) التي كتبها بعد حرب تشرين 1973،
تحدث الشاعر بطريقة منبسطة تزدحم نظرته للأشياء، وتوارت أمام عينيه
معالم المأساة، فراح ينظر إلى ما حوله بعين جديدة، يرى فيها الأشياء قد
تغيرت نحو الأفضل في زمن الحرب والنصر.
ألاحظت
شيئاً؟
ألاحظت
أن العلاقة بيني وبينك..
في زمن
الحرب..
تأخذُ
شكلا جديدا
وتدخلُ
طوراً جديدا
وأنك
أصبحت أجمل من أيّ يوم مضى..
وأني
أحبك اكثر من أيّ يوم مضى..
ألاحظت؟.
كيف
اخترقنا جدار الزمن
وصارت
مساحة عينيك
مثل
مساحة هذا الوطن..
وتأسيساً على هذا فان قباني كان مدركاً لما يكتب.. انه لم يعش حالة
طارئة ولدت فجأة واختفت سريعاً، إنما يكتب وفق رؤية يعتقد بصحتها،
ويتحرك في شعره على هداها.
إن
مراجعة الخط الشعري لنزار قباني في كل فتراته.. وإمعان النظر في نتاجه
السياسي، يجعلنا نقرر ملاحظة هامة في هذا الخصوص تلك هي، إن الشاعر
يعطي لنفسه حرية تجريح الواقع العربي، مجنداً كل إمكاناته اللغوية
والأدبية إلى حدودها القصوى، وذلك عندما يوجه حديثه داخلياً ضمن حدود
هذا الواقع، لأنه يتحرك في محاولة ترمي إلى تعرية أقسامه بوصفه تسبب في
سلسلة مزدحمة الحلقات من الهزائم والتراجعات.. فهو يصف الساحة على ما
هي عليه، ليوجه الأنظار إلى نقاط الخلل القاتلة. وفي هذا المجال لا يجد
ثمة حاجة إلى التحدث بطريقة حماسية شعاريه. فالمطلوب هو عرض الحقيقة
علناً دون لمسات إضافية تجميلية.
والى
جانب ذلك، فان الشعر يعتمد الطريقة الثورية المتفاعلة مع الحاضر
والمستقبل، والمستندة إلى عناصر القوة في الطرح والمعالجة، عندما يوجه
خطابه إلى الأعداء، كما هو واضح في قصيدة (منشورات فدائية)، لأنه يريد
تحشيد المعنويات ضد الخصم. لذلك يجمد صراعه الداخلي، باعتباره خارج
دائرة الحدث.
إن
نزار قباني يتعامل مع الموقف بقدر ما يحتله من حيز على الساحة، وبقدر
ما يمثله من تحرك وسط الأحداث. فحرب تشرين مثلا كانت حدثاً ضخماً أعاد
الثقة إلى الإنسان العربي، مما دفع الشاعر إلى أن يتفاعل معه إيجابيا،
ويعطيه حجمه الكبير في نتاجه الشعري الذي خصصه لمعركة رمضان.
وخلاصة
القول إن قباني، يجعل شعره يأساً جارحاً حين يعالج الأوضاع العربية..
ويصيره ثورة غاضبة عندما يوجهه إلى ما وراء دائرة الحزن. لكنه ضخم
الحالة الأولى على حساب الثانية، فكان إن دخل وخرج ثم دخل قفص الاتهام
ولا يزال.
عندما
تناول نزار قباني حدث الانتفاضة الفلسطينية، فانه جمع بين نمطي معالجته
في قصائده الثلاث.. فوضع التجريح إلى جانب التمجيد في القصيدة الواحدة.
مستثمراً الحدث ليستكمل مشروعه الناقم على الأوضاع القائمة في البلاد
العربية.. وليتمم مشروعه الآخر ذي النظرة المتفائلة التي تقدم البدائل
الثورية المتعددة أمام السائرين في طريق الثورة.
ولعله
في هذه الاثنية انطلق من تحليله لمجريات الساحة، حيث تعيش فلسطين ثورة
حية متصاعدة.. بينما لا يزال المحيط العربي يراوح في مكانه. لذلك عقد
الشاعر مقارنته بين فئتين.. وجيلين.. وحالتين، وسعى إلى الفصل بينهما
سياسياً واجتماعياً وقبل ذلك تاريخياً.. ومن ثم دعا الأول للانتقام من
الثاني وشطبه من الذاكرة والحياة.
لم يضف
في القسم السلبي من حديثه، جديداً على أسلوبه السابق، فلقد ظلت
المعالجة كما هي، وان اختلفت جزئياً الكلمات والصور ودرجة الهجوم.
لكنه
في القسم الإيجابي الذي تناول فيه أبطال الحجارة، أضاف جديداً، متميزاً
إلى مشروعه الخاص في هذا المجال. حيث سعى إلى جعل حدث الحجارة مرتبطاً
بكليته بالطفل الفلسطيني، وكأنه يريد أن يكرس بأقصى ما يستطيع حالة
الضعف التي يعانى منها الواقع العربي، في مقارنة إيحائية غير مباشرة.
يرسم
الشاعر مساراً طويلا للأطفال الحجارة، يتدرج على محطات متواصلة، تبدأ
من القرار الإرادي للفعل الثوري، ثم تبلغ الغاية في استعادة الوطن.
وبين البداية والنهاية، يحقق الطفل الفلسطيني إنجازات هائلة. فهو يتمكن
من خلال سلوكه الثوري البسيط والصعب في آن واحد، أن يعيد الأمل قوياً
إلى النفوس فتبدو أشلاء الوطن وهي تتجمع شيئاً فشيئاً، لتتشكل خارطة
الوطن المفقود في حلم جميل يوشك أن يصبح حقيقة.
في
لحظات
تظهرُ
ارضٌ فوق الغيم
ويولدُ
وطنٌ في العينين..
في
لحظات
تظهرُ
حيفا
تظهر
يافا
تأتي
غزّةُ في أمواج البحر،
تضيء
القدسُ كمئذنة بين الشفتين.
ثم
تنتقل آثار الحلم الثوري العقلاني إلى الأرض التي يسعى لإعادة بناء
الوطن عليها، فتظهر عليها الحياة تدريجياً في عودة خارجة عن زمن
الاحتلال.
ولأن
الطفل الفلسطيني يتحرك في انتفاضته بسرعة فائقة، فان الأمل يتحرك هو
الآخر بسرعة متناهية، مستوعباً في منطقة الحلم عملية البناء التي تتم
في لحظات قصيرة خاطفة:
في
لحظات
تحبلُ
أشجار الزيتون،
يدرُّ
حليبٌ في الثديين..
يرسم
أرضاً في طبريا
يزرعُ
فيها سنبلتين،
يرسمُ
بيتاً فوق الكرمل،
يرسمُ
أمّاً تطحن بُنّاً عند الباب،
وفنجانين.
في
لحظات
تهجمُ
رائحةُ الليمون
ويولدُ
وطنٌ في العينين.
وتتلاحق حركات الحلم الثوري لأطفال الانتفاضة، معيدة في تكوين جديد
المعالم الغائبة للوطن فلسطين. ويؤكد الشاعر الترابط الوثيق بين الحلم
الثوري وانعكاسه الواقعي.. فكل موقف يتخذه أبناء الانتفاضة، لابد أن
يسفر عن إنجاز كبير على الأرض، ضمن منهاج عام ثابت لإعادة فلسطين كاملة
غير منقوصة.
ولكي
يحقق الفلسطيني هذا الهدف الكبير، ويستكمل دوره التاريخي المنتظر، فانه
يتجه إلى الماضي في إطار عمليته الثورية الواسعة، ليشطب على مرتكزات
الهزيمة، ويحطم مصدر الضعف، في خطوة تستهدف إنهاء آثاره من الحاضر، حتى
لا تتوغل في الزمن القادم، فتجعله مجرد امتداد زمني لا يمتلك إشراقة
المستقبل. فهو يريد القضاء على كل الاحتمالات التي قد تعيد الماضي إلى
تحكيم قراراته الانهزامية او تنقل مواقعه الكئيبة إلى عالم الغد.
يركبُ
فرساً من ياقوت الفجر
ويدخلُ
كالاسكندر ذي القرنين
يخلعُ
أبواب التاريخ
وينهي
عصر الحشاشين
ويقفل
سوق القوادين
ويقطعُ
أيدي المرتزقين
ويلقي
تركة أهل الكهف عن الكتفين..
بعد أن
يتم الطفل الفلسطيني العملاق مهمته التغييرية في عمق الماضي.. يبلغ
الحاضر، فيحدث فيه تغييراً انقلابياً مماثلا. وهو في مواقفه وحركاته
التي تخلع وتنهي وتقفل وتقطع وتلقي.. يقدم البدائل المطلوبة. فلكل فعل
متمرد، هناك إنجاز ضخم، انه بصدد عملية بناء يريد لها الشاعر أن تكون
تاريخية شاملة لا يعلق بها من الماضي شيء.
ينفضُ
عن نعليه الرمل..
ويدخلُ
في مملكة الماء..
يفتحٌ
أفقاً آخر..
يبدعُ
زمناً آخر.
يكسرُ
ذاكرة الصحراء..
يقتلُ
لغة مستهلكةً
منذ
الهمزة.. حتى الياء..
يفتحُ
ثقباً في القاموس..
ويعلنُ
موت النحو..
وموت
الصرف..
وموت
قصائدنا العصماء.
إن
الشاعر يعتبر مهمة الطفل هذه، أساسية من أجل بناء فلسطين بناء سليماً..
فهو استطاع بقراراته الثورية أن يحذف من الواقع كل نقاط الخلل. وان
يلغي دور كوابح الثورة.. ويبطل مفعول أي قنبلة تثير الغبار في الطريق.
وحين
أدى الطفل مهمته الشاقة، فان فعله الثوري اصبح يمتلك قدرة عالية على
البناء النهائي. وبذلك فانه راح يستكمل مشروعه الحضاري عملياً. ومن هنا
تختفي الأحلام كلياً.. ولم يعد في هذه المرحلة وجود لأي حلم أو أمنية.
فلقد استوعب كل شيء، وهاهو ينطلق ليبني فلسطين على الأرض. ولأنه بلغ
هذه النقطة، فان كل موقف من مواقفه يكون له أثر مباشر في الواقع، يظهر
على هيئة اتجار ماثل أمام العين. وهكذا تتحول رمية الحجارة إلى عملية
بناء مستقلة لجزء من أجزاء الوطن.
يرمي
حجراً..
يبدأ
وجهُ فلسطين
يتشكلُ
مثل قصيدة شعر
يرمي
الحجر الثاني
تطفو
عكا فوق الماء.. زجاجة عطر
يرمي
الحجر الثالث
تطلعُ
رام الله بنفسجةً من ليل القهر
يرمي
الحجر العاشر
حتى
يظهر وجه الله.. ويظهر نور الفجر
يرمي
حجر الثورة
حتى
يسقط آخر فاشستي..
من
فاشست العصر
يرمي..
يرمي..
يرمي..
حتى
يقلع نجمة داود.. بيديه
ويرميها في البحر..
لقد
قدم نزار قباني منهاجاً طويلا في حلقاته من أجل أحداث المشروع الثوري
المطلوب، والذي لا ينفذ إلا بعد اتخاذ موقف قاطع من الماضي يحكم عليه
بالموت والفناء، وبذلك يصبح الجو صالحاً لولادة الأمل.. ثم تأتي عملية
الثورة التي تنقل نقاط الأمل إلى الأرض، واقعاً حياً متحركاً.. حتى
يستكمل المشروع فقراته.
بهذه
الرؤية فسر الشاعر انتفاضة رماة الحجر.
أعلى
|