|
أنا

وُلِدْتُ
..
في
الواحدِ والعشرينَ من آذارْ.
في ذلكَ
اليومِ المزاجيِّ الذي تُراهقُ الأرضُ به
وتَحْبَلُ
الأشجارْ.
ماذا جرى
في بَيتِنا ؟
في ليلة
الواحدِ والعشرينَ من آذارْ.
فحرّكَ
الدموعَ والأشجانْ
وما
لأُمّي قد بدت شاحبةً ؟
وابتلعتْ
صُراخَها
ومزقتْ
فراشَها
واستنجَدتْ
بمريمَ العذراء، في مَخَاضِها
وسُورةِ
الرحمنْ.
لا أحدٌ
أجابَني ..
لكنني
أحسستُ أن امرأة في بيتنا
كانت
تعيشُ حالةَ ابتكارْ ..
وُلِدتُ
في بُرج الحملْ.
بُرجِ
المجانين الذينَ قرروا
أن
يسرقُوا من السماءِ النارْ ..
خرجتُ من
مَحَارتي
مضرجاً
كالسمكةْ ..
وفي يدي
طبشورةٌ تبحثُ عن جدارْ ..
هوايةُ
التكسيرِ..
كانتْ
مهنتي.
وشهوةُ
الخروجِ مِنْ عَباءةِ الأخوالِ والأعمامْ ..
يومَ
اشتروا لي قلماً.. ودفتراً
قررتُ أن
أكونَ من عائلة البروقِ.. لا من عائلةِ الأحجارْ
وُلدتُ..
في الواحد والعشرينَ من آذار
وكنتُ في
طُفُولتي -كما تقولُ جارةٌ قديمةٌ في حيِّنا-
مُسْتَنْفَراً
للعشقِ.. مثلَ الديكِ..
كانت
مهنتي أن أجمعَ النساءَ في قارورةٍ وأجمعَ الأزهار..
وعندما
جاءَ أبي في آخرِ النهار
قال لأمي ضاحكاً:
( استبشري
يا فائزةْ..)
هذا الذي
أنجبتهِ ليسَ بطفلٍ أبداً.. لكنهُ إعصارْ..
حليبُ
أمي.. كان حبراً أبيضاً
وثديُها
علمني صناعةَ الفخارْ
وُلدتُ في
دمشقْ
بينَ
خِصاصِ الفلِّ.. والخبيزةِ الخضراءِ..
والنرجسِ..
والأضاليا..
ولم يزل
في لغتي
شيءٌ من القرفةِ،
والكمونِ، والبهارْ
مسقطُ
رأسي في دمشقَ الشامْ
حيث
البيوتُ امرأةٌ عاريةٌ
على بياضَ
نهدها..
تُراهقُ
الأنهار..
معجزةٌ أن
يولدَ الإنسانُ في مدينة
ترمى على
أكتافه
في الصيف
آلافاً من الأقمارْ..
ما كان
عندي أبداً مشكلة
فكل شيءٍ
هاهنا، وجدتُهُ ملحنا
الأرضُ،
والسماءُ، والحقول
والطيورُ،
والرياحُ والأمطارْ
كيف
أقولُ: إني ولدت ؟
ولم أزلْ
في بطن أمي جالساً
كفرخةٍ
مذبوحةٍ..
منتظراً
أن ياخذوا أمي
إلى طاولة
الولادة..
ولادتي..
كانت بلا
سابقة
لم يسحبِ
الطبيبُ رأسي أولاً
وإنما أعطيته
أصابعي..
شابتْ
حروفُ القلبِ، يا سيدتي
وشابتِ
الأوراقُ والأقلامْ
ولم أزلْ
من ألفِ.. ألفِ عامْ
في غرفة
الولادة
منتظراً
ولادتي الأخرى، على يديكِ
منتظراً
أن تفتحي الأقفاصَ يا سيدتي..
كي يخرجَ
الحمام..
اعلى

يوم
ولدتُ في 21 آذار
(مارس) 1923 في بيت من
بيوت دمشق القديمة، كانت الأرض هي الأخرى في حالة ولادة.. وكان الربيع يستعد لفتح
حقائبه الخضراء.
الأرض
وأمي حملتا في وقت واحد.. ووضعتا في وقت واحد.
هل
كانت مصادفة يا ترى أن تكون ولادتي هي الفصل الذي تثور فيه الأرض على نفسها، وترمي
فيه الأشجار كل أثوابها القديمة؟ أم كان مكتوباً عليَ أن أكون كشهر آذار، شهر
التغيير والتحولات؟.
كل
الذي أعرفه أنني يوم ولدتُ، كانت الطبيعة تنفذ انقلابها على الشتاء.. وتطلب من
الحقول والحشائش والأزهار والعصافير أن تؤيدها في انقلابها..
على روتين الأرض.
هذا
ما كان يجري في داخل التراب، أما في خارجه فقد كانت حركة المقاومة ضدّ الانتداب
الفرنسي تمتد من الأرياف السورية إلى المدن والأحياء الشعبية. وكان حي (الشاغور)،
حيث كنا نسكن، معقلاً من معاقل المقاومة، وكان زعماء هذه الأحياء الدمشقية من تجار
ومهنيين، وأصحاب حوانيت، يمولون الحركة الوطنية، ويقودونها من حوانيتهم ومنازلهم.
أبي،
توفيق القباني، كان واحداً من هؤلاء الرجال، وبيتنا واحداً من تلك البيوت.
و
يا طالما جلست في باحة الدار الشرقية الفسيحة، أستمع بشغف طفولي غامر، إلى الزعماء
السياسيين السوريين يقفون في إيوان منزلنا، ويخطبون في ألوف الناس، مطالبين
بمقاومة الاحتلال الفرنسي، ومحرضين الشعب على الثورة من أجل الحريّة.
وفي
بيتنا في حي (مئذنة الشحم) كانت تعقد الاجتماعات السياسية ضمن أبواب مغلقة، وتوضع
خطط الإضرابات والمظاهرات ووسائل المقاومة. وكنا من وراء الأبواب نسترق الهمسات
ولا نكاد نفهم منها شيئاً..
ولم
تكن مخيلتي الصغيرة في تلك الأعوام من الثلاثينيات قادرة على وعي الأشياء بوضوح.
ولكنني حين رأيت عساكر السنغال يدخلون في ساعات الفجر الأولى منزلنا بالبنادق
والحراب ويأخذون أبي معهم في سيارة مصفحة إلى معتقل (تدمر) الصحراوي..
عرفت أن أبي كان
يمتهن عملاً آخر غير صناعة الحلويّات.. كان يمتهن صناعة الحريّة.
كان
أبي إذن يصنع الحلوى ويصنع الثورة. وكنت أعجب بهذه الازدواجية فيه، وأدهش كيف يستطيع
أن يجمع بين الحلاوة وبين الضراوة..
اعلى

أدمنتُ
أحزاني
فصِرتُ
أخافُ أن لا أحزنا
وطُعنت
آلافاً من المرّاتِ
حتى صار
يوجعُني، بأن لا أُطعنا
ولُعنتُ
في كل اللغاتِ..
وصار
يُقلِقُني بأن لا أُلعنا..
ولقد
شُنِقتُ على جدارِ قصائدي
ووصيتي
كانت..
بأن لا
أُدفنا
وتشابهت
كلُ البلادِ
فلا أرى
نفسي هناكَ
ولا أرى
نفسي هنا
وتشابهت
كلُ النساءِ
فجسم
مريمَ في الظلام كما مُنى..
ما كان
شعري لعبةً عبثيةً
أو نزهةً
قمرية
إني أقولُ
الشعرَ -سيدتي-
لأعرفَ من
أنا..
يا سادتي:
إني أسافر
في قطار مدامعي
هل يركب الشعراءُ
الاّ في قطارات الضنى؟
إني أفكر
باختراع الماءِ..
إن الشعرَ
يجعل كل حلمٍ ممكنا
وأنا
افكرُ باختراعِ النهدِ..
حتى
تطْلِعَ الصحراءُ، بعدي سوسنا
وأنا أفكر
باختراع النايِ
حتى يأكلَ
الفقراءُ بعدي “ الميجنا ”
إن صادروا
وطن الطفولة من يدي
فلقد جعلت
من القصيدة موطنا..
يا سادتي:
إن
السماءَ رحيبةٌ جداً
ولكن
الصيارفةَ الذين
تقاسموا
ميراثنا..
وتقاسموا
أوطاننا..
وتقاسموا
أجسادَنا..
لم يتركوا
شبراً لنا..
يا سادتي:
قاتلت
عصراً لامثيلَ لقبحهِ
وفتحت جرح
قبيلتي المتعفنا..
أنا لست
مكترثا
بكل
الباعةِ المتجولينَ
وكل
كتّابِ البلاطِ
وكل من
جعلوا الكتابةَ حرفةً مثل الزنى..
يا سادتي:
عفواً إذا
أقلقتكم
أنا لستُ
مضطراً
لأعلنَ توبتي
هذا أنا..
هذا أنا..
هذا أنا..
اعلى

في
التشكيل العائلي، كنت الولد الثاني بين أربعة صبيان وبنت، هم المعتز ورشيد وصباح
وهيفاء.
أسرتنا
من الأسر الدمشقية المتوسطة الحال. لم يكن أبي غنياً ولم يجمع ثروة، كل مدخول معمل
الحلويات الذي كان يملكه، كان ينفق على إعاشتنا، وتعليمنا، وتمويل حركة المقاومة
الشعبية ضدّ الفرنسيين.
و
إذا أردت تصنيف أبي أصنفه دون تردد بين الكادحين، لأنه أنفق خمسين عاماً من عمره،
يستنشق روائح الفحم الحجري، ويتوسد أكياس السكَّر، وألواح خشب السحاحير..
وكان
يعود إلينا من معمله في زقاق (معاوية) كلَّ مساء، تحت المزاريب الشتائية كأنه
سفينة مثقوبة..
وإني
لأتذّكر وجه أبي المطلي بهباب الفحم، وثيابه الملطخة بالبقع والحروق، كلّما قرأت
كلامَ من يتّهمونني بالبورجوازية والانتماء إلى الطبقة المرفهة، والسلالات ذات
الدم الأزرق..
أي
طبقة.. وأي دم أزرق.. هذا الذي يتحدثون عنه؟
إن
دمي ليس ملكياً، ولا شاهانياً، وإنما هو دم عادي كدم آلاف الأسر الدمشقية الطيبة
التي كانت تكسب رزقها بالشرف والاستقامة والخوف من اللّه..
وراثياً،
في حديقة الأسرة شجرة كبيرة..
كبيرة..
اسمها أبو خليل القباني. إنه عمّ والدتي وشقيق جدّ والدي..
قليلون
منكم
-ربّما- من يعرفون هذا الرجل.
قليلون
من يعرفون أنه هزّ مملكة، وهزَّ باب (الباب العالي) وهزَّ مفاصل الدولة
العثمانيَّة، في أواخر القرن التاسع عشر.
أعجوية
كان هذا الرجل. تصوَّروا إنساناً أراد أن يحول خانات دمشق التي كانت تزرب فيها
الدواب إلى مسارح.. ويجعل من دمشق المحافظة، التقيّة، الورعة.. (برودواي) ثانية..
خطيرة
كانت أفكار أبي خليل. وأخطر ما فيها أنه نفَّذها.. وصُلب من أجلها..
أبو
خلبل القبّاني كان إنسكلوبيديا بمئة مجلد ومجلد.. يؤلف الروايات، ويخرجها، ويكتب
السيناريو، ويضع الحوار، ويصمم الأزياء، ويغني ويمثل، ويرقص، ويلحّن كلام
المسرحيات، ويكتب الشعر بالعربية والفارسيّة.
وحين
كانت دمشق لا تعرف من الفن المسرحيّ غير خيمة (قره كوز) ولا تعرف من الأبطال، غير
أبي زيد الهلالي، وعنترة، والزير..
كان أبو خليل يترجم لها راسّين عن الفرنسية..
وفي
غياب العنصر النسائي، اضطر الشيخ إلى إلباس الصبية ملابس النساء، وإسناد الأدوار
النسائية إليهم، تماماً مثلما فعل شكسبير في العصر الفيكتوري.
وطار
صواب دمشق، وأصيب مشايخها، ورجال الدين فيها بإنهيار عصبيّ، فقاموا بكل ما يملكون
من وسائل، وسلّطوا الرعاع عليه ليشتموه في غدوه ورواحه، وهجوه بأقذر الشعر، ولكنه
ظل صامداً، وظلّت مسرحياته تعرض في خانات دمشق، ويقبل عليها الجمهور الباحث عن
الفن النظيف.
وحين
يئس رجال الدين الدمشقيون من تحطيم أبي خليل، ألفوا وفداً ذهب إلى الأستانة وقابل
الباب العالي، وأخبره أنَّ أبا خليل القباني يشكل خطراً على مكارم الأخلاق،
والدين، والدولة العليّة، وأنه إذا لم يُغْلَق مسرحه، فسوف تطير دمشق من يد آل عثمان..
وتسقط الخلافة.
طبعاً
خافت الخلافة على نفسها، وصدر فرمان سلطاني بإغلاق أول مسرح طليعي عرفه الشرق
وغادر أبو خليل منزله الدمشقي إلى مصر، وودّعته دمشق كما تودّع كلُّ المدن
المتحجرة موهوبيها، أي بالحجارة، والبندورة، والبيض الفاسد..
وفي
مصر، التي كانت أكثر إنفتاحاً على الفن، وأكثر فهماً لطبيعة العمل الفني، أمضى أبو
خليل بقيَّة أيام حياته، ووضع الحجر الأول في بناء المسرح الغنائي المصري.
إن
انقضاض الرجعيّة على أبي خليل، هو أول حادث استشهاد فنيّ في تاريخ أسرتنا.. وحين أفكر
في جراح أبي خليل، وفي الصليب الذي حمله على كتفيه، وفي ألوف المسامير المغروزة في
لحمه، تبدو جراحي تافهة..و صليبي صغيراً صغيراً
فأنا
أيضاً ضربتني دمشق بالحجارة، والبندورة، والبيض الفاسد.. حين نشرتُ عام 1954
قصيدتي (خبز وحشيش وقمر)..
العمائم
نفسها التي طالبت بشنق أبي خليل طالبت بشنقي.. والذقون المحشوّة بغبار التاريخ
التي طلبت رأسه طلبت رأسي..
(خبز
وحشيش وقمر) كانت أول مواجهة بالسلاح الأبيض بيني وبين الخرافة.. وبين
التاريخّين..
اعلى

أنا
لا أسكن في أي مكان
إن
عنواني هو اللامنتظر ..
مبحرا
كالسمك الوحشي في هذا المدى
في
دمي نار .. وفي عيني شرر
ذاهبا
أبحث عن حرية الريح،
التي
يتقنها كل الغجر..
راكضا
خلف غمام أخضر
شاربا
بالعين آلاف الصور
ذاهبا
.. حتى نهايات السفر ..
مبحرا
.. نحو فضاء آخر
نافضا
عني غباري
ناسيا
اسمي ..
وأسماء
النباتات ..
وتاريخ
الشجر..
هاربا
من هذه الشمس التي تجلدني
بكرابيج
الضجر ..
هاربا
من مدن نامت قرونا
تحت
أقدام القمر ..
تاركا
خلفي عيونا من زجاج
وسماء
من حجر ..
ومضافات
تميم ومضر ..
لا
تقولي : عد إلى الشمس .. فإني
أنتمي
الآن إلى حزب المطر..
اعلى

قاتلت
بالأسنان
كي
أحمل الماء إلى قـبـيـلتي
وأجعل
الصحراء بستـانا من الألوان
وأجعل
الكلام من بنفسج ٍ
وضحكة
المرأة من بنفسج ٍ
وثـديها
.. قمة عُـنـفوان ..
قاتـلت
بالسيـف وبالقصيدة
كي
أحمل الحب إلى مديـنـتي
وأغسل
القبح عن الوجوه والجدران
وأجعل
العصر أقـل قسوة ً
وأجعل
البحر أشـدّ زرقة
وأجعل
الناس ينـامون|
على
شراشف الحنان ..
قاتـلت
عصرا كامل
كي
أشعل النـيـران في ذاكرتي
وفي
ثـياب من تـبـقى من بـني عثمان .
وأوقف
الذكور عن إرهابهم
وأنـقـذ
النساء من أقبـية السلطان
حَـفِـظتُ
للكلمةِ كبـرياءَها
ولم
أسافر مرة ًواحدة
لأمدح
الأمين َ..
أو
لأمدح المأمون َ..
أو
لأمدح الخليـفـة النعمان ..
قاتـلت
خمسين سنة
حتى
أقيم دولة الحب التي أريدها
ودولة
الإنسان .
لكنني
اكتشفت أن ما كـتـبـته
ليس
سوى حفر ٍ على الصوان ..
وها
أنا، من بعد خمسين سنة
تأكلني
الأحزان
لأن
من حاولت أن أجعلهم آلهة
قد
تركوني خلفهم،
وفضلوا
عبادة الشيطان ..
اعلى

ما
تتلمذت على شعر المعري
ولم
أقرا تعاليم سليمان الحكيم
إنني
في الشعر لا آباء لي
فلقد
ألقيت آبائي جميعا في الجحيم
من
هو الشاعر يا سيدتي
إن
مشى فوق الصراط المستـقيم
اعلى

كان
الشاعر يأكل من أوراق الورد
وكان
ينام بأحضان الصفصاف
ثم
أتى عصر عربي
صار
الشاعر فيه
ينام
بأحضان السياف ..
اعلى

لم
اخطط كي ادخل العشـق
فتـاريخي
النسائي قضاء وقدر
كم
تفاجأت بحب امرأة
جعلتـني
وردة بعدما كنـت حجر
اعلى

الكاتب
في وطني
يتكلم
كل لغات العالم
إلا
العربية
فلديـنا
لغة مرعبة
قد
سدوا فيها كل ثقوب الحرية
اعلى

الشعر
هندسة حروف وأصوات ورؤى نعمر بها في نفوس الآخرين عالما يشابه عالمنا الداخلي.
والشعراء
مهندسون لكل واحد منهم طريقته وأسلوبه في بناء الحروف وتعميرها. فالحجر متوفر
للجميع ولكن القلة من الموهوبين هي التي تعرف أين تضعه وكيف تضعه.
وبالرغم
من اعترافنا بوجود قواعد أساسية للفن الهندسي، فإن حرية المهندس تبقى لا حدود لها،
وهي التي تتيح له في كل لحظة أن يحذف، ويضيف ويعدل في تفاصيل مخططه حتى يقتنع
بكماله الفني.
معنى
هذا أن هندسة القصيدة، أي وضع سلمها الموسيقي، عمل مرتبط أعمق الارتباط بحرية
الشاعر، ومهارته، ومعرفته بكيمياء اللفظة. ومعنى هذا أيضا أن موسيقى الشعر ليست
مخطوطة كلاسيكية محفوظة في متحف لا يسمح لنا بلمسها وبإخراجها إخراجا جديدا.
إن
بحور الشعر العربي الستة عشر، بتعدد قراراتها وتفاوت نغماتها هي ثروة موسيقية
ثمينة بين أيدينا وبإمكاننا أن نتخذها نقطة انطلاق لكتابة معادلات موسيقية جديدة
في شعرنا.
إن
ذوقنا الموسيقي تطور ونما وتأثر إلى حد بعيد بالبناء السمفوني المركب في الموسيقى
الأوروبية، وبالأصوات الحادة الممزقة التي نسمعها كل يوم كموسيقى الجاز والبوق
والصنوج النحاسية.
لقد
تجاوزنا مرحلة (ربابة الراعي) بإيقاعها البدائي البسيط إلى مرحلة البناء الموسيقي
المتداخل وانتهت في حياتنا مرحلة (القصيدة العصماء) بأبياتها المئة تجلد أعصابنا
بقواف نحاسية مرصوصة كأسنان المشط.. نعرفها قبل أن نعرفها.
ليس
الشعر صنوجا تضرب في حلقة ذكر ولا ترتيلا مريضا يقرأ على الأضرحة. ولكنه همس خافت
يتجاوز الأذن الخارجية ليختلط بلحمنا. وأعصابنا.ووجودنا وإنسانيتنا.
الشعر
العربي الحديث يسمع بالعين، أي أنه موسيقى مقروءة وهذا دليل آخر على دخوله مرحلة
التحضير. اليسار بلغة الشعر:
الشعر
هو همس الإنسان للإنسان. هذه هي حقيقة الشعر منذ هوميروس إلى فاليري. إذن فالشعر
أداة نقل راقية بين الهامس والمهموس له. أداة تصلنا بالآخرين وتوحدنا معهم.
ووسيلة
الشعر إلى الناس هي اللغة، وهذا يقودنا إلى طرح السؤال التالي: هل هناك لغة شعرية؟
هل هناك حدود بين لغة نستعملها لكتابة القصيدة.. ولغة نستعملها لكتابة الرواية أو
المقالة؟.
أنا
شخصيا أرفض تقسم اللغة إلى مناطق جغرافية ومناخات.
فاللغة
هي هواء مشاع يتنفسه الجميع ونقد موحد مطروح في كل يد.
وإذا
كانت اللغة هي الحجارة التي نبني بها أفكارنا فإن الشعر هو ذلك الفن الهندسي الذي
يحول الحجارة إلى قصور كقصور ألف ليلة وليلة.
كل
الكلمات بلا استثناء هي موضوع للشعر. والفن الشعري هو ذلك الساحر الذي يحول النحاس
إلى ذهب.. ويقلب التراب إلى ضوء.
إن
اليمين متعصب للغة "الأغاني" و"العقد الفريد" ولديه عن
البلاغة والفصاحة مفهوم لا يقبل أن يتزحزح عنه. لذلك فهو ينظر شذرا إلى كل إنتاج
جديد ويعتبره مثالا للضعف والركاكة.
أما
اليسار فهو يؤمن بأن لغة الحديث اليومي بكل حرارتها وزخمها وتوترها هي لغة الشعر
وأن الكلمة هي الكلمة التي تعيش بيننا.. في بيوتنا.. وحوانيتنا.. ومفاهيمنا لا
الكلمة المدفونة في أحشاء القاموس.
لقد
نزل الشعر- نتيجة للمد الاشتراكي والماركسي- عن أرستقراطيته، ولم يعد متاع
النبلاء.. ولهو الخلفاء.. لم يعد الشعر كأس ذهب في يد أمير بل أصبح قطعة خبز في فم
كل جائع للخبز والحرية.
ونحن
إذا نادينا بشعر هامس كلغة الحديث اليومي فهذا يعني بالطبع الهبوط به إلى ظلمات
الأزقة ومستنقع العامية. كل ما نطلبه أن يكون شعرنا- في المرحلة الثقافية التي نحن
فيها- صورة لهذه الثقافة وانعكاسا لها.
إن
لغة المثقفين في جميع البلاد العربية هي القاسم المشترك الصحيح والمادة الأولية
التي يجب أن نستعملها في كل ما نكتب من قصة أو نقد أو مقالة.
قد
لا تكون هذه اللغة (أكاديمية) مئة بالمئة.. وقد لا تكون معجمية مئة بالمئة. ولكنها
على أي حال تشبهنا. أنها جزء من شفاهنا.. من كتبنا.. من جرائدنا.. من رسائلنا.
إنها
اللغة التي نحب بها.. ونضحك بها.. ونبكي بها..
اعلى

من يوميات تلميذ راسب
ما
هو المطلوب مني ؟
ما
هو المطلوب بالتحديد مني ؟
إنني
أنفقت في مدرسة الحب حياتي
وطوال
الليل .. طالعت .. وذاكرت ..
وأنهيت
جميع الواجبات ..
كل
ما يمكن أن أفعله في مخدع الحب، فعلته ..
كل
ما يمكن أن أحفره في خشب الورد، حفرته ..
كل
ما يمكن أن أرسمه ..
من
حروف .. ونقاط .. ودوائر ..
قد
رسمته ..
فلماذا
امتلأت كراستي بالعلامات الرديئة ؟.
ولماذا
تستهيـنـيـن بـتاريخي ..
وقدراتي
.. وفـني ..
أنا
لا أفهم حتى الآن، يا سيدتي
ما
هو المطلوب مني ؟
ما
هو المطلوب مني ؟
يشهد
الله بأني ..
قد
تفرغت لنهديك تماماً ..
وتصرفت
كفنان بدائي ..
فأنهكت
وأوجعت الرخاما
إنني
منذ عصور الرق .. ما نلت إجازة
فأنا
أعمل نحاتا بلا أجر لدى نهديك
مذ
كنت غلاما ..
أحمل
الرمل على ظهري ..
وألقيه
ببحر اللانهاية
أنا
منذ السنة الألـفـين قبل الـنهد ..
ـ
يا سيدتي ـ أفعل هذا ..
فلماذا
؟
تطلـبـين
الآن أن أبدأ ـ يا سيدتي ـ منذ البداية
ولماذا
أطعن اليوم بإبداعي ..
وتشكيلات
فـني ؟
ليـتـني
أعرف ماذا ..
يبتغي
النهدان مني ؟؟
ما
هو المطلوب مني ؟
كي
أكون الرجل الأول ما بين رجالك
وأكون
الرائد الأول ..
والمكتشف
الأول ..
والمستوطن
الأول ..
في
شعرك .. أو طيات شالك ..
ما
هو المطلوب حتى أدخل البحر ..
وأستلقي
على دفء رمالك ؟
إنني
نفذت حتى الآن
آلاف
الحماقـات لإرضاء خيالك
وأنا
استشهدت آلاف من المرات
من
أجل وصالك ..
يا
التي داخت على أقـدامها
أقـوى
المـمــالـك ..
حرريني
..
من
جنوني .. وجمالك ..
ما
هو المطلوب مني ؟
ما
هو المطلوب حتى قطتي تصفح عني ؟
إنني
أطعمتها ..
قمحا
.. ولوزا .. وزبيبا ..
وأنا
قدمت للنهدين ..
تفاحاً
..
وخمراً
..
وحليباً
..
وأنا علقت في رقبتها ..
خرزا
أزرق يحميها من العين،
وياقوتاً
عجيباً ..
ما
الذي تطلبه القطة ذات الوبر الناعم مني ؟
وأنا
أجلستها سلطانة في مقعدي ..
وأنا
رافـقـتـها للبحر يوم الأحد ..
وأنا
حممتها كل مساء بيدي ..
فلماذا
؟
بعد
كل الحب .. والتكريم ..
قد
عضت يدي ؟.
ولماذا
هي تدعوني حبـيـباً .
وأنا
لست الحـبـيـبـا ..
ولماذا
هي لا تمحو ذنوبي ؟
أبداً
.. والله في عليائه يمحو الذنوبا ..
ما
هو المطلوب أن أفعل
كي
أعلن للعشق ولائي .
ما
هو المطلوب أن أفعل
كي
أدفن بين الشهداء؟
أدخلوني
في سبيل العشق مستشفى المجاذيب..
وحتى
الآن ـ يا سيدتي ـ ما أطلقـوني ..
شنقوني
ـ في سبيل الشعر ـ مرات .. ومرات..
ويبدو
أنهم ما قـتـلوني ..
حاولوا
أن يقلعوا الثورة من قلبي .. وأوراقي .. ويبدو أنهم ..
في
داخل الثورة ـ يا سيدتي ـ قد زرعوني ..
يا
التي حبي لها ..
يدخل
في باب الخرافات ..
ويستـنزف
عمري .. ودمايا ..
لم
يعد عندي هوايات
سوى
أن أجمع الكحل الحجازي الذي بعثرتِ في كل الزوايا ..
لم
يعد عندي اهتمامات سوى ..
أن
أطفئ النار التي أشعلها نهداك في قلب المرايا ..
لم
يعد عندي جواب مقنع ..
عندما
تسألني عنك دموعي .. ويدايا
اشربي
قهوتك الآن .. وقولي
ما
هو المطلوب مني ؟
أنا
منذ السنة الألفين قبل الثغر ..
فكرت
بثغرك ..
أنا
منذ السنة الألـفين قبل الخيل ..
أجري
كحصان حول خصرك ..
وإذا
ما ذكروا النيل ..
تباهيت
أنا في طول شعرك
يا
التي يأخذني قـفطانها المشغول بالزهر ..
إلى
أرض العجائب ..
يا
التي تنتشر الشامات في أطرافها مثل الكواكب ..
إنني
أصرخ كالمجنون من شدة عشقي ..
فلماذا
أنت، يا سيدتي، ضد المواهب ؟
إنني
أرجوك أن تبـتسمي ..
إنني
أرجوك أن تـنسجمي ..
أنت
تدرين تماما ..
أن
خبراتي جميعا تحت أمرك
ومهاراتي
جميعا تحت أمرك
وأصابعي
التي عمـّـرتُ أكوانا بها
هي
أيضا ..
هي
أيضا ..
هي
أيضا تحت أمرك ..
اعلى

ليس
في ذهني سؤال واضح
لسؤالاتك
يا سيدتي
كل
ما اعرفه
أنني
ازداد حزنا
حين
عيـناك تـزيـدان اتساعا وسوادا
أنا
لا أكتب في الغربة شعرا
إنني
أنكـش جمرا ورمادا
ما
الذي من لغة الشاعر يـبـقى
عندما
يشتعل اللون الرمادي مدادا
ما
الذي من عنفوان الشعر يـبـقى .. عندما
يصبح
الكرسي في المقهى .. بلادا ؟
اعلى

لو كنت
أعرف ما أريد
ما جئت
ملتجئا إليك كقطة مذعورة
لو كنت
أعرف ما أريد
لو كنت
أعرف أين أقضي ليلتي
لو كنت
أعرف أين أسند جبهتي
ما كان
أغراني الصعود
لاتسألي:من
أين جئت،وكيف جئت،وما أريد
تللك
السؤالات السخيفة مالدي لها ردود
ألديك
كبريت وبعض سجائر؟
ألديك أي
جريدة ماهم ما تاريخها
كل
الجرائد ما بها شيء جديد
ألديك-سيدتي-
سرير آخر
في الدار،
إني دائما رجل وحيد
أنت ادخلي
نامي
سأصنع
قهوتي وحدي ،
فإني
دائما ..رجل وحيد
تغتالني
الطرقات.. ترفضني الخرائط والحدود
أما
البريد.. فمن قرون ليس يأتيني البريد
هاتي
السجائر واختفي
هي كل ما
أحتاجه
هي كل ما
يحتاجه الرجل الوحيد
لا تقفلي
الأبواب خلفك..
إن أعصابي
يغطيها الجليد
لاتقفلي
شيئا.. فإن الجنس آخر ما أريد
اعلى

أركبي
آلاف القطارات
وأمتطي
فجيعتي
وأمتطي
غيم سجائري
حقيبة
واحدة أحملها
فيها
عناوين حبيباتي
من
كن ، بالأمس ، حبيباتي
يمضي
قطاري مسرعا .. مسرع
يمضغ
في طريقه لحم المسافات
يفترس
الحقول في طريقه
يلتهم
الأشجار في طريقه
يلحس
أقدام البحيرات
يسألني
مفتش القطار عن تذكرتي
وموقفي
آلاتي
وهل
هناك موقف آتي ؟
فنادق
العالم لا تعرفني
ولا
عناوين حبيباتي
أنا
قطار الحزن
لا
رصيف لي
أقصده
.. في كل رحلاتي
أرصفتي
جميعها .. هاربة
هاربة
.. مني محطاتي
اعلى

يا
سائلي عن حاجتي
الحمد
لله على الصحة والرغيـف
وما
تـقول الصحف اليومية..
عندي
صغار يملأون البـيـت
وزوجة
وفــيّـه
وفي
الخوابي حنطة وزيت .
لكنما
مشكلـتي ..
ليست
مع الخبـز الذي آكله
ولا
مع الماء الذي أشربه
مشكلتي
الأولى هي الحرية ..
اعلى

في
بلاد الغرب يا سيدتي
يولد
الشاعر حرا
مثـلما
الأسماك في عرض البحار
ويغني
..
بين
أحضان البحيـرات
وأجراس
المراعي
وحقول
الجلنـار .
ولديـنا
يولد
الشاعر في كيس غبار
ويغني
لملوك من غبار
وخيول
من غبار
وسيوف
من غبار
إنها
معجزة .
أن
نزرع الأزهار
ما
بـين حصار، وحصار ..
نحن
لا نكتب
مثـل الشاعر الغربي -، شعرا
إنما
نكتب يا سيدتي،
صك
انـتـحار ..
اعلى

إن
القصيدة العربية ليس لها مخطط. والشاعر العربي هو صياد مصادفات من الطراز الأول..
فهن ينتقل من وصف سيفه.. إلى ثغر حبيبته ويقفز من سرج حصانه.. إلى حضن الخليفة
بخفة بهلوان.. وما دامت القافية مواتية، والمنبر مريحا فكل موضوع هو موضوعه.. وكل
ميدان هو فارسه.. من حطين.. إلى اليرموك. إلى القدس.. إلى الجزائر إلى آخر هذا
الفيلم الإخباري الذي يعرضه علينا شعراء اليمين كما تعرض على الجمهور البسيط أفلام
رعاة البقر، فلا تتجاوز الإثارة سطح جلده.
في
هذه النقطة بالذات يتفوق اليمين على اليسار، أو هكذا يخيل إلينا. فالفخامة
والجزالة وتساقط الحروف العربية وتكسرها يحقق لها نجاحا منبريا أكيدا لأن جمهورنا
ورث مع ما ورث غريزة التطريب وحسه الموسيقي مرتبط تاريخيا بالآلات ذات الوتر
الواحد وبالأدوار الشرقية التي تعتمد على تكرار النغمة الواحدة بشكل دوري.
أما
الشاعر العربي الحديث فلا يحاول استعمال طريقة التخدير الموضعي هذه ولا يلجأ إليها
لأن اللغة لديه ليست غاية يحد ذاتها ولكنها مفاتيح إلى عوالم أرحب وأبعد. وقيمة
الحروف تكون بقدر ما تثيره حولها من رؤى وظلال وتبعثه من إيحاءات. إن البناء
الموسيقي في قصيدة الشاعر الحديث مركب من فلذات نغمية تعلو وتخف، وتصطدم وتفترق،
وترق وتقسو، وتهدأ وتنفعل.
ويتولد
من هذه الحركة الدائمة لذرات القصيدة موسيقى داخلية هي منها إلى البناء بالسمفوني
أقرب إلى دقات الساعة الرتيبة. إن ثورة اليسار على ناحية الشكل في القصيدة
التقليدية لا تعني أبدا رغبة اليساريين، أو المعتدلين منهم على الأقل، في إلغاء
هذا الشكل أو حذفه. إن وعيهم التاريخي والجمالي بطبيعة الشعر عامة وبطبيعة القصيدة
العربية خاصة وظروف نشأتها وتكونها، يمنعهم من التطرف والمغالاة.
إنهم
يؤمنون إن الإنسان هو الذي يصنع قوالبه وليست القوالب هي التي تصنع الإنسان، وليس
في الفن أشكال نهائية أو أبدية. فالأثواب الجاهزة لا تطيقها أجسام الموهوبين وكل
موهوب يختار الثوب الذي يستريح فيه.
إن
اليسار يرفض أن يضع أفكاره في قوالب كلسية جاهزة وهو يرى أن البيان والبديع
والطباق والجناس وما يتصل بها من فسيفساء لغوية ليست سواء (حذاء صيني) أعاق الفكر
العربي قرونا عن النمو والحركة.
مأساة
القافية: إن اليسار لا يطالب أبدا بإلغاء الأثواب الفضفاضة في شعرنا، لأنه يعرف أن
التخلي عن أثوابنا القديمة معناه العري الأدبي التام. ولكنه يطالب بتعديل هذه
الأثواب بشكل يجعلها عصرية.. وعملية.. ومريحة.
أنني
أستعمل هنا كلمة "مريحة" لأنها الكلمة الأصلح لما أريد التعبير عنه. فلا
شاعر عربي- مهما كان مجيدا- يستطيع أن يدعي أن جميع قوافيه مستريحة وأنه دائما في
أحسن حالاته.
فالقافية،
برغم كل سحرها وإثارتها- نهاية يقف عندها خيال الشاعر لاهثا. إنها اللافتة الحمراء
التي تصرخ بالشاعر "قف" حين يكون في ذروة اندفاعه وانسيابه.. فتقطع
أنفاسه وتسكب الثلج على وقوده المشتعل وتضطره إلى بدء الشوط من جديد. والبدء من
جديد معناه الدخول- بعد الصدمة- في مرحلة اليقظة أي مرحلة النثر. وبتكرر الصدمات
تصبح أبيات القصيدة عوالم نائية وطوابق مستقلة في بناية شاهقة.
هذه
الطريقة في عمارة القصيدة العربية جعلتها قصيدة بيت واحد، نستعمله في حديثنا حكمة
مرسلة ومثلا سائرا ونعلقه على جدران بيوتنا مكتوبا بماء الذهب.
وليس
"بيت القصيد" كما عرفناه سوى ذلك البيت من القصيدة الذي كتبه الشاعر وهو
في لحظة انسيابية الحر.. أي قبل اصطدامه بأي حاجز مصطنع.
وربما
كانت ظروف الشاعر العربي القديم وحياته غير المستقرة وعدم توفر أدوات الكتاب بين
يديه هي التي جعلت فنه مخزونا في طرف لسانه واضطرته إلى الإيجاز والتركيز وتضمين
فلسفته وعواطفه ونظراته إلى الوجود في بيت شعر مكثف يسهل حفظه وروايته.
اعلى

شكرا
.. لمن يقرؤونا
على
امتـداد هذه الخريطة الرملية
شكرا
..لمن يقرؤونا
في
الغرف السرية
فنحن
كتاب بلا أصابع
وأنبياء
دون أبجدية ..
اعلى

الكاتبان
الكاتـب
الكبـير
هو
الذي تـنخر في عظامه
جرثومة
الشجاعة
والكاتـب
الصغيـر
هو
الذي يـبلع قبل نومه
برشامة
القناعة ..
اعلى

ان (الدونجوانية) صفة لا تنطبق
عليّ أبدا..
فالدونجوان
– كما نعرفه – شخص عابث ومتحلل، وهوائي المزاج.. والحب عنده سفر طويل على أجساد كل
النساء..
الدونجوان
بهلوان محترف لا تعنيه فكرة الحب، ولا يتعامل بها أصلا.
انه
مسافر لا مرافئ له.. ولا محطات..
أما
أنا فمسافر من نوع آخر. مسافر لا يرفض كل المرافئ.. وإنما في ذهنه صورة لمرفأ معين
لا يعرف أين هو.. ومتى يلاقيه.
إن
(الدونجوانية) ليست في طبيعتي ولا تركيـبي، وتجارة الجواري ليست حرفتي.
إنني
لا أؤمن بشراء المرأة أصلا، ولا أستطيع أن أنفّذ الحب مع امرأة أشعر أنها تبيعني
جسدها..
حتى
في أيام مراهقتي لم تكن سوق البغاء مكان خلاص لي، كما كانت بالنسبة لمن هم في نفس
السن من أصدقائي..
كنت
أشعر أمام المومس بوجع إنساني لا نهاية له. كأنني أحمل كل خطايا العالم على ظهري..
كنت
حين أخرج من مخدع بغي أعتذر لجسدي.. وأبكي أمامه كطفل مذنب علّه يسامحني.
إذن
فالجسد عندي ليس جدارا تنتهي عنده الدنيا.. ولا هو قرص منوّم أبلعه وأنام..
أنا
لا أستطيع أن أفصل الجسد عن صاحبة الجسد.. وإلا كان بوسع أي رجل في العالم أن ينام
مع أية جثة في مشرحة..
إنني
أعرف رجالا كثيرين قضوا نصف عمرهم في المشرحة، يحبون على طريقة القصّابين،
ويمارسون الجنس على طريقة القصّابين، لا يفّرقون بين النعجة والبقرة، وبين المرأة
وبين الذبيحة..
هؤلاء
في نظري لا ينتمون إلى فصيلة البشر، وإنما إلى فصيلة أكلة لحوم البشر..
إن
الجنس، مهما قيل فيه، هو حوار ذكي بين جسدين. هو توغل في غابات الفرح. هو معركة
أولاد على سرير من الرمل الناعم.. لا غالب فيها ولا مغلوب.
هذا
موقفي الأساسي من الحب ومن الجنس.
والذين
عرفوني عن قرب، يعرفون أنني في كل علاقاتي العاطفية كنت ملتزما مبدأ الصدق مع نفسي
ومع من عرفتهن.
حتى
في علاقاتي الغابرة، لم أمارس التغرير ولا الخديعة، ولم أعمّر قصورا في إسبانيا
لأية امرأة بقصد التقرّب والزلفى.
إن
كلماتي كانت دائما بحجم عواطفي، ولم أقل أبدا لامرأة (أنت حبيبتي) إلا إذا كنت
فعلا أعني ما أقول.
ولقد
خسرت كثيرا من النساء.. بسبب ضعف موهبتي (التمثيلية).. ورفضي المستمر ارتداء ملابس
المهرّجين.. وطلاء عواطفي بألف لون ولون.. وتمثيل دور أنا غير مقتنع به أساسا..
إنني
لا أدخل في حديث تلفوني مع مجهولة أبدا.. ولا أستطيع أن أثرثر في الهاتف مع امرأة
ضحلة الفكر، وليس لديها ما تقوله. وفي الحفلات العامة لا أفرض نفسي على سيدة إلا
إذا شعرت أنها راغبة في محادثتي..
أنا
لا أحتمل الغوغائية بكل أشكالها، ولا سيما غوغائية العواطف.
وطريقة
عرض العاطفة، تهمني أكثر من العواطف ذاتها. فالحب، مهما كان كبيرا، يصبح رخيصا إذا
قُدِّم في إطار رخيص..
الحب
لا يفقدني بصيرتي ولا يفقدني توازني. فأنا أحب وأنا مفتوح العينين، وقادر على رؤية
من أحبها بحجمها الطبيعي.
الحب
الأعمى شيء لا أعترف به. فالحب لا يقوم على الغباء أو على التغابي. فلكي أحب
امرأة، من بين عشرة آلاف امرأة، لا بد أن أكون في حالة من الوعي والصفاء الذهني
تسمح لي باكتشاف ما يميزها عن بقية النساء..
قالت
لي احداهن مرة: أنت لا تحبني لأنك تفكر كثيرا. أجبتها: بل أنا أحبك.. لأنني أفكر
كثيرا..
هذه
النظرة إلى الحب تعرّضت لبعض التغيرات في جزء من شعري. والسبب في ذلك يعود إلى بعض
النماذج النسائية التي مرّت بي، وكانت وراء هذا التغيّر..
فمما
لا شك فيه أن كل امرأة تحمل معها حقيقتها.. وتدفعك بالتالي إلى اتخاذ موقف منها..
إن
التناقض شيء لا مفر منه، بل هو جزء لا يتجزأ من عمل الفنان.
وإنني
لأضحك من كل قلبي، كلما سألني أحدهم: كيف تقول في الحب عام 1940 كذا.. وكذا.. في
حين تقول في الحب عام 1972 ما يناقض قولك الأول.
إن
شعر الحب الذي كتبته يغطي مساحة ثلاثين عاما، رستْ فيها مراكبي على ألوف الموانئ،
واصطدمت بألوف النساء..
ومع
كل خطوة كان يتغيّر ذوقي، ويتغيّر منطقي، ويتغيّر لون حبري وعدد أصابعي..
منطق
الحب في دمشق، غيره في هونكونغ، غيره في سوهو.. غيره في دسلدورف، غيره في غرناطة..
غيره في شنغهاي.. غيره في شارح الحمراء وغاردن سيتي..
كل
امرأة من هذه المدن كانت قارة.. بصحوها.. ومطرها، وتقلّب طقسها..
كل
امرأة كانت كتابا مكتوبا بلغة جديدة.. وأسلوب جديد.
وكان
عليّ أن أكتشف كل القارات، وأقرأ كل الكتب.
من
كل امرأة.. تعلّمت كلمة.. من كتاب الحب.
من
الدمشقية تعلّمت الوداعة وانكسار الجفن، ومن العراقية تعلّمت الوضوح والكبرياء،
ومن الفرنسية تعلّمت الخبرة، ومن الصينية تعلّمت الحكمة، ومن الإنكليزية تعلّمت
العمق، ومن الإسبانية تعلّمت العنف، ومن اللبنانية اكتسبت خبرة الفينيقيين في
تغيير السفن، وتغيير المرافئ..
بعض
شعري يقدّمني للناسب بملامح (شهريار)، هذا الملك الدموي الذي حوّل سريره إلى مذبح
للجميلات، وحوّل حجرة نومه إلى مقبرة..
وحين
قلت في قصيدة (الرسم بالكلمات):
فصَّلتُ من جلد النساء عباءة
وبنيتُ أهراماً من الحَلَماتِ
لم يبقَ نهدٌ أبيضٌ.. أو أسود
إلا زرعتُ بأرضه راياتي
لم تبقَ زاويةٌ بجسم جميلة
إلا ومرَّتْ فوقها عَرَباتي
حين
قلت هذا الكلام، اعتبروا ذلك اعترافا خطيا مني بارتكاب الجريمة، وأدانوني
(بالشهريارية).
الذين
رأوا أثاث غرف نومي.. يعرفون أنها لا تحتوي إلا على سرير مفرد، ومنفضة سجائر،
ومصباح صغير، وقلم، ودفتر عليه خربشات غير مفهومة لقصائد لم تتم..
لا
سكاكين عندي، ولا قناني سُم، ولا مخططات لقتل أحد..
أنا
لا أحترف قتل الجميلات، وإنما أحترف عبادتهن.. ولو رجعت إلى حسابات عشقي القديمة،
لوجدت أنني في أكثر تجاربي العاطفية، كنت القتيل لا القاتل، والمذبوح لا الذابح..
إن
الرجل عادة يتحدث عن انتصاراته في الحب، ويسكت عن هزائمه. إن غروره لا يسمح له أن
يقول: سحقتني امرأة.. أو باعتني امرأة..
والواقع
أن أكثر من امرأة سحقتني، وأكثر من واحدة باعتني، أو استعملتني جسرا للشهرة، أو
حبستني كعصفور في قفص لأغني جمالها وأُرضي نرجسيتها.. أو استعملتني كساعي بريد
أحمل لها رسائل الحب في الصباح والمساء..
ومع
كل هذا.. ظل شهريار صامتا.
ظل
محتفظا بسرّه، وبأحزانه، وبمرارة هزائمه، لأن الناس لا يقتنعون بأن خنجره لا يغوص
في أجساد النساء، وإنما يغوص في لحمه هو..
إن
شهريار في نظري بريء من كل الجرائم المنسوبة اليه.. ومن حقه أن يطالب بإعادة
محاكمته.. وإعادة اعتباره.
وحين
ستُعاد محاكمته في القرن العشرين، على ضوء علم النفس، سيتبين أن الرجل لم يكن
قاتلا وإنما كان مضطرا إلى القتل بدافع الملل.. ملله من حريمه.. وملله من حاشيته،
وملله من عشرات الأجساد التي كانت تُحمل اليه كل ليلة كما تُحمل أطباق المشهّيات.
إن
شهريار كان فنانا وإنسانا وكان – وهذه هي النقطة الهامة في شخصيته – أُحادي النظرة
في الحب..
كان
يبحث في أعماقه.. عن امرأة.. امرأة واحدة تحبه.. لا لأنه ملك، ولا لأنه صاحب قوة
وسلطان.. ولكن لذاته..
إن
وليمة الجنس التي كانت تُقدّم إليه كل ليلة، أثارت قرفه وثورته، وليس السيف الذي
كان يغمده في أجساد النساء.. سوى رمز لقتل التفاهة.
وكشهريار،
كانت الوفرة تصيبني بالقرف والاشمئزاز، وكنت، كلما ارتفع عدد النساء في حياتي،
أزداد شعورا بغربتي وتوحّدي..
هذا
الشعور بالذنب، وصل إلى ذروته في لندن 1952-1955. فكنت كلما ودّعت امرأة.. أسقط
على فراشي باكيا، وفي حلقي بحارٌ من الملح والفجيعة..
لقد
كنت أبحث، مثل شهريار، عن امرأة تحبني لذاتي، لا لكوني شاعرا معروفا تحيط به
الخرافات والأساطير من كل جانب:
أحببتِني شاعرا طارتْ قصائدهُ
فحاولي مرةً أن تفهمي الرجُلا
وحاولي مرةً أن تفهمي مَلَلي
قد يعرفُ الله في فردوسه المللا..
هل
تفهمون الآن كم هي عميقة جراحات شهريار؟
اعلى

فرشتُ
فوقَ ثراكِ الطاهر الهدبا
فيا
دمشـقُ… لماذا نبـدأ العتبا؟
حبيبتي
أنـتِ… فاستلقي كأغنيـةٍ
على
ذراعي، ولا تستوضحي السببا
أنتِ
النساءُ جميعاً.. ما من امـرأةٍ
أحببتُ
بعدك..ِ إلا خلتُها كـذبا
يا
شامُ، إنَّ جراحي لا ضفافَ لها
فمسّحي
عن جبيني الحزنَ والتعبا
وأرجعيني
إلى أسـوارِ مدرسـتي
وأرجعيني
الحبرَ والطبشورَ والكتبا
تلكَ
الزواريبُ كم كنزٍ طمرتُ بها
وكم
تركتُ عليها ذكرياتِ صـبا
وكم
رسمتُ على جدرانِها صـوراً
وكم
كسرتُ على أدراجـها لُعبا
أتيتُ
من رحمِ الأحزانِ.. يا وطني
أقبّلُ
الأرضَ والأبـوابَ والشُّـهبا
حبّي
هـنا.. وحبيباتي ولـدنَ هـنا
فمـن
يعيـدُ ليَ العمرَ الذي ذهبا؟
أنا قبيلـةُ
عشّـاقٍ بكامـلـها
ومن
دموعي سقيتُ البحرَ والسّحُبا
فكـلُّ
صفصافـةٍ حّولتُها امـرأةً
و
كـلُّ مئذنـةٍ رصّـعتُها ذهـبا
هذي
البساتـينُ كانت بينَ أمتعتي
لما
ارتحلـتُ عـن الفيحـاءِ مغتربا
فلا
قميصَ من القمصـانِ ألبسـه
إلا
وجـدتُ على خيطانـهِ عنبا
كـم
مبحـرٍ.. وهمومُ البرِّ تسكنهُ
وهاربٍ
من قضاءِ الحبِّ ما هـربا
يا
شـامُ، أيـنَ هما عـينا معاويةٍ
وأيـنَ
من زحموا بالمنكـبِ الشُّهبا
فلا
خيـولُ بني حمـدانَ راقصـةٌ
زُهــواً..
ولا المتنبّي مالئٌ حَـلبا
وقبـرُ
خالدَ في حـمصٍ نلامسـهُ
فـيرجفُ
القبـرُ من زوّارهِ غـضبا
رُبَّ
حـيٍّ.. رخامُ القبرِ مسكنـهُ
ورُبَّ
ميّتٍ.. على أقدامـهِ انتصـبا
يا
ابنَ الوليـدِ.. ألا سيـفٌ تؤجّرهُ؟
فكلُّ أسيافنا قد أصبحـت خشـبا
دمشـقُ،
يا كنزَ أحلامي ومروحتي
أشكو
العروبةَ أم أشكو لكِ العربا
؟
أدمـت
سياطُ حزيرانَ ظهورهم
فأدمنوها..
وباسوا كفَّ من ضربا
وطالعوا
كتبَ التاريخِ.. واقتنعوا
متى
البنادقُ كانت تسكنُ الكتبا؟
سقـوا
فلسطـينَ أحلاماً ملوّنةً
وأطعموها
سخيفَ القولِ والخطبا
وخلّفوا
القدسَ فوقَ الوحلِ عاريةً
تبيحُ
عـزّةَ نهديها لمـن رغِبـا..
هل
من فلسطينَ مكتوبٌ يطمئنني
عمّن
كتبتُ إليهِ.. وهوَ ما كتبا؟
وعن
بساتينَ ليمونٍ، وعن حلمٍ
يزدادُ
عنّي ابتعاداً.. كلّما اقتربا
أيا
فلسطينُ.. من يهديكِ زنبقة
ً؟
ومن
يعيدُ لكِ البيتَ الذي خربا؟
شردتِ
فوقَ رصيفِ الدمعِ باحثةً
عن
الحنانِ، ولكن ما وجدتِ أبا..
تلفّـتي…
تجـدينا في مَـباذلنا..
من
يعبدُ الجنسَ، أو من يعبدُ الذهبا
فواحـدٌ
أعمـتِ النُعمى بصيرتَهُ
فللخنى
والغـواني كـلُّ ما وهبا
وواحدٌ
ببحـارِ النفـطِ مغتسـلٌ
قد
ضاقَ بالخيشِ ثوباً فارتدى القصبا
وواحـدٌ
نرجسـيٌّ في سـريرتهِ
وواحـدٌ
من دمِ الأحرارِ قد شربا
إن
كانَ من ذبحوا التاريخَ هم نسبي
على
العصـورِ، فإنّي أرفضُ النسبا
يا
شامُ، يا شامُ، ما في جعبتي طربٌ
أستغفرُ
الشـعرَ أن يستجديَ الطربا
ماذا
سأقرأُ مـن شعري ومن أدبي؟
حوافرُ
الخيلِ داسـت عندنا الأدبا
وحاصرتنا..
وآذتنـا.. فلا قلـمٌ
قالَ
الحقيقةَ إلا اغتيـلَ أو صُـلبا
يا
من يعاتبُ مذبوحـاً على دمـهِ
ونزفِ
شريانهِ، ما أسهـلَ العـتبا
من
جرّبَ الكيَّ لا ينسـى مواجعهُ
ومن
رأى السمَّ لا يشقى كمن شربا
حبلُ
الفجيعةِ ملتفٌّ عـلى عنقي
من
ذا يعاتبُ مشنوقاً إذا اضطربا؟
الشعرُ
ليـسَ حمامـاتٍ نـطيّرها
نحوَ
السماءِ، ولا ناياً.. وريحَ صَبا
لكنّهُ
غضـبٌ طـالت أظـافـرهُ
ما
أجبنَ الشعرَ إن لم يركبِ الغضبا
اعلى
حادثة

كل
يوم في لبنان كان يحمل لي مفاجأة جديدة، فيها كثير من دهشة الحلم، وألوان
الفانتازيا.
فبالإضافة
إلى حادثة العشق الأولى التي جرت لي على مرفأ بيروت في ربيع عام 1966، وكان
أبطالها رجالَ الجمارك اللبنانيين.
تعرّضت
لحادثة عشق أشد إثارة، وأكثر درماتيكية فوق ثلوج (ضهر البيدر) خلال فصل الشتاء من
العام ذاته، وتشبه في فصولها أحداث المسرح الإغريقي، ومسرحيات شكسبير.
ففي
يوم عاصف من أيام كانون الأول (ديسمبر) 1966 ركبت سيارتي الصغيرة، وانطلقت باتجاه
دمشق لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أهلي.
كان
الثلج في ضاحية (عاليه) و(بحمدون) و(صوفر) يهطل بشكل خفيف ومعتدل. فواصلت السير
على أمل انحسار العاصفة.
ولكن
ما إن تجاوزت منطقة (المديرج) صعودا إلى قمة (ضهر البيدر)، حتى ازدادت العاصفة
قوة، وبدأ الثلج الكثيف يغطي سقف السيارة، ونوافذها الأمامية والجانبية، والطريق
الجبلية الصاعدة، حتى أصبحت عجلات السيارة تدور على نفسها، وتسمّرت السيارة في مكانها..
كانت
الثلوج تزداد كثافة، والسيارة تختفي تحت الثلج تدريجيا، وأنا جالس في مقعد القيادة
لا أرى من حولي شيئا.. سوى الموت القادم بردائه الأبيض.. ولا أسمع سوى ضربات
قلبي.. وارتعاشات جسدي الذي بدأ يتجمد..
بدأت
أقرأ آيات من القرآن الكريم بصوت مرتجف، وأدعو الله أن يكون معي، ويلطف بي،
ويخرجني من تحت هذا الكفن الأبيض..
ولم
أكد أنتهي من ضراعتي، حتى سمعت ضربا شديدا على سقف السيارة..
فتحت
النافذة، فإذا بي أمام دركي لبناني يوجّه مصباح بطاريته إلى وجهي.. ويصرخ بدهشة
ظاهرة، وأفراد الدورية من حوله:
- لا أصدّق.. لا أصدّق.. هذا الأستاذ نزار
قباني.. تحاصره الثلوج. يا الله.. يا الله.. ماذا فعلتَ بنفسك يا أستاذ؟ وكيف صعدت
الجبل في عز العاصفة؟.. ألم يخبروك في مخفر الدرك بالمديرج بأن طريق (ضهر البيدر)
مقطوعة..
والتفت
إلى رفاقه الثلاثة في الدورية وهو يردّد:
- لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا حول ولا قوة
إلا بالله..
أستاذ نزار: ليس هناك وقت للكلام. إفعل ما
نطلبه منك.. ابقَ خلف المقود، واحلل فرامل اليد.. ونحن سنقوم بدفعك إلى (ضهر
البيدر)..
أجبت:
- حرام عليكم يا أخوان. فالمسافة إلى ضهر
البيدر تبلغ عدة كيلومترات.. والعاصفة على أشدها.. والرؤية متعذرة.. فكيف يمكنكم
سحبي إلى القمة؟..
أجابني
رئيس الدورية بصوت حاسم وآمرْ:
- لا تضيّع الوقت يا أستاذ نزار، فالموقف
خطير، ولا يمكننا أن نتركك وحدك.. لأن الثلوج ستدفنك بعد ساعات.. ونحن مسؤولون عن
حياتك، لأن حياتك ليست ملكك وحدك.. ولكنها ملك الملايين من العرب واللبنانيين
الذين كتبتَ لهم أجمل الشعر، وكنت صوت وجدانهم.. فكيف نتركك تموت.. أنت الذي
أعطيتنا بشعرك أمل الحياة؟؟
هذه أوامر الشعب اللبناني،
يا أستاذ، فأَطِع الأوامر..
وأخذ
رجال الدورية الأربعة يدفعون سيارتي، وأنا في داخلها أشعر بعذاب النفس ووجع
الضمير.. حتى رأيت بعد ما يقارب الساعة أضواء مخفر (ضهر البيدر) تتلألأ.. ورأيت
الضابط المسؤول عن المخفر يتقدم نحو رجال الدورية الذين يجرّون السيارة قائلا:
- شو القصة يا شباب؟ ظننت أن
العاصفة قد ابتلعتكم.. من معكم في هذه السيارة؟؟
فتقدم
منه رئيس الدورية، والتعب والكبرياء تقطران من عينيه، وقال له بعد أخذ التحية
العسكرية:
- يا سيدي الرئيسي: صحيح أننا تأخرنا.. ولكننا
حملنا لك معنا أجمل هدية.. انه الشاعر نزار قباني..
تقدّم
مني رئيس المخفر، وأخذني بالأحضان.. قائلا:
- مش معقول.. مش معقول.. كما أنا فخور أن رجال
الدرك اللبنانيين أنقذوا تاريخا من الشعر كاد يختفي تحت الثلج..
تفضّل، يا أستاذي، لنشرب
الشاي معا، وتستريح من عناء رحلتك السندبادية..
والتفت
إلى رجاله قائلا:
- شكرا يا شباب على بطولتكم.. وابتداء من الغد
سوف أصدر التعليمات بترقيتكم.. وزيادة مرتباتكم.. لأنكم جمعتم بين حماية الأمن..
وحماية الثقافة..
بعد
أن شربت الشاي، واسترحت قليلا لدى رئيس مخفر (ضهر البيدر).. طلب من أحد معاونيه أن
يرافقني إلى مدينة شتورة حيث طريق الشام آمنة.. ومفتوحة..
ودّعته..
وودّعت رجاله الشجعان الذين وهبوني عمرا جديدا.. وواصلت طريقي إلى دمشق، وفي طريقي
إليها كانت دموع صامتة تترقرق من عينيّ. وكنت أسأل نفسي:
أي
مصير كان ينتظرني يا تُرى لو لم أكن على أرض لبنانية؟ ولم أقع مصادفة بين أيدي درك
لبنانيين مثقفين.. يقرؤون الشعر، ويحفظونه.. ويرضعونه مع حليب أمهاتهم؟؟..
ماذا
كان مصيري يا تري، لو وقع الحادث على جبال الألب.. أو البيرنيه.. أو على المرتفعات
السويسرية أو الاسكوتلاندية؟..
أكيد
أنهم في محضر التحقيق.. سوف يسجلون رقم سيارتي.. وجواز سفري.. ومحتويات حقيبتي..
ولكنهم
لن يعرفوا تاريخي الشعري.. ولن ينقذوني من حصار الموت الأبيض.. كما فعل
اللبنانيون!!.
اعلى
تجليات

عندما
تسطع عيناك كقنديل نحاسي،
على
باب ولي من دمشق
أفرش
السجادة التبريز في الأرض وأدعو للصلاة..
وأنادي،
ودموعي فوق خدي: مدد
يا
وحيدا.. يا أحد..
أعطني
القوة كي أفنى بمحبوبي،
وخذ
كل حياتي..
عندما
يمتزج الأخضر، بالأسود، بالأزرق،
بالزيتي،
بالوردي، في عينيك، يا سيدتي
تعتريني
حالة نادرة..
هي
بين الصحو والإغماء،
بين
الوحي والإسراء،
بين
الكشف والإيماء،
بين
الموت والميلاد،
بين
الورق المشتاق للحب..
وبين
الكلمات..
وتناديني
البساتين
التي من خلفها أيضاً بساتين،
الفراديس
التي من خلفها أيضا فراديس،
الفوانيس
التي من خلفها أيضا فوانيس..
الزوايا
التي من خلفها أيضا زوايا،
وتكايا،
ومريدون
وأطفال
يغنون..
وشمع
.. وموالد ..
وأرى
نفسي طير من ذهب..
وسماء
من ذهب
ونوافير
يثرثرن بصوت من ذهب
وأرى،
فيما يرى النائم، شباكين مفتوحين..
من
خلفهما تجري ألوف المعجزات..
عندما
يبدأ في الليل،
احتفال
الصوت والضوء.. بعينيك ..
وتمشي
فرحا كل المآذن..
يبدأ
العرس الخرافي الذي ما قبله عرس..
وتأتي
سفن من جزر الهند، لتهديك عطورا وشموسا.
عندها..
يخطفني
الوجد إلى سبع سماوات..
لها
سبعة أبواب..
لها
سبعة حراس..
بها
سبع مقاصير.
بها
سبع وصيفات..
يقدمن
شرابا في كؤوس قمرية..
ويقدمن
لمن مات على العشق،
مفاتيح
الحياة السرمدية..
وإذا
بالشام تأتيني .. نهورا.. ومياها..
وعيونا
عسلية..
وإذا
بي بين أمي، ورفاقي،
وفروضي
المدرسية..
فأنادي،
ودموعي فوق خدي:
مدد!
يا
وحيدا، يا أحد
أعطني
القدرة كي أصبح في علم الهوى..
واحدا
من أولياء " الصالحية "..
عندما
يرتفع البحر بعينيك كسيف أخضر في الظلمات
تعتريني
رغبة للموت مذبوحا على سطح المراكب
وتناديني
مسافات..
تناديني
بحيرات..
تناديني
كواكب..
عندما
يشطرني البحر إلى نصفين..
حتى
تصبح اللحظة في الحب، جميع اللحظات..
ويجيء
الماء كالمجنون من كل الجهات..
هادما
كل جسوري..
ماحيا
كل تفاصيل حياتي..
يتولاني
حنين للرحيل
حيث
خلف البحر بحر..
ووراء
الجزر مد .. ووراء المد جزر..
ووراء
الرمل جنات لكل المؤمنين
ومنارات..
ونجم
غير معروف..
وعشق
غير مألوف ..
وشعر
غير مكتوب..
ونهد
.. لم تمزقه سيوف الفاتحين.
عندما
أدخل في مملكة الإيقاع، والنعناع، والماء،
فلا
تسعجليني..
فلقد
تأخذني الحال، فأهتز كدرويش على قرع الطبول
مستجيرا
بضريح السيد الخضر . وأسماء الرسول ..
عندما
يحدث هذا..
فبحق
الله، يا سيدتي، لا توقظيني.
واتركيني..
نائما
بين البساتين التي أسكرها الشعر، وماء الياسمين
علني
أحلم في الليل بأني..
صرت
قنديلا على باب ولي من دمشق..
عندما
تبدأ في عينيك آلاف المرايا بالكلام
ينتهي
كل كلام..
وأراني
صامتا في حضرة العشق،
ومن
في حضرة العشق يجاوب؟
فإذا
شاهدتني منخطف اللون، غريب النظرات..
وإذا
شاهدتني أقرأ كالطفل صلاتي..
وعلى
رأسي فراشات. وأسراب حمام..
فأحبيني،
كما كنت، بعنف وجنون..
واعصري
قلبي، كالتفاحة الحمراء، حتى تقتليني..
وعلى
الدنيا السلام..
اعلى

سرقة
النار كانت هوايتي منذ بدأت بكتابة الشعر.
لم
أسرق نار السماء كبروميثيوس.. لأن السماء لم تكن تهمني. كانت نار الأرض هي مطلبي،
وإشعال الحرائق في وجدان الناس وفي ثيابهم هو هاجسي.
كنت
أؤمن أن الشعر هو إشعال عود ثقاب في أشجار الغابة اليابسة..
الغابة
تصير أجمل عندما تشتعل. عندما يتحوّل كل غصن من أغصانها إلى شمعدان.
ومن
هنا يكتسب قول دورنمات:
"
إن الشعر اغتصاب العالم بالكلمات "
أهميةً
خاصة.
فبدون
اغتصاب لا يوجد شعر..
والاغتصاب
هنا يعني تمزيق الغشاء الذي تنسجه المفردات والأفكار والعواطف حول نفسها مع تقادم
الزمن.
انه
يعني إخراج الشعر من مملكة العادة والإدمان إلى مملكة الدهشة..
وعظمة
الشاعر تقاس بقدرته على إحداث الدهشة. والدهشة لا تكون بالاستسلام للأنموذج الشعري
العام، الذي يكتسب مع الوقت صفة القانون السرمدي.. لكن تكون بالتمرد عليه، ورفضه،
وتخطّيه.
الشعر
ليس انتظار ما هو منتَظَر. وإنما هو انتظار ما لا يُنْتَظَر..
انه
موعد مع المجيء الذي لا يجيء، والآتي الذي لا يأتي.
الشعر
الحقيقي لا يسير على الأرصفة المخصصة للمارة.. ولا يتقيد بالإشارات الضوئية، وإنما
يتقدم في المجهول، والحدْس، والمغامرة.
إنه
– في تصوّري – عملية انقلابية يخطط لها وينفّذها إنسان غاضب، ويريد من ورائها
تغيير صورة الكون.
ولا
قيمة لشعر، لا يحدث ارتجاجا في قشرة الكرة الأرضية، ولا يحدث تغييرا في خريطة
الدنيا، وخريطة الإنسان.
إنني
لا أفهم الشعر إلا من جهة كونه حركة، حركة مستمرة في سكون اللغة، وفي سكون الكتب،
وفي سكون العلاقات التاريخية بين الأشياء.
اعلى

أحبائي
:
إذا
جئنا لنحضر حفلة للزار ..
منها
يضجر الضجر
إذا
كانت طبول الشعر، يا سادة
تفرقنا
.. وتجمعنا
وتعطينا
حبوب النوم في فمنا
وتسطلنا
.. وتكسرنا.
كما
الأوراق في تشرين تنكسر
فإني
سوف أعتذر ..
أحبائي
:
إذا
كنا سنرقص دون سيقان .. كعادتنا
ونخطب
دون أسنان .. كعادتنا ..
ونؤمن
دون إيمان .. كعادتنا ..
ونشنق
كل من جاؤوا إلى القاعة
على
حبل طويل من بلاغتنا
سأجمع
كل أوراقي..
وأعتذر..
إذا
كنا سنبقي أيها السادة
ليوم
الدين .. مختلفين حول كتابة الهمزة .
وحول
قصيدة نسبت إلى عمرو بن كلثوم ..
إذا
كنا سنقرأ مرة أخرى
قصائدنا
التي كنا قرأناها ..
ونمضغ
مرة أخرى
حروف
النصب والجر .. التي كنا مضغناها
إذا
كنا سنكذب مرة أخرى
ونخدع
مرة أخرى الجماهير التي كنا خدعناها
ونرعد
مرة أخرى، ولا مطر ..
سأجمع
كل أوراقي ..
وأعتذر..
إذا
كان تلاقينا
لكي
نتبادل الأنخاب، أو نسكر ..
ونستلقي
على تخت من الريحان والعنبر
إذا
كنا نظن الشعر راقصة .. مع الأفراح تستأجر
وفي
الميلاد، والتأبين تستأجر
ونتلوه
كما نتلو كلام الزير أو عنتر
إذا
كانت هموم الشعر يا سادة
هي
الترفيه عن معشوقة القيصر
ورشوة
كل من في القصر من حرس .. ومن عسكر ..
إذا
كنا سنسرق خطبة الحجاج : والحجاج .. والمنبر ..
ونذبح
بعضنا بعضا لنعرف من بنا أشعر ..
فأكبر
شاعر فينا هو الخنجر..
أبا
تمام .. أين تكون .. أين حديثك العطر؟
وأين
يد مغامرة تسافر في مجاهيل، وتبتكر ..
أبا
تمام ..
أرملة
قصائدنا .. وأرملة كتابتنا ..
وأرملة
هي الألفاظ والصور..
فلا
ماء يسيل على دفاترنا..
ولا
ريح تهب على مراكبنا
ولا
شمس ولا قمر
أبا
تمام، دار الشعر دورته
وثار
اللفظ .. والقاموس..
ثار
البدو والحضر ..
ومل
البحر زرقته ..
ومل
جذوعه الشجر
ونحن
هنا ..
كأهل
الكهف .. لا علم ولا خبر
فلا
ثوارنا ثاروا ..
ولا
شعراؤنا شعروا ..
أبا
تمام : لا تقرأ قصائدنا ..
فكل
قصورنا ورق ..
وكل
دموعنا حجر ..
أبا
تمام : إن الشعر في أعماقه سفر
وإبحار
إلى الآتي .. وكشف ليس ينتظر
ولكنا
.. جعلنا منه شيئا يشبه الزفة
وإيقاعا
نحاسيا، يدق كأنه القدر ..
أمير
الحرف .. سامحنا
فقد
خنا جميعا مهنة الحرف
وأرهقناه
بالتشطير، والتربيع، والتخميس، والوصف
أبا
تمام .. إن النار تأكلنا
ما
زلنا نجادل بعضنا بعضا ..
عن
المصروف .. والممنوع من صرف ..
وجيش
الغاصب المحتل ممنوع من الصرف!!
وما
زلنا نطقطق عظيم أرجلنا
ونقعد
في بيوت الله ننتظر ..
بأن
يأتي الإمام على .. أو يأتي لنا عمر
ولن
يأتوا .. ولن يأتوا
فلا
أحدا بسيف سواه ينتصر ..
أبا
تمام : إن الناس بالكلمات قد كفروا
وبالشعراء
قد كفروا..
فقل
لي أيها الشاعر
لماذا
الشعر - حين يشيخ -
لا
يستل سكينا .. وينتحر؟
اعلى
تزوجتك

كان
لدي بلاط نساء
فيه
جميلات الدنيا
فالعربـية
والروميـة
والتركيـة
والكرديـة
كان
بقصري لعب صنعت في باريس
وجيش
من قطط شاميـة
كنت
الرجل الأوحد في التـاريخ
فلا
أولاد ولا أحفاد ولا ذريـة
كنت
أمير العشق
وكنت
أسافر يوما في الأحداق الخضر
ويوما
في الأحداق العسلية
كان
هناك العطر الأسود والأمطار الأولى
والأزهار
الوحشيـة
كانت
هناك عيـون
تسبح
مثـل طيـور النورس في دورتي الدمويـة
كانت
هناك شفاه مفتـرسات
كالأصداف
البحرية
كان
هناك سمك حي تحت الإبط
وثمة
رائحة بحرية
كانت
هناك نهود تـقرع حولي
مثل
طبول أفريقية
إني
قديس الكلمات
وشيخ
الطرق الصوفـية
وأنا
اغسل بالموسيقى
وجه
المدن الحجرية
وأنا
الرائي والمستكشف
والمسكون
بنار الشعر الأبدية
كنت
كموسى
أزرع
فوق ميـاه البحر الأحمر وردا
كنت
مسيحا قبل مجيء النصرانيـة
كل
امرأة امسك يدها
تصبح
زنـبقة مائيـة
كان
هناك ألف امرأة في تاريخي
إلا
إني لم أتزوج بـيـن نساء العالم
إلا
الحريـة..
اعلى
غرن

في
مدخل الحمراء كان لقاؤنا
ما
أطـيب اللقـيا بلا ميعاد
عينان
سوداوان في جحريهما
تتوالـد
الأبعاد مـن أبعـاد
هل
أنت إسبانـية؟ ساءلـتها
قالت:
وفي غـرناطة ميلادي
غرناطة
؟ وصحت قرون سبعة
في
تينـك العينين.. بعد رقاد
وأمـية
راياتـها مرفوعـة
وجيـادها
موصـولة بجيـاد
ما
أغرب التاريخ كيف أعادني
لحفيـدة
سـمراء من أحفادي
وجه
دمشـقي رأيت خـلاله
أجفان
بلقيس وجيـد سعـاد
ورأيت
منـزلنا القديم وحجرة
كانـت
بها أمي تمد وسـادي
واليـاسمينة
رصعـت بنجومها
والبركـة
الذهبيـة الإنشـاد
ودمشق،
أين تكون ؟ قلت ترينها
في
شعـرك المنساب ..نهر سواد
في
وجهك العربي، في الثغر الذي
ما
زال مختـزناً شمـوس بلادي
في
طيب "جنات العريف" ومائها
في
الفل، في الريحـان، في الكباد
سارت
معي.. والشعر يلهث خلفها
كسنابـل
تركـت بغيـر حصاد
يتألـق
القـرط الطـويل بجيدها
مثـل
الشموع بليلـة الميـلاد..
ومـشيت
مثل الطفل خلف دليلتي
وورائي
التاريـخ كـوم رمـاد
الزخـرفات..
أكاد أسمع نبـضها
والزركشات
على السقوف تنادي
قالت:
هنا "الحمراء" زهو جدودنا
فاقـرأ
على جـدرانها أمجـادي
أمجادها؟
ومسحت جرحاً نـازفاً
ومسحت
جرحاً ثانيـاً بفـؤادي
يا
ليت وارثتي الجمـيلة أدركـت
أن
الـذين عـنتـهم أجـدادي
عانـقت
فيهـا عنـدما ودعتها
رجلاً
يسمـى "طـارق بن زياد"
اعلى
الحاكم

أتجوَّلُ في
الوطنِ العربيِّ
لأقرأَ شعري
للجمهورْ
فأنا مقتنعٌ
أنَّ الشعرَ
رغيفٌ يُخبزُ للجمهورْ
وأنا مقتنعٌ –
منذُ بدأتُ –
بأنَّ الأحرفَ
أسماكٌ
وبأنَّ الماءَ
هوَ الجمهورْ
أتجوَّلُ في
الوطنِ العربيِّ
وليسَ معي إلا
دفترْ
يُرسلني
المخفرُ للمخفرْ
يرميني العسكرُ
للعسكرْ
وأنا لا أحملُ
في جيبي إلا عصفورْ
لكنَّ الضابطَ
يوقفني
ويريدُ جوازاً
للعصفورْ
تحتاجُ الكلمةُ
في وطني
لجوازِ مرورْ
أبقى ملحوشاً
ساعاتٍ
منتظراً فرمانَ
المأمورْ
أتأمّلُ في
أكياسِ الرملِ
ودمعي في
عينيَّ بحورْ
وأمامي كانتْ
لافتةٌ
تتحدّثُ عن
(وطنٍ واحدْ)
تتحدّثُ عن
(شعبٍ واحدْ)
وأنا كالجُرذِ
هنا قاعدْ
أتقيأُ
أحزاني..
وأدوسُ جميعَ
شعاراتِ الطبشورْ
وأظلُّ على
بابِ بلادي
مرميّاً..
كالقدحِ
المكسورْ
اعلى
دارنا

لابدَّ من
العودة مرةً أخرى إلى الحديث عن دار (مئذنة الشحم) لأنها المفتاح إلى شعري، والمدخل
الصحيح إليه.
وبغير الحديث
عن هذه الدار تبقى الصورة غير مكتملة، ومنتزعة من إطارها.
هل تعرفون معنى
أن يسكن الإنسان في قارورة عطر؟ بيتنا كان تلك القارورة.
إنني لا أحاول
رشوتكم بتشبيه بليغ، ولكن ثقوا أنني بهذا التشبيه لا أظلم قارورة العطر .. وإنما
أظلم دارنا.
والذين سكنوا
دمشق، وتغلغلوا في حاراتها وزواريبها الضيقة، يعرفون كيف تفتح لهم الجنة ذراعيها من
حيث لا ينتظرون..
بوّابة صغيرة
من الخشب تنفتح. ويبدأ الإسراء على الأخضر، والأحمر، والليلكيّ، وتبدأ سمفونية
الضوء والظّل والرخام.
شجرة النارنج
تحتضن ثمارها، والدالية حامل، والياسمينة ولدت ألف قمر أبيض وعلقتهم على قضبان
النوافذ.. وأسراب السنونو لا تصطاف إلا عندنا..
أسود الرخام
حول البركة الوسطى تملأ فمها بالماء.. وتنفخه.. وتستمر اللعبة المائية ليلاً
ونهاراً.. لا النوافير تتعب.. ولا ماء دمشق ينتهي..
الورد البلديّ
سجَّاد أحمر ممدود تحت أقدامك.. واللَّيلكَة تمشط شعرها البنفسجي، والشِمشير،
والخبَّيزة، والشاب الظريف، والمنثور، والريحان، والأضاليا.. وألوف النباتات
الدمشقية التي أتذكَّر ألوانها ولا أتذكر أسمائها.. لا تزال تتسلق على أصابعي
كلَّما أرت أن أكتب..
القطط
الشامِّية النظيفة الممتلئة صحةً ونضارة تصعد إلى مملكة الشمس لتمارس غزلها
ورومانتيكيتها بحريّة مطلقة، وحين تعود بعد هجر الحبيب ومعها قطيع من صغارها ستجد
من يستقبلها ويُطعمها ويكفكف دموعها..
الأدراج
الرخاميّة تصعد.. وتصعد.. على كيفها..و الحمائم تهاجر وترجع على كيفها.. لا أحد
يسألها ماذا تفعل؟ والسمكُ الأحمر يسبح على كيفه.. ولا أحد يسأله إلى أين؟
وعشرون صحيفة
فلّ في صحن الدار هي كل ثروة أمي.
كلُّ زر فّلٍ
عندها يساوي صبيّاً من أولادها.. لذاك كلما غافلناها وسرقنا ولداً من
أولادها..بكتْ.. وشكتنا إلى الله..
ضمن نطاق هذا
الحزام الأخضر.. ولدتُ، وحبوتُ، ونطقتُ كلماتي الأولى.
كان إصطدامي
بالجمال قدراً يومياً. كنتُ إذا تعثّرتُ أتعثّر بجناح حمامة.. وإذا سقطتُ أسقط على
حضن وردة..
هذا البيت
الدمشقي الجميل استحوذ على كل مشاعري وأفقدني شهِّية الخروج إلى الزقاق.. كما يفعل
الصبيان في كل الحارات.. ومن هنا نشأ عندي هذا الحسُّ (البيتوتّي) الذي رافقني في
كلّ مراحل حياتي.
إنني أشعر حتى
اليوم بنوع من الإكتفاء الذاتي، يجعل التسكع على أرصفة الشوارع، واصطياد الذباب في
المقاهي المكتظة بالرجال، عملاً ترفضه طبيعتي.
وإذا كان نصف
أدباء العالم قد تخرج من أكاديمية المقاهي، فإنني لم أكن من متخرّجيها.
لقد كنت أؤمن
أن العمل الأدبي عمل من أعمال العبادة، له طقوسه ومراسمه وطهارته، وكان من الصعب
عليَّ أن أفهم كيف يمكن أن يخرج الأدب الجادّ من نرابيش النراجيل، وطقطقة أحجار
النرد..
طفولتي قضيتها
تحت (مظلّة الفيءْ والرطوبة) التي هي بيتنا العتيق في (مئذنة الشحم).
كان هذا البيت
هو نهاية حدود العالم عندي، كان الصديق، والواحة، والمشتى، والمصيف..
أستطيع الآن،
أن أغمض عيني وأعد مسامير أبوابه، وأستعيد آيات القرآن المحفورة على خشب قاعاته.
أستطيع الآن أن
أعدّ بلاطاته واحدةً.. واحدة.. وأسماك بركته واحدةً.. واحدة.. وسلالمه الرخاميّة
درجةً.. درجة..
أستطيع أن أغمض
عيني، وأستعيد، بعد ثلاثين سنة مجلسَ أبي في صحن الدار، وأمامه فنجان قهوته،
ومنقله، وعلبة تبغه، وجريدته.. وعلى صفحات الجريدة تسقط كلّ خمس دقائق زهرة ياسمين
بيضاء.. كأنها رسالة حبّ قادمة من السماء..
على السجادة
الفارسيّة الممدودة على بلاط الدار ذاكرتُ دروسي، وكتبتُ فروضي، وحفظتُ قصائد عمر
بن كلثوم، وزهير، والنابغة الذبياني، وطرفة بن العبد..
ذا البيت-المظلة
ترك بصماته واضحة على شعري. تماماً كما تركت غرناطة وقرطبة وإشبيليا بصماتها على
الشعر الأندلسي.
القصيدة
العربية عندما وصلت إلى إسبانيا كانت مغطّاةً بقشرة كثيفة من الغبار الصحراوي..
وحين دخلتْ منطقة الماء والبرودة في جبال (سييرا نيفادا) وشواطئ نهر الوادي
الكبير.. و تغلغلت في بساتين الزيتون وكروم العنب في سهول قرطبة، خلعت ملابسها
وألقت نفسها في الماء.. ومن هذا الإصطدام التاريخي بين الظمأ والريّ.. وُلِدَ الشعر
الأندلسيّ..
هذا هو تفسيري
الوحيد لهذا الإنقلاب الجذريّ في القصيدة العربية حين سافرتْ إلى إسبانيا في القرن
السابع.
إنها بكل بساطة
دخلتْ إلى قاعة مكيّفة الهواء..
والموشحات
الأندلسية ليست سوى (قصائد مكيفة الهواء)..
وكما حدث
للقصيدة العربية في إسبانيا حدث لي، امتلأت طفولتي رطوبة، وامتلأت دفاتري رطوبة،
وامتلأت أبجديتي رطوبة..
هذه اللغة
الشاميّة التي تتغلغل في مفاصل كلماتي، تعلَّمتها في البيت-المظّلة الذي حدثتكم
عنه..
ولقد سافرت
كثيراً بعد ذلك، وابتعدت عن دمشق موظفاً في السلك الديبلوماسي نحو عشرين عاماً
وتعلمت لغات كثيرة أخرى، إلاَّ أن أبجديتي الدمشقية ظلت متمسكة بأصابعي وحنجرتي،
وثيابي. وظللتُ ذلك الطفل الذي يحمل في حقيبته كلَّ ما في أحواض دمشق، من نعناعٍ،
وفلّ، وورد بلدي..
إلى كل فنادق
العالم التي دخلتُها.. حملتُ معي دمشق، ونمت معها على سريرٍ واحد.
اعلى

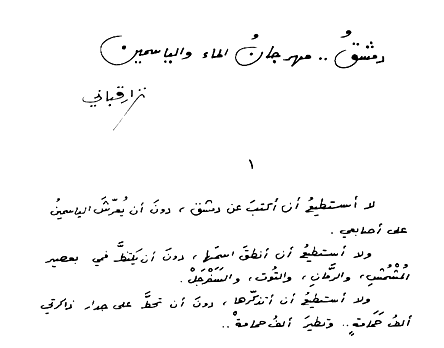
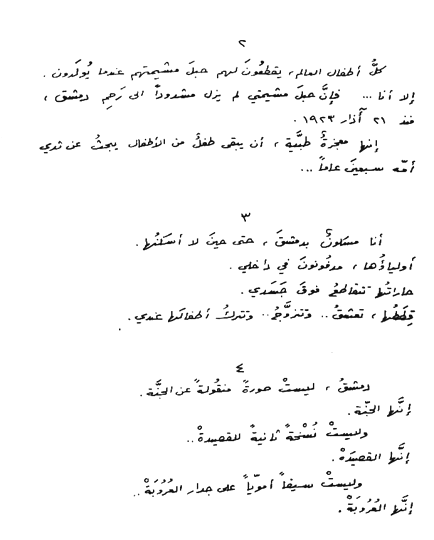
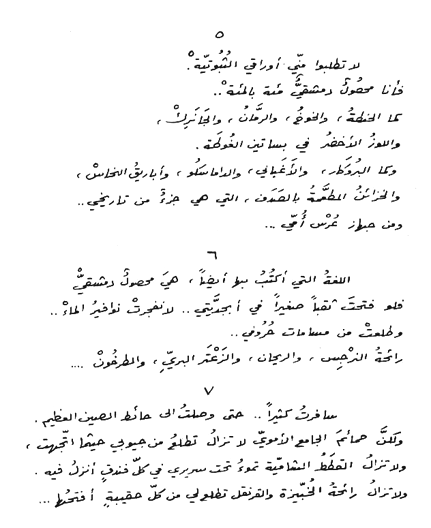
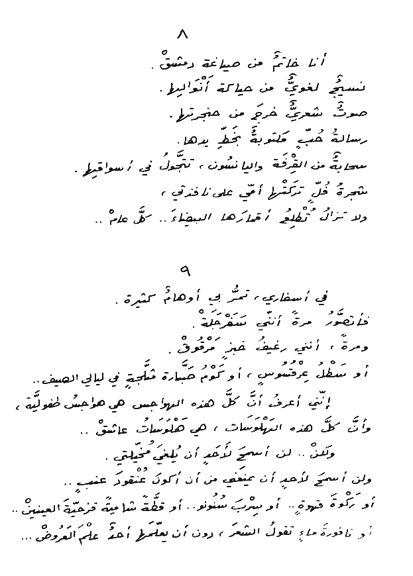
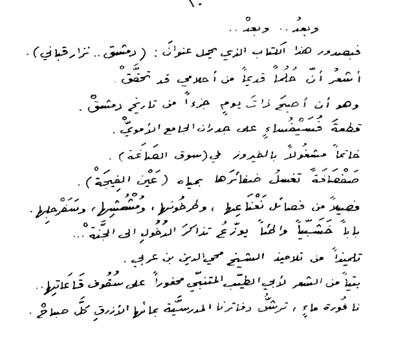
1
لا أستطيع أن أكتب عن دمشق , دون أن يعرش الياسمين على
أصابعي
.
ولا أستطيع أن أنطق اسمها , دون أن يكتظ فمي بعصير
المشمش والرمان , والتوت , والسفرجل
.
ولا أستطيع أن أتذكرها , دون أن تحط على جدار ذاكرتي
ألف حمامة .. وتطير ألف حمامة
..
2
كل أطفال العالم , يقطعون لهم حبل مشيمتهم عندما يولدون
إلا أنا
..
فإن حبل مشيمتي لم يزل مشدوداً إلى رحم دمشق منذ 21
آذار 1923
.
إنها معجزة طبية , أن يبقى طفل من الأطفال يبحث عن ثدي
أمه سبعين عاماً
…
3
أنا مسكون بدمشق , حتى حين لا أسكنها
.
أولياؤها , مدفونون في داخلي
.
حارتها تتقاطع فوق جسدي
.
قططها , تعشق .. وتتزوج .. وتترك أطفالها عندي
.
4
دمشق , ليست صورة منقولة من الجنة . إنها الجنة
.
وليست نسخة ثانية للقصيدة .. إنها القصيدة
.
وليست سيفاً أموياً على جدار العروبة إنها العروبة
5
لا تطلبوا مني أوراقي الثبوتية
.
فأنا محصول دمشقي مئة بالمئة..
كما الحنطة , والخوخ , والرمان , والجانرك
,
واللوز الأخضر في بساتين الغوطة
.
وكما البروكار , والأغباني , والداماسكو , وأباريق
النحاس
,
والخزائن المطعمة بالصدف , التي هي جزء من تاريخي ..
ومن جهاز عرس أمي
..
6
اللغة التي أكتب بها أيضا , هي محصول دمشقي
فلو فتحت ثقبا صغيراً في أبجديتي .. لانفجرت نوافير
الماء.. وطلعت من مسامات حروفي..
رائحة النرجس , والريحان , والزعتر البري , والطرخون
…
7
سافرت كثيراً.. حتى وصلت الى حائط الصين العظيم
.
ولكن حمائم الجامع الأموي لا تزال تطلع من جيوبي حيثما
اتجهت
,
ولا تزال القطط الشامية تموء تحت سريري في كل فندق أنزل
فيه
.
ولا تزال رائحة الخبيزة والقرنفل تطلع لي من كل حقيبة
أفتحها
..
8
أنا خاتم من صياغة دمشق
.
نسيج لغوي من حياكة أنوالها
صوت شعري خرج من حنجرتها
.
رسالة حب مكتوبة بخط يدها
.
سحابة من القرفة واليانسون , تتجول في أسواقها
.
شجرة فل تركتها أمي على نافذتي
,
ولا تزال تطلع أقمارها البيضاء … كل عام
..
9
في أسفاري تمرُ بي أوهامٌ كثيرةٌ
فأتصور مرةً أنني رغيفُ خبزٍ مرقوقْ
أو سطل عرقسوس أو كوم صبارةٍ مثلجةٍ في ليالي الصيف
……
أنني أعرف أن كل هذه الهواجس هي هواجس طفولية و أن كل
هذه الهلوسات …..هي هلوسات عاشق
و لكن لن أسمح لأحد أن يلغي مخيلتي
و لن أسمح لأحد أ،
يمنعني أن أكون عنقود عنبٍ أو ركوة قهوةٍ أو سرب سنونو أو قطةَ شاميةَ
قزحية العينين أو نافورة ماءٍ تقول الشعر
دون أن يعلمها أحد علم العروض
10
وبعد .. وبعد
..
فبصدور هذا الكتاب الذي يحمل عنوان : (دمشق ..
نزارقباني(
أشعر أن حلما قديما من أحلامي قد تحقق
وهو أن أصبح ذات يوم جزءا من تاريخ دمشق
قطعة فسيفساء على جدران الجامع الأموي
خاتماً مشغول بالفيروز في (سوق الصاغة)
صفصافة تغسل ضفائرها بمياه (عين الفيجة(
فصيلا من فصائل نعناعها وطرخونها , ومشمشها , وسفرجلها
.
بابا خشبياً واطئاً يوزع تذاكر الدخول الى الجنة
..
تلميذا من تلاميذ الشيخ محي الدين بن عربي
.
بيتاً من الشعر لأبي الطيب المتنبي محفوراً على سقوف
قاعاتها
..
نافورة ماء , ترش دفاترنا المدرسية بمائها الأزرق كل
صباح
.
اعلى

هذي دمشقُ..
وهذي الكأسُ والرّاحُ
إنّي أحبُّ..
وبعـضُ الحـبِّ ذبّاحُ
أنا
الدمشقيُّ.. لو شرحتمُ جسدي
لسـالَ منهُ
عناقيـدٌ.. وتفـّاحُ
و لو فتحـتُم
شراييني بمديتكـم
سمعتمُ في دمي
أصواتَ من راحوا
زراعةُ
القلبِ.. تشفي بعضَ من عشقوا
وما لقلـبي
–إذا أحببـتُ- جـرّاحُ
ألا
تزال بخير دار فاطمة
فالنهد مستنفر .. والكحل صداح
إن النبيذ هنا .. نار معطرة
فهل عيون نساء الشام, أقداح؟
مآذنُ الشّـامِ
تبكـي إذ تعانقـني
و للمـآذنِ..
كالأشجارِ.. أرواحُ
للياسمـينِ
حقـوقٌ في منازلنـا..
وقطّةُ البيتِ
تغفو حيثُ ترتـاحُ
طاحونةُ البنِّ
جزءٌ من طفولتنـا
فكيفَ أنسى؟
وعطرُ الهالِ فوّاحُ
هذا مكانُ "أبي
المعتزِّ".. منتظرٌ
ووجهُ "فائزةٍ"
حلوٌ ولمـاحُ
هنا جذوري..
هنا قلبي.. هنا لغـتي
فكيفَ أوضحُ؟
هل في العشقِ إيضاحُ؟
كم من دمشقيةٍ
باعـت أسـاورَها
حتّى أغازلها..
والشعـرُ مفتـاحُ
أتيتُ يا شجرَ
الصفصافِ معتذراً
فهل تسامحُ
هيفاءٌ ..ووضّـاحُ؟
خمسونَ عاماً..
وأجزائي مبعثرةٌ..
فوقَ المحيطِ..
وما في الأفقِ مصباحُ
تقاذفتني
بحـارٌ لا ضفـافَ لها..
وطاردتني
شيـاطينٌ وأشبـاحُ
أقاتلُ القبحَ
في شعري وفي أدبي
حتى يفتّـحَ
نوّارٌ.. وقـدّاحُ
ما للعروبـةِ
تبدو مثلَ أرملةٍ؟
أليسَ في كتبِ
التاريخِ أفراحُ؟
والشعرُ.. ماذا
سيبقى من أصالتهِ؟
إذا تولاهُ
نصَّـابٌ .. ومـدّاحُ؟
وكيفَ نكتبُ
والأقفالُ في فمنا؟
وكلُّ ثانيـةٍ
يأتيـك سـفّاحُ؟
حملت شعري على
ظهري فأتعبني
ماذا من الشعرِ
يبقى حينَ يرتاحُ؟
اعلى

المفاتيح إلى
شعري ليس مفاتيح سحرية، وهي ليس معلّقة في وسطي، أو مخبّأة تحت الوسادة.
فعوالمي
الداخلية براري مكشوفة، وحدائق عامة يسمح بالدخول إليها في كل ساعات النهار
والليل..
مفاتيح شعري هي
شعري نفسه. وقصائدي هي الصورة الفوتوغرافية الوحيدة التي تشبهني. وكتبي التي
نشرتُها هي جواز سفري الحقيقي.
مفاتيح شعري
ثلاثة: الطفولة، والثورة، والجنون. وبالطفولة أعني كل ما هو براءة ومكاشفة
وتلقائية. فالطفل والشاعر هما الساحران الوحيدان القادران على تحويل الكون إلى كرة
بنفسجية معدومة الوزن..
وبالثورة، أعني
إحداثَ خلخلة وتشقق وكسور في كل الموروثات الثقافية والنفسية والتاريخية التي أخذت
شكل العادة أو شكل القانون..
وبالجنون، أعني
تفكيك ساعة العقل القديمة، والاعتراض العنيف على كل الأحكام القرقاشية الصادرة
علينا قبل ولادتنا..
ان إخطر ما يقع
فيه الشاعر هو السقوط في صمغ الطمأنينة ومهادنة الأشياء التي تحيط به.
والشاعر لا
يعرف قشعريرة الصدام مع العالم يتحوّل إلى حيوان أليف، استئصلت منه غُدد الرفض
والمعارضة.
إنني منذ
طفولتي، كنت أجد متعة كبرى في التصادم مع التاريخ والخرافة، ولم أكن راغبا أبدا في
أن أكونَ درويشا في حلقة ذكر.. أو طفلا يغني في جوقة الكنيسة..
كنت أبحث
باستمرار عن وجهي وصوتي بين ألوف الوجوه والأصوات. إستعارة أصابع الآخرين وبصماتهم
لم أحترفها. كنت أريد أن أكتب بأصابعي أنا.. وأترك على الورق بصماتي المميّزة.
كنت أرفض أن
أكون نسخة بالكاربون لأي شاعر آخر.. ففي العالم متنبّي واحد.. وووردثوورث واحد..
وفاليري واحد.. وبابلو نيرودا واحد.. وكل نسخة أخرى تظهر في السوق لهؤلاء
المبدعين.. هي نسخة مزوّرة..
هذا كان أساس
تفكيري الشعري في عام 1940. كنت أعتقد أن ثمانين بالمئة من قصائدنا.. (براويز)
متشابهة. بالطول، والعرض، والزخرفة، وأن ثمانين بالمئة من شعرائنا.. كانوا نسخا
فوتوغرافية منسوخة نسخا رديئا عن الأصل.
بهذا كنت أفكر،
وأنا أصغي مع رفاق المدرسة الثانوية إلى قصائد كبار شعراء الشام آنئذ، وهم يلقون
قصائدهم على منبر الجامعة السورية، أو على أسوار مقبرة (الباب الصغير) و(الدحداح)
في المناسبات القومية والتأبينية.
كان عندي إحساس
بأن الزمن الشعري العربي، واقف في مكانه، وأن شعرنا في النصف الأول من القرن
العشرين، لا يختلف عن شعرنا في القرن الأول أو القرن الثاني، أو العاشر..
براويز
بلاغية.. تنقل من يد إلى يد.. ومن مالك إلى مالك.. أما الصورة داخل البرواز
فواحدة..
القصيدة
العربية ظلّت حتى العشرينات من هذا القرن تلبس العباءة الحجازية، وتشرب في الوقت
ذاته الويسكي في فنادق القاهرة وبيروت وبغداد ودمشق.
كان ثمة تناقض
مخيف بين زيّها وسلوكها. حتى أمير الشعراء شوقي، كان يتجول في بولفار الشانزيليزيه
في باريس.. وهو ينتعي خُفَّ المتنبي.. ويشرب النبيذ الاسباني في منفاه في غرناطة.
ويسكب على مصر البعيدة.. دموع البحتري..
انتقلنا إلى
المدينة وظلّت أوتاد البادية مدقوقة في أعماقنا. وعرفنا أزهار المارغريت،
والبانسيه، والغاردينيا.. وظلت رائحة الرند والعرار متكمشة في رئتينا.. وسكنّا أفخم
الفيلات والشاليهات.. وحملنا معنا إلى غرف نومنا.. نوقَنا وظباءنا..
كانت القصيدة
العربية تعاني انفصاما حادا في الشخصية، وكنت أحس، وأنا أقرأ شعراء عصر النهضة،
أنني أحضر حفلة تنكرية.. وأن كل شاعر يستعير القناع الذي يعجبه..
هذا يستعير سيف
أبي فراس.. وذاك يستعير حصان عنترة.. وثالث يستعير عباءة ابن الرومي..
وفي وسط هذه
الحفلة التنكرية، كنت أتساءل، وأنا شاب يافع، لماذا لا يكشف هؤلاء عن وجوههم
الطبيعية، ويتكلمون بأصواتهم الطبيعية؟ ولماذا يستعيرون لغة الآخرين، وعصر الآخرين؟
في هذا
الاحتفال الكرنفالي الذي لم يكن يُعرف فيه أنفُ فلان من أذن فلان.. ورأس هذا من كتف
ذاك.. قررت بحماس الشاب أن أغيّر بروتوكول الحفلة، وأخرق نظامها..
وبكل بساطة،
دخلت القاعة المكتظة بوجهي الطبيعي وملابسي العادية.. وفي يدي أول مجموعة شعرية لي
(قالت لي السمراء).
تعالى الصراخ
من كل مكان. طالب المشرفون على الحفلة بطردي. قال واحد منهم: متسلّل.. قال آخر: دخل
بغير بطاقة.. قال ثالث: وَلَدٌ غير شرعي.. لا يشبه أحدا من شجرة العائلة.
الواقع أنني لم
أكن أشبه أحدا من شجرة العائلة.. ولا أريد أن أشبهه..
أنا أكره أن
أكون توأما سياميا مع أي شاعر. التوائم السيامية في الأدب محكوم عليها سلفا
بالموت..
رفضوني لأني لم
أكن أشبه الشنفرى.. ولأن كلامي كان عصريا.. وملابسي عصرية..
ولم يصافحوني
حين مددت لهم يدي، لأن شَعْري كان أشقر.. ولأن عينيَّ كانتا زرقاوين..
لم يكن من
السهل إحداث شَغَب في حفلات الشعر التنكرية في دمشق الأربعينات.. لأن برامجها
معدَّة منذ ألف سنة على الأقل، ولأن المدعوين إليها هم أنفسهم منذ ألف سنة.. شرابهم
هو هو.. وطعامهم هو هو.. وطريقة رقصهم – بالسيف والترس – هي.. هي..
كان الداعونَ
والمدعوون يشكلون شركة محدودة لنظم الشعر. كانوا يرفضون أي عضو جديد في مجلس
الإدارة..
تحت إرهاب هذه
(الرأسمالية الشعريَّة).. كان علينا أن نبدأ العصيانَ والمقاومة..
كان الشعر
العربي قلعةً من الحجر تشبه قلاع القرون الوسطى.. وكان اختراق القلعة عملا جنونيا،
بل كان عملا أقرب إلى التجديف والكفر..
كان الإرهاب
متعدد الأطراف.. إرهابا لغويا، وإرهابا تاريخيا، وإرهابا بلاغيا، وإرهابا نحويا،
وإرهابا أخلاقيا ودينيا..
كل تفكير
بإنزال الهمزة عن كرسيّها، وكتابتها على السطر، كان يوصل إلى حبل المشنقة..
كل محاولة
لتحريك حجر واحد في (شطرنج) الخليل بن أحمد الفراهيدي.. كانت خروجا على قواعد
اللعبة..
كل اقتراب من
مملكة الحب، أو مملكة الجنس، كان اعتداءً شائناً تفصل فيه محاكم الجنايات..
اعلى

من سلالات
العصافير أنا
لا سلالات
الشجر
وشراييني
امتداد
لشرايـين القمر
إنني اخزن
كالأسماك في عيني
ألوان الصواري
ومواقيـت السفر
أنا لا أشبه
إلا صورتي
فلماذا شبهوني
بعمر
اعلى

لا تزال صورته واضحة التقاطيع، ولا يزال صوته القوي يهدر في
مسمعي، بعد مرور أربعين عاما على لقائي الدراماتيكي معه..
بطل القصة مواطن مغربي لا أتذكر اسمه، جاء عام 1954 إلى دار القنصلية السورية في
لندن في شارع
Kensington Palace Gardens
حيث كنت أدير الشؤون القنصلية. وطلب من السكرتيرة مقابلتي.
سألتُ السكرتيرة، إذا كان الأمر يتعلق بأي شأن من الشؤون القنصلية، أو بتأشيرة دخول
متأخرة.
أجابتني السكرتيرة، أن الرجل قد حصل على تأشيرته، وأنك وقّعت على التأشيرة، وانتهى
الموضوع.
ولكنه عندما رأى اسمك وتوقيعك على جواز سفره، سألني إذا كان القنصل الذي وقّع على
التأشيرة، هو نزار قباني الشاعر.. أم أنه شخص آخر؟؟..
وعندما أجبته أن القنصل والشاعر هما شخص واحد.. ظهرت الدهشة على وجهه، والتمعت
عيناه.. وطلب مقابلتك..
قلت للسكرتيرة حسنا .. قولي له أن يتفضل ..
وانفتح الباب، ودخل منه رجل أسمر الملامح، نحيل القامة، يحمل معه كتبا وجرائد،
وتوحي هيئته الخارجية بأنه أحد الطلبة المغاربة الذين يدرسون في إنكلترا.
نهضت لاستقبال الزائر، مبتسما، وطلبت منه أن يجلس ويشاركني القهوة، ولكنه امتنع عن
الجلوس، وبقي مزروعا في منتصف الغرفة، وفي عينيه شهوة واضحة للقتال والتحدي.
ظللتُ صامتا ومبتسما، حتى خرج الرجل عن صمته، وقال بلهجة يغلب عليها التوتر
والانكسار الداخلي:
" يا سيدي الشاعر: ولا
أقول يا سعادة القنصل، لأن كل الألقاب الأخرى المضافة إلى اسمك كشاعر، لا تهمني.
قل لي بالله عليك يا سيدي،
ما الذي تفعله وراء هذا المكتب؟ هل مهمتك أن تنظر في جوازات السفر، وتدقق في أسماء
طالبي التأشيرات، وتلصق الطوابع عليها.. وتمهرها بتوقيعك الشريف؟؟
لا يا سيدي، هذا عمل يمكن
أن يقوم به أي موظف من العصر العثماني، أو أي كاتب عَرْضحَالات..
أما أنت، فشاعرنا، وصوت
ضميرنا، والناطق الرسمي باسم أحلامنا، وأفراحنا، وأحزاننا، وهمومنا العاطفية
والقومية.
أتوسل إليك، يا سيدي، باسم
الأجيال العربية التي قرأتك، وأحبتك، وتعلمت على يديك أبجدية الحب والثورة..
أتوسل إليك باسم جميع
الأنبياء والرسل، وجميع الشعراء الذين استشهدوا من أجل كلمة جميلة، أن تترك هذا
المكان فورا.. وتبقى عصفورا يوقظ الشعوب من غيبوبتها، ويغني للحرية من المحيط إلى
الخليج..".
وخرج الرجل من مكتبي دون كلمة وداع.. وغادر دار القنصلية كالبرق تاركا وراءه كلماته
الغاضبة، تشتعل كالحرائق الصغيرة في رأسي، وفي ثيابي، وفي أوراق مكتبي..
والحقيقة أن الرجل ذهب .. ولم يذهب..
لأن كلماته ظلت تطاردني اثني عشر عاما، أي من عام 1954 حتى عام 1966، حتى ظهر لي
مرة ثانية وهو يلوح لي بمنديله، وأنا على ظهر السفينة في ميناء برشلونة، منتظرا
رحيل الباخرة إلى بيروت.
كان واقفا على رصيف المرفأ، والدمع يملأ عينيه، وعلامات الانتصار واضحة على وجهه..
وعندما بدأت الباخرة تبتعد عن الرصيف، وصلتني أصداء كلماته وهو يقول: شكرا لك يا
أيها الشاعر.. شكرا لأنك اخترتَ الشعر!!.
في عام 1996 أي بعد مرور أربعين عاما على هذه القصة المثيرة، أجلس في منـزلي في حي
نايتس بريدج في لندن، وليس عندي من الالتزامات سوى التزامين أساسيين: التزامي نحو
الشعر، والتزامي نحو الحرية.
فهل كان الرجل المغربي يدري أن كلماته الرسولية قد غيّرت مسار حياتي، وأن الشرارة
التي أشعلها في عقلي، أضاءت طريقي، وأوصلتني إلى مرفأ الشعر؟؟
وإنني لأتساءل اليوم، هل كان هذا الرجل مجرد سائح يطلب تأشيرة دخول من قنصلية
عربية، أم أنه كان رسولا هبط من كوكب آخر لينير بصيرتي، ويفتح عيني، ويدلني على
الصراط المستقيم؟.ٍٍ
إنني لا أشك في أن السماء لعبت دورها في رسم مصيري.. وانهاء حالة الازدواجية التي
كنت أعيشها بين الدبلوماسية.. وبين الشعر.. بين أقنعتي وبين وجهي الحقيقي.
ومن المؤسف أن لعبة الدبلوماسية استغرقتني عشرين سنة، حتى جاء الرجل المغربي فألفى
عصاه.. التي ابتلعت كل ملابسي الرسمية، وقمصاني المنشأة، وأحذيتي اللماعة، ورباطات
عنقي السوداء.. في لحظة واحدة.
ههذا الرجل أدين له بحريتي.. وبإعتاق رقبتي من السيف الحكومي الذي يصبح مع الزمن
جزءا من الرقبة..
أدين له بإنهاء حالة الفصام التي كنت أعيشها بين خطابين.. ولغتين.. وسلوكين..
وقناعين.. وعالمين متناقضين.
أدين له لأنه أخرجني من جحيم الاستقبالات، والكوكتيلات، والصالونات التي تختنق
برائحة السيجار الكوبي، والثرثرة، والاستعراضية، إلى فضاءات مفتوحة على المستحيل.
وأخيرا أدين له لأنه حررني من كل السلطات الأبوية، والسياسية، والقبلية،
والعشائرية، والجاهلية..
وأرجعني إلى رَحِم القصيدة.
على ظهر الباخرة التي نقلتني في نيسان (أبريل) عام 1966، من برشلونة إلى بيروت،
قررت الاستقالة من عملي الدبلوماسي.
وبغير تردد، قمت بفصل (التوأم السيامي) الذي كان ملتصقا بجسدي عن بعضه.. فتركت
الطفل الدبلوماسي على ظهر الباخرة في عناية أحد البحّارة الاسبان، واحتضنت طفل
الشعر بذراعي.. ونزلنا معا في مرفأ بيروت..
بعد أن قمت بعملية الفصل، استرحت جسديا ونفسيا، وبدأت أمشي في شوارع بيروت، بخطوات
رياضي يستعد لدخول الأولمبياد..
زواج الشاعر من القصيدة زواج نهائي..
انه زواج كاثوليكي لا مكان فيه للطلاق، أو لتعدد الزوجات..
ولا يوجد في الشعر شيء اسمه زواج عرفي.. أو زواج متعة.. أو زواج مصلحة.
ولقد اتضح لي أن جميع الشعراء الذين تورطوا (بزيجات) سرية، أو جانبية.. طمعا
بالمال، أو بالجاه، أو بزيادة الدخل، خسروا السعادة الزوجية.. والسعادة الشعرية..
معا..
إن الشعراء – السفراء الذي يتوهمون أنهم إذا قدّموا أوراق اعتمادهم إلى الملكة
اليزابيث، أو إلى الرئيس نهرو، أو إلى الرئيس شارل دوغول، أو إلى السلطان عبد
الحميد، أو إلى الخديوي اسماعيل، سوف يدخلون الجنة، هم واهمون. لأن الجنة الحقيقية
هي جنة الإبداع، ولأن مجد الشعر أهم بكثير من مجد حرس الشرف، والعربات المذهبة،
والجياد المطهّمة.. التي تحملهم إلى قصور الملوك والرؤساء.
القصيدة الجيدة التي يكتبها الشاعر.. هي ورقة اعتماده إلى الإنسانية كلها.. أما
الأوراق الأخرى إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة.. فهي كتابات على الريح سوف
تمحوها الريح!!..
اعلى

شام.. يا شام..
يا أميرةَ حبي
كيف ينسى
غرامَه المجنونُ؟
أتراها تحبني
ميسونُ ؟
أم توهمتُ..
والنساءُ ظنونُ
كم رسولٍ
أرسلتُهُ لأبيها
ذبحته تحت
النقاب العيونُ
يا ابنة
العمِّ.. والهوى أمويٌ
كيف أٌخفي
الهوى، وكيف أُبينُ
كم قُتلنا في
عشقنا.. وبُعثنا
بعدَ موتٍ..
وما علينا يمينُ
ما وقوفي على
الديار.. وقلبي
كجبيني قد
طرزته الغضونُ
لا ظباء الحمى
رددن سلامي
والخلاخيلُ ما
لهُن رنينُ
هل مرايا دمشق
تعرف وجهي
من جديدٍ.. أم
غيرتني السنينُ ؟
يا زماناً في
الصالحيةِ سَمحاً
أين مني الغوى،
وأين الفتونُ ؟
يا سريري.. ويا
شراشف أمي
يا عصافيرُ..
يا شذا.. يا غُصُونُ
يا زواريبَ
حارتي.. خبئيني
بين جفنيك،
فالزمان ضنينُ
واعذريني، إذا
بدوت حزيناً
إن وجه المحبِّ
وجهٌ حزينُ
ها هي الشام
بعد فرقة دهرٍ
أنهرٌ سبعةٌ..
وحورٌ عِينُ
النوافيرُ في
البيوتِ كلامٌ
والعناقيدُ
سكرٌ مطحونُ
والسماءُ
الزرقاءُ دفترُ شعرٍ
والحروفُ التي
عليهِ.. سنونو
هل دمشقٌ -كما
يقولونَ- كانت
حين في الليل،
فكَّرَ الياسمينُ ؟
آهٍ يا شامُ..
كيف أشرحُ ما بي
وأنا فيكِ
دائماً مسكونُ
سامحيني.. إن
لم أكاشفك بالعشقِ
فأحلى ما في
الهوى التضمينُ
نحن أسرى
معاً.. وفي قفص الحبِّ
يُعاني
السجَّانُ والمسجونُ
يا دمشقُ..
التي تقمصّت فيها
هل أنا
السروُ.. أم أنا الشربين ؟
أم أنا الفُلُ
في أباريق أمي..
أم أنا
العشبُ.. والسحابُ الهتونُ
أم أنا
القطَّةُ الأثيرةُ في الدار
تُلبي.. إذا
دعاها الحنينُ
يادمشقُ التي
تفشّى شَذاها
تحت جلدي..
كأنه الزيزفونُ
سامحيني إذا
اضطربتُ.. فإني
لا مقفَىً
حُبي.. ولا موزونُ
وازرعيني تحت
الضفائر مِشطاً
لأُريكِ
الغرامَ كيفَ يكونُ..
قادمٌ من مدائن
الريح وحدي
فاحتَضني،
كالطفل، يا قاسيونُ
احتضني.. ولا
تُناقشْ جنوني
ذروةُ العقل،
يا حبيبي، الجنونُ
احتضني..
خمسينَ ألفاً وألفا
فمع الضَمِّ..
لا يجوز السكونُ
أهيَ مجنونةٌ
بشوقي إليها..
هذه الشامُ، أم
أنا المجنونُ
حاملٌ حُبها
ثلاثينَ قرناً
فوق ظهري، وما
هناك مُعينُ
جاءَ تشرينُ..
يا حبيبةَ عمري
أحسنُ الوقت
للهوى تشرينُ
ولنا موعدٌ على
(جبلِ الشيخ)
كم الثلجُ
دافيءٌ.. وحنونُ
لم أُعانقكِ من
زمانٍ طويلٍ
لم أحدثك..
والحديثُ شجونُ
لم أُغازِلكِ..
والتغزلُ بعضي
للهوى دينُه..
وللسيف دينُ..
سنواتٌ سبعٌ من
الحزن مرَّت
مات فيها
الصفصافُ والزيتونُ
سنواتٌ فيها
استقلتُ من الحُب
وجفت على شفاهي
اللُحونُ
سنواتٌ سبعٌ..
بها اغتالنا اليأسُ
وعلم الكلام
واليانسونُ
فانقسمنا
قبائلا وشعوباً
واستبيحَ
الحمى، وضاع العرينُ
كيف أهواك حين
حولَ سريري
يتمشى اليهودُ
والطاعون
كيف أهواك..
والحمى مستباحٌ
هـل من السهل
أن يحبَّ السجينُ ؟
لا تقولي :
نسيتَ. لم أنسَ شيئاً
كيف تنسى
أهدابَهنَ الجُفُون ؟
غير أن الهوى
يصيرُ ذليلا
كلما ذُلَّ
للرجال جبينُ
شام.. يا شام..
يا أميرةَ حبي
كيف ينسى
غرامَه المجنونُ؟
أوقدي النارَ..
فالحديث طويلٌ
وطويلٌ لمن
نُحب الحنبنُ
شمس غرناطةٍ
أطلت علينا
بعد يأس،
وزغردت (ميسلون)
جاءَ تشرينُ..
إن وجهَكِ أحلى
بكثيرٍ. ما
سرُهُ تشرينُ ؟
كيف صارت سنابل
القمح أعلى..
كيف صارت عيناك
بيتَ السنونو
إن أرض الجولان
تشبهُ عينيكِ
فماءٌ يجري..
ولوزٌ.. وتينُ
كلُ جرحٍ فيها
حديقةُ ورد
وربيعٌ..
ولؤلؤٌ مكنونُ
يا دمشقُ البسي
دموعي سِواراً
وتمني فكل صعبٍ
يهونُ
وضعي طرحةَ
العروسِ لأجلي
إن مهرَ
المناضلاتِ ثمين
رضيَ اللهُ
والرسولُ عن الشامِ
فنصرٌ آتٍ
وفتحٌ مبين..
مزّقي يا دمشقُ
خارطةَ الذلّ
وقولي للدهر
كنْ فيكونُ
استردت أيامَها
بكِ بدرٌ
واستعادت
شبابَها حِطِّينُ
بكِ عزَّتْ
قريشُ بعدَ هوانٍ
وتلاقتْ قبائلٌ
وبطونُ..
إنَّ عَمْرَو
بنَ العاصِ يزحف للشرق
وللغربِ يزحفُ
المأمونُ
كتبَ اللهُ أن
تكوني دمشقاً
بكِ يبدأ
وينتهي التكوينُ
لا خيارٌ أن
يصبح البحرُ بحراً
أو يختارُ
صوتَه الحسّونُ
ذاك عمر
السيوفِ.. لاسيفَ إلاّ
دائنٌ ياحبيبتي
أو مدينُ..
هُزمَ الرومُ
بعدَ سبعٍ عجافٍ
وتعافى
وجدانُنا المطعونُ
وقتلنا
العنقاءَ في (جبل الشيخِ)
وألقى أضراسَهُ
التِنينُ
صدق السيفُ
وعدهُ يابلادي
فالسياساتُ
كلُها أفيونُ
صدق السيفُ
حاكماً وحكيماً
وحده السيفُ،
يا دمشقُ، اليقينُ
إسحبي الذل يا
قنيطرةَ المجد
وكحّلْ جفنيكَ
يا حرَمونُ
سبقت ظلِّها
خيولُ هشامٍ
وأفاقتْ من
نومها السكينُ
علمينا فِقهَ
العروبةِ يا شِام
فأنتِ البيانُ
والتبيينُ
علمينا
الأفعالَ.. قد ذبحتنا
أحرفُ الجرِّ..
والكلام العجينُ
علمينا قراءةََ
البرقِ والرعدِ
فنصفُ اللغاتِ
وحلٌ وطينُ
علمينا
التفكيرَ.. لا نصرَ يرجى
حينما الشعبُ
كلُه سردينُ
إنَّ أقصى ما
يُغضبُ اللهَ
فكرٌ دجّنوهُ..
وكاتبٌ عنينُ
وطني.. يا
قصيدةَ النارِ والوردِ..
تغنت بما صنعت
القرونُ
إن نهر التاريخ
ينبعُ في الشام
أيُلغي
التاريخُ طِرحٌ هجينٌ ؟
نحن عكا..
ونحنُ كرمِلُ حيفا..
وجبال
الجليلِ.. واللطرونُ
كل ليمونةٍ
ستنجب طفلا
ومحالٌ أن
ينتهي الليمونُ
إركبي الشمسَ،
يا دمشقُ، حصانا
ولكِ اللهُ..
حافظٌ وأمينُ
اعلى

حكاية الشعر
كحكاية الوردة التي ترتجف على الرابية، مخدة من العبير.. وقميصا من الدم.
إنك تحبها هذه
الكتلة الملتهبة من الحرير التي تغمر إصبعك.. وأنفك.. وخيالك.. وقلبك.. دون أن يدور
في خلدك أن تمزقها، وتقطع قميصها الأحمر، لتقف على سر هذا الجهاز الجميل الذي يحدث
لك هذه الهزة العجيبة، وهذه الحالة السمحة، القريرة، التي تغرق فيها…
وحين تفكر في
هذا الإثم يوما، فتشق هذه اللفائف المعطرة، وتذبح هذه الأوراق الصبية، لتمد أنفك في
هذا الوعاء الأنيق.. الذي يفرز لك العطر، ويعصر لك قلبه لونا.. حين تدور في رأسك
هذه الفكرة المجرمة، لا يبقى على راحتك غير جثة الجمال. وجنازة العطر.
وفي الفن، كما
في الطبيعة، وفي القصيدة كما في الوردة وكما في اللوحة البارعة.. يجب أن لا نعمد
إلى تقطيع القصيدة، هذا الشريط الباهر الندي من المعاني والأصباغ، والصور، والدندنة
المنغومة.
حرام أن نمزق
القصيدة لنحصي (كمية) المعاني التي تنضم عليها، ونحصر عدد تفاعيلها، وخفي زحافاتها
ونقف على "لون" بحرها..
فالإحصاء،
والحساب، والتحليل، والفكر المنطقي يجب أن تتوارى كلها ساعة التلقين المبدع، أن كل
هذه الملكات العقلانية الحاسبة، فاشلة في ميدان الروح.
فالقمر.. هذا
الينبوع المفضض الذي يذر على الكون جدائل الياسمين.. يحدث لك ولي ولكل إنسان حالة
حببية ملائمة. إنك تفتح قلبك له، وتغمس أهدابك في سائله الزنبقي دون أن تعرف عن هذا
(الجميل) من أنه قمر..
ولو اتفق أن
أوضح لك فلكي سر القمر، وأجواءه، وجباله الجرداء، وقممه المرعبة، وأدار لك الحديث
عن معادنه ودرجة حرارته ورطوبته، إذن لأشفقت على قلبك، وأسدلت ستارتك…
إذن، فلنقرأ
القصيدة كما ننظر إلى القمر.. بطفولة وعفوية، واستغراق.
فالتذوق الفني
كما قال الفيلسوف الإيطالي كروتشه في كتابه: (المجمل في فلسفة الفن) هو عبارة عن
(حدس غنائي). والحدس
Intuition
هو
الصورة الأولى للمعرفة وسابق لكل معرفة. وهو من شأن المخيلة، وهو بتعبير آخر
الإدراك الخالي من أي عنصر منطقي.
إذن فكل أثر
فني يجب أن يستقبل عن طريق (الإدراك الحدسي) لا (المنطقي) أو (الذهني) لأن هذا
النوع الأخير من الإدراك ميدانه العلم والظواهر المادية.
يقول كروتشه:
"على الناقد أن
يقف أمام مبدعات الفن موقف المتعبد لا موقف القاضي، ولا موقف الناصح؛ وما الناقد
إلا فنان آخر يحس ما أحسه الفنان الأول فيعيش حدسه مرة ثانية ولا يختلف عنه إلا في
أنه يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة غير واعية…."
ومتى تم انتقال
هذه السيالة الدافئة من الأصباغ، والنغم، والغريزة، والانفعال.. إليك، تنتهي مهمة
الشعر، فهو ليس أكثر من (كهربة جميلة) تصدم عصبك وتنقلك إلى واحات مضيئة مزروعة على
أجفان السحاب.
مهمة القصيدة
كمهمة الفراشة.. هذه تضع على فم الزهر دفعة واحدة جميع ما جنته من عطر ورحيق،
متنقلة بين الجبل والحقل والسياج.. وتلك- أي القصيدة- تفرغ القارئ شحنة من الطاقة
الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس، وتنتظم الحياة كلها. يجب أن لا نطلب من الشعر
أكثر من هذا. ويتجنى من هذا على الشعر الذين يريدون منه أن يغل غلة، وينتج ريعا.
فهو زينة وتحفة باذخة فحسب.. كآنية الورد التي تستريح على منضدتي، لست أرجو منها
أكثر من صحبة الأناقة.. وصداقة العطر.. لذلك نشأت على كره عنيد للشعر الذي يراد من
نظمه إقامة ملجأ.. أو بناء تكية.. أو حصر قواعد اللغة العربية، أو تأريخ ميلاد صبي
أو تعداد مآثر الميت على رخامة قبره.
قرأت في طفولتي
تعاريف كثيرة للشعر، وأهزل هذه التعاريف :
"الشعر هو
الكلام الموزون المقفى"
أليس من المخجل
أن يلقن المعلمون العرب تلاميذهم في هذا العصر، عصر فلق الذرة، ومراودة القمر، مثل
هذه الأكذوبة البلهاء؟
ماذا نقول
للشاعر، هذا الرجل الذي يحمل بين رئتيه قلب الله، ويضطرب على أصابعه الجحيم، وكيف
نعتذر لهذا الإنسان الإله الذي تداعب أشواقه النجوم، وتفزع تنهداته الليل، ويتكئ
على مخدته الصباح، كيف نعتذر له بعد أن نقول له عن قصيدته التي حبكها من وهج
شرايينه ونسجها من ريش أهدابه "إنها كلام".
وكلمة (كلام)
هذه.. تقف في قلبي يابسة كالشوكة لأن ما يدور بين الباعة على رصيف الشارع هو كلام..
والضجة التي ترتفع في سوق البورصة هي مجموعة من الكلام الموزون.. أيضا.
فهل الشعر عند
سادتنا العروضيين هو هذا النوع من الكلام دون أن يكون ثمة فرق بين كلام (ممتاز)
وكلام (رخيص)؟.
ويقال في تعريف
ثان للشعر إنه تصوير للطبيعة. وأنا أقول إن الفن هو صنع الطبيعة مرة ثانية، على
صورة أكمل، ونسق أروع.
الطبيعة وحدها،
فقيرة، عاجزة مقيدة بأبدية القوانين المفروضة عليها: هذه الزهرة تنبت في شهر كذا..
وهذا النبع يتفجر إذا انعقدت السحب مطرا، وهذا النوع من العصافير يرحل عن البيادر
في أوائل الشتاء.
أما في الفن
فإنك تشم رائحة الأعشاب لمجرد تصفحك ديوان ابن زيدون.وإنك لتستطيع أن تستمع إلى
وشوشة الينابيع وأنت أمام الموقدة تقرأ ما كتب البحتري وابن المعتز.
أستطيع في أي
موسم أن أغلق نافذتي وأمد يدي إلى مكتبتي لأنعم بالورد وبالماء وبالعطر وبزقزقة
العصافير المغنية وهي تتفجر من دواوين المتنبي، وبودلير، وبول فيرلين، وأبي نواس،
وبشار، فتحيل مخدعي إلى مزرعة يصلي على ترابها الضوء والعبير.
الوردة الحمراء
على الرابية تموت.،ولكن الوردة المزروعة في قصيدة فلان لا تزال توزع عطرها على
الناس وتقطر دمعها على أصابعهم.
إذن فما هو
الشعر؟
كل ما قيل في
هذا الموضوع لا يتعدى دراسة نتائج الغضب والانفعال والسرور على جسد الإنسان، وكما
يدرس علماء الفيزياء آثار التيار الكهربائي من ضوء وحرارة وحركة.
وجميع ما قرأته
من نظريات المعنى، والفكرة، والصورة واللفظ والخيال ونسبة كل منها في البيت إنما
تدرس آثار التجربة الشعرية في العالم الخارجي، أي بعد انتقالها من جبين الشاعر إلى
الورق.
لا أجرؤ على
تحديد جوهر الشعر.. لأنه يهزأ بالحدود. ثم ماذا يضير الشعر إذا لم نجد له تعريفا؟
ألسنا نتقبل
أكثر الأشياء التي تحيط بنا دون مناقشة. فالروائح، والألوان، والأصوات التي يسبح
كياننا فيها، تبعث اللذة فينا دون أن نعرف شيئا عن مادتها وتركيبها. وهل تخسر
الوردة شيئا بمن فتنتها إذا جهلنا تاريخ حياتها؟
لنتواضع إذن
على القول: إن الشعر هو كهربة جميلة، لا تعمر طويلا تكون النفس خلالها بجميع
عناصرها من عاطفة، وخيال، وذاكرة، وغريزة مسربلة بالموسيقا.
ومتى اكتسب
الهنيهة الشعرية ريش النغم، كان الشعر فهو بتعبير موجز (النفس الملحنة).
لا تعرف هذه
الهنيهة الشاعرة موسما ولا موعدا مضروبا، فكأنها فوق المواسم والمواعيد. وأنا لا
أعرف مهنة يجهل صاحبها ماهيتها أكثر من هذه المهنة التي تغزل النار..
والذي أقرره أن
الشعر يصنع نفسه بنفسه، وينسج ثوبه بيديه وراء ستائر النفس، حتى إذا تمت له أسباب
الوجود، واكتسى رداء النغم، ارتجف أحرفا تلهث على الورق..
ولقد اقتنعت أن
جهدي لا يقدم ولا يؤخر في ميعاد ولادة القصيدة، فأنا على العكس أعيق الولادة إذا
حاولت أن أفعل شيئا.
كم مرة ..
ومرة.. اتخذت لنفسي وضع من يريد أن ينظم، وألقيت بنفسي في أحضان مقعد وثير، وأمسكت
بالقلم، وأحرقت أكثر من دخينة.. فلم يفتح الله عليّ بحرف واحد، حتى إذا كنت أعبر
الطريق بين ألوف العابرين أو كنت في حلقة صاخبة من الأصدقاء، دغدغني ألف خاطر
أشقر.. وحملتني ألف أرجوحة معطرة إلى حيث تفنى المسافات..
والشعر يحيط
بالوجود كله، وينطلق في كل الاتجاهات: فترسم ريشته المليح والقبيح، وتتناول المترف
والمبتذل، والرفيع والوضيع. ويخطئ الذين يظنون أنه خط صاعد دائما. لأن الدعوة إلى
الفضيلة ليست مهمة الفن بل مهمة الأديان وعلم الأخلاق. وأنا أؤمن بجمال القبح، ولذة
الألم، وطهارة الإثم. فهي كلها أشياء صحيحة في نظر الفنان.
تصوير مخدع
مومس وارد في منطق الفن ومعقول، وهو من أسخى مواضيع الفن وأغزرها ألوانا. أما
المومس من حيث كونها إناء من الأثم، وخطأ من أخطاء المجتمع، فهذا موضوع آخر تعالجه
المذاهب الاجتماعية وعلم الأخلاق.
يقول كروتشه في
نقد المذهب الأخلاقي في الفن:
"إن العمل الفني لا يمكن أن يكون فعلا نفعيا يتجه إلى
بلوغ لذة أو استبعاد ألم، لأن الفن من حيث هو فن لا شأن له بالمنفعة"
وقد لوحظ من
قديم الأزمان أن الفن ليس ناشئا عن الإرادة. ولئن كانت الإرادة قوام الإنسان الخير
فليست قوام الإنسان الفنان.
فقد تعبر
الصورة عن فعل يحمد أو يذم من الناحية الخلقية؛ ولكن الصورة من حيث هي صورة لا يمكن
أن تحمد أو تذم من الناحية الأخلاقية، لأنه ليس ثمة حكم أخلاقي يمكن أن يصدر عن
إنسان عاقل ويكون موضوعه صورة.
"إن الفنان
فنان لا أكثر، أي إنسان يحب ويعبر. ليس الفنان من حيث هو فنان عالما، ولا فيلسوفا
ولا أخلاقيا. وقد تنصب عليه صفة التخلق من حيث هو إنسان، أما من حيث هو فنان خلاق
فلا نستطيع أن نطلب إليه شيئا واحدا هو التكافؤ التام بين ما ينتج وما يشعر به".
لو صح لنا أن
نقبل ما زعمته المدرسة الأخلاقية في الفن لمات الفن مختنقا بأبخرة المعابد، ولوجب
أن نحطم كل التماثيل العارية التي نحتها ميشيل آنجلو، والصورة البارعة التي رسمها
رفائيل.. لأنها إثم يجب أن لا تقع فيه العين.
لو ذهبنا مع
أشياع هذه المدرسة إلى حيث يريدون لوجب أن نخرج من حظيرة الشعر الجيد قصيدة النابغة
التي قالها في زوجة النعمان وقد انزلق مئزرها عن نهدين .. شابين .. مرتعشين:
سقط النصيف ولم
ترد إسقاطه
فتناولته
واتقتنا باليد …
ولكان علينا أن
نلعن النابغة ونعتبره ضالا لا يستحق أن نقر سيرته وأشعاره.
وبعد.. وبعد..
ففي يد القارئ حروف دافئة تتحرك على بياض الورق، وتتسلق أصابعه لتعانق قلبه.
هذه الأحرف لم
أكتبها لفئة خاصة من الناس روضوا خيالهم على تذوق الشعر وهيأتهم ثقافاتهم لهذا.
لا.. إنني أكتب
لأي (إنسان) مثلي يشترك معي في الإنسانية وتوجد بين خلايا عقله، خلية، تهتز للعاطفة
الصافية، وللوحات المزروعة وراء مدى خلايا الظن..
أريد أن يكون
الفن ملكا لكل الناس كالهواء، وكالماء، وكغناء العصافير يجب أن لا يحرم منها أحد.
إذن يجب أن
نعمم الفن، وأن نجعله بعيد الشمول، ومتى كان لنا ذلك استطعنا أن نجلب بالجماهير
المتهالكة على الشوك، والطين، والمادة الفارغة إلى عالم أسواره النجوم، وأرضه
مفروشة بالبريق.
متى جذبنا
الجماهير إلى قمتنا، نبذوا أنانيتهم، وتخلوا عن شهوة الدم، وخلعوا أثواب رذائلهم،
وهكذا يغمر السلام الأرض، وينبعث الريحان مكان الشوك.
إنني أحلم
(بالمدينة الشاعرة) لتكون إلى جانب مدينة الفارابي (الفاضلة). وحينئذ فقط، يكتشف
الإنسان نفسه ويعرف الله..
وفي سبيل هذه
الفلسفة، فلسفة الغناء العفوي، حاولت فيما كتبت أن أرد قلبي إلى طفولته، وأتخير
ألفاظا مبسطة، مهموسة الرنين، وأختار من أوزان الشعر ألطفها على الأذن.
وإن القارئ
ليحس أن الكلام الذي أهمس له به يعرفه كأنه هو الذي يغني.
فإذا أحس
القارئ بأن قلبي صار مكان قلبه وانتفض بين أضلعه هو، وأنه يعرفه قبل أن يعرفني،
وأنني صرت فما له وحنجرة، فلقد أدركت غايتي، وحققت حلمي الأبيض، وهو أن أجعل الشعر
يقوم في كل منزل إلى جانب الخبز والماء
أعلى

مِنْ لثْغَةِ
الشحرورِ
من
بَحَّة
نايٍ
محزنة
مِنْ رجفة
المُوّال
مِنْ
تنهُّداتِ
المئذنة
مِنْ
غيمه
تحبكُها
عند الغروب
المدخنة
و جُرْح
قرميدِ القرى
المنثورةِ
المزينهْ
مِنْ
وشْوَشَات نجمةٍ
في شرقنا
مستوطنهْ
مِنْ قصّةٍ
تدورُ
بين وردةٍ ..
وسَوْسَنَهْ
و من
شذا
فلاّحة
تعبق منها
الميْجَنَهْ
و من لهاث
حاطبٍ
عاد بفأسٍ
مُوهَنَهْ
جبالنا..
مروحةٌ
للشرقِ،
غرقى،ليّنهْ
توزّع الخيرَ
على الدنيا
ذُرانا
المحسِنَهْ
يطيبُ للعصفور،
أنْ
يبني لدينا
مسكنهْ
و بغزلُ
الصفصافُ
في حضن السواقي
موطنَهْ
حدودُنا..
الياسمينِ
و الندَى ..
محصّنَهْ
و وردُنا
مُفَتِّحٌ
كالفِكَرِ
الملونهْ
..
و عندنا
الصخورُ
تَهوَى
و الدوالي
مدمنة
و إن
غضبنا
نزرعِ
الشمسَ
سيوفاً
مؤمِنَهْ
..
بلادُنا كانتْ
وكانت
بعد هذا
الأزمِنَهْ
..
اعلى

حين وصلت إلى
مرفأ بيروت في شهر نيسان (أبريل) 1966 على ظهر سفينة إسبانية قادمة من برشلونة،
أحسست أن السفينة رست في مرفأ الأحلام، وأن قصائدي نامت في بيت أمها وأبيها..
من إسبانيا
حملت معني أثاثا منـزليا كاملا، وأخبرت رجال الجمارك اللبنانيين أنني شاعر سوري
اختار أن يقيم في لبنان، وليس لديه في لبنان بيت، أو عنوان، أو بطاقة إقامة دائمة..
فقال لي
المسؤول الجمركي:
- أهلا بك في
لبنان. ولكن إدخال أثاث منـزلي كامل إلى لبنان، معفيا من الرسوم، هو من صلاحيات
المدير العام للجمارك .. فهل ترغب أن تراه؟
قلت:
بالطبع..
يسعدني أن أتعرّف عليه..
ودخلت على
المدير العام للجمارك، فنهض من وراء مكتبه، وأخذني بالأحضان، وطلب لي قهوة.. وسألني
عن شعري أولا.. وعن صحتي وأحوالي ثانيا.. ثم طرحت عليه مشكلتي بكل طفولة..
فقال، والابتسامة الكبيرة تضيء في عينيه.. وعلى شفتيه..:
" عن أي مشكلة
تتحدث؟ هل يحتاج نزار قباني إلى تصريح لدخول بيته؟ إن لبنان هو بيتك.. كما هو بيت
الشعر.. فلا تشغل بالك أبدا حول هذا الموضوع، فنحن في لبنان عشّاق لشعرك، ولبنان لا
يتقاضى رسوما جمركية على الشعر!!..
فأهلا وسهلا بك
في وطن الشعر.. ووطن الحب.. "
واستدعى
معاونه، وطلب منه أن يملأ البيان الخاص بالإعفاء.. ووقّعه على الفور..
وخرجت من مكتب
مدير الجمارك، وأن أتعثّر بدموعي، وبعد ساعات كان أثاثي المنـزلي، مكوّما على رصيف
مرفأ بيروت، وأنا لا أعرف إلى أين أذهب.. وأين أضع الحاوية الضخمة التي تضم أثاث
بيتي في مدريد، وفي أي منطقة من مناطق بيروت سيكون بيتي؟؟
المهم، أنني
أودعت أثاثي في قبو يملكه أحد الأصدقاء اللبنانيين، وذهبت إلى أحد الفنادق، ونمت
ليلتي الأولى على صدر بيروت الحنون الدافئ.. وكلمات المدير العام للجمارك تطنّ في
أذني:
-
نحن في لبنان لا نأخذ رسوما جمركية على الشعر !!.
- أهلا وسهلا
بك في وطن الشعر.. وفي وطن الحب.. الحب.. ا ل..ح..ب..
هذا الحب الأول
الذي داهمني وأنا واقف على مرفأ بيروت في ربيع عام 1966 خضّني.. ودوّخني.. وغيّر
تركيب دورتي الدموية.
تأمّلت السفن
الراسية في المرفأ، ورأيت اللنشات الصغيرة تنقل الركاب، وطيور النورس تحمل في
أجنحتها رائحة السفر.. ورائحة الأعشاب البحرية.. ورائحة الحرية..
شعرت بطمأنينة
عجيبة على مصيري، وأحسست أن الرياحَ حملتني إلى قدري الجميل، وإلى جزيرة الشعر،
والقمر، وأزهار الغاردينيا..
وتأكدتُ من
رضاء الله والوالدين عليّ..
فماذا كان يحدث
لو أنني نزلت في مرفأ مرسيليا.. أو سنغافورة.. أو هونكونغ؟؟..
بالتأكيد، سوف
أكون شاعرا صينيا!!.
ولكنني هبطت
كما هبط الأمير الصغير في رائعة سانت اكزوبري على (صخرة الروشة).. فوجدت الطيور
البحرية بانتظاري، وصيّادي السمك بانتظاري.. ومقهى (دبيبو).. ومقهى (الدولتشه
فيتا).. ومطعم نصر.. والعربات التي كانت تبيع على الكورنيش الجميل، قهوة الأكسبرسو،
ومناقيش الزعتر.. والأولاد الذين كانوا يبيعون أطواق الغاردينيا للعشّاق.. وجدتهم
جميعا بانتظاري.
وهكذا وجد
(الأميرُ الصغير) جزيرة أحلامه، وبدأ منذ صباح اليوم التالي، يحرث أرضَ بيروت
ويزرعها وردا، وعنبا، وتُفّاحا.. وقصائد..
حتى صارت مزرعة
الشعر التي أنشأها ملجأً لآلاف العصافير..
في بيروت، رجعت
قطعة واحدة بعدما كنت قطعتين..
هذه الازدواجية
الرهيبة، استمرت مع الأسف إحدى وعشرين سنة (1945-1966) كنت خلالها ألبس قناعَيْن،
وأتكلم بصوتين، وأظهر في الحفلات الرسمية شاحبا، كتمثال من الشمع في متحف (مدام
توسُّو)..
انفصل التوأم
السيامي عن بعضه.. وذهب طفل الشعر جنوبا.. وذهب طفل الدبلوماسية شمالا..
وربما كان من
حسن حظي، أن جهازَ المناعة الشعرية عندي لم يفقد مناعته حتى آخر لحظة..
ولم تستطع
فايروسات الوظيفة أن تفترس كريّات الشعر الحمراء..
بيروت كرّستني
شاعرا.. وعمّدتني بماء بحرها الأزرق.. وأعطتني (دكتوراه) في الشعر لا تزال معلّقة
في غرفة مكتبي في لندن.
بيروت أعطت
أيضا شهادات الدكتوراه في الشعر لشعراء عرب طليعيين، كأدونيس، وبدر شاكر السيّاب،
ومحمود درويش، وأطلقتهم كالشُهُب في سماوات الوطن العربي.
كانت عادلة في
اختيارها.. وعادلة في قراراتها.. وعادلة في تقييم الشعر بصرف النظر عن هوية الشاعر،
وانتماءاته، واتجاهاته السياسية والأيديولوجية.
أي أن بيروت
كانت مع الشعر.. قبل أن تكون مع الشعراء.. وكانت متحرّرة عن العَصَبيّة، والقبلية،
والشوفينية، والطائفية..
فاللبناني، حين
يقرأ الشعر، ينسى طائفته!!.
على صخور
الجبال اللبنانية أقمت مجدي الشعري.
ومن أرز لبنان
وسنديانه وصنوبره، صنعت مراكب على طريقة الفينيقيين، أوصلتني إلى حدود الشمس، وتخوم
المستحيل..
لبنان أعطاني
خرائط الشعر، وقدّم لي زوّادة من المعرفة والثقافة والحضارة، لا أزال آكُلُ منها
حتى اليوم.
نحن جميعا
عصافير أكلت القمح من سهل البقاع، واللوز الأخضر من وديانه.. وتعلّمت أبجدية الحرية
على يديه..
تفرّغت في
بيروت للشعر وحده.. ولم أُشرك به أحدا.
كنت أتنفس
شعرا.. وأتكلم شعرا.. وأنام شعرا.. وأستيقظ شعرا.. وأشرب قهوتي ممزوجة بالشعر..
وحبّ الهال..
كنت أتمشى
صباحا على كورنيش البحر، فيملؤني الإحساس بأنني قصيدة تمشي على قدميها..
ولا أتذكر
مرحلةً في حياتي تماهيتُ بها مع الشعر، كهذه المرحلة اللبنانية، الزاهية الممتدة من
منتصف الأربعينات، حتى منتصف السبعينات..
كانت بيروت في
أحسن حالاتها شبابا، ونضارة، وحضارة..
وكنا في أحسن
أيامنا اشتعالا، وعطاءً، وإحساسا بالحرية..
ولقد أعطتني
بيروت خلال عشرين عاما كل المواد الأولية التي يحتاج اليها شاعر ليكتبَ اسمه على
جدران الوطن العربي، بالحروف الكبيرة.
فمن جنيف، ومن
مدريد، ومن لندن، كنت كلما شعرت ببرد المنفى وقشعريرته.. أحجز مكانا على أول طائرة
مسافرة إلى بيروت.. لأسترجع حرارة الشعر.. وحرارة القلب..
كنت أذهب إلى
بيروت، لأدوزنَ صوتي.. وأدوزنَ كلماتي.. وأطمئن على القصائد التي تركتها نائمة تحت
أشجار الجامعة الأميركية.. وفي أحضان النساء اللبنانيات اللواتي كن يتكحّلن بالشعر،
ويتزين كل يوم بقصيدة حب جديدة..
كنت أذهب إلى
بيروت، لأحافظ على لياقتي الشعرية، وأتأكد بأن الأمواج التي تتكسّر على شطآن عين
المريسة، والسان جورج، والسان ميشيل، وصيدا، وصور، وطبرجة، وجونية وطرابلس، لا تزال
تحفظ النوتة الموسيقية لـ (رسالة من تحت الماء).. و(قارئة الفنجان)..
كنت أذهب إلى
بيروت لأتبارك بصوت مقرئيها، ورنين أجراس كنائسها، وبياض أشرعتها، وشباك صيّاديها،
وطموح عصافيرها، وزحمة سياراتها.. وليبرالية مقاهيها، وتعدّد منابرها، وشجاعة
جرائدها.. وجنون صحافييها..
وأخيرا.. كنت
أذهب إلى بيروت لأتأكد من أنني لا أزال قادرا على الكتابة.. وقادرا على العشق..
وقادرا على السفر إلى أي مكان.. دون أن يكون معي تأشيرة دخول لأي مكان..
أهم ما في
تكوين بيروت أنها تجمع في جسدها الأنوثة والأمومة معا.. فهي أمّ عظيمة، وحبيبة
رائعة في الوقت ذاته.
وهذا نادر في
معجم البلدان. فباريس مثلاً يمكن أن تكون عشيقة مدهشة، ولكنها لا تستطيع أن تكون
أمّاً مدهشة..
أما نيويورك
فلا يمكنها أن تكون أمّاً.. ولا أن تكون عشيقة!!.
بيروت ليست
طارئة على خارطة الشعر.. أو مضافة اليه.. انها الشعر.
انها على خارطة
المنطقة العربية تشبه طاووسا رأسه فوق جبال صنين.. وذيله مبلّلٌ بمياه البحر الأبيض
المتوسط.
بيروت هي حالة
شعرية لا تتكرر بسهولة..
وقصيدة لا يمكن
إعادة كتابتها.
لذلك من
السذاجة أن يسألَ سائلٌ: متى تعود بيروت؟
وإذا كان
بالإمكان إعادة الحجر، والحديد، والألومنيوم، والجسور، والرافعات، والأوتوسترادات،
والفنادق.. فإن استعادة بيروت الشاعرة مهمة مستحيلة..
فالأشياء
الجميلة جدا.. لا عمر لها.. كما الشباب، والجمال، والأنوثة، والشروق والغروب،
والربيع، وقوس قزح..
فكما بابل،
وروما وأثينا، وفلورنسة، وغرناطة، وقرطبة، اشتعلت كشموس عظيمة في تاريخ الحضارات،
ثم انطفأ وهجُها..
فإن بيروت التي
كسرت الحرب الأهلية عظامها، وأحرقت غطاء عرسها، وشوّهت وجهها الجميل، وجسدها
المعجون بالبرونز والذهب والكاكاو..
بيروت المليحة،
الذكية، المثقفة، المبدعة، الحرة حتى الجنون.. هل من الممكن أن تخرج إلينا من تحت
الأمواج كحورية البحر؟..
يؤسفني أن زمن
الحوريات قد انتهى..
وجاء عصر
السيرلانكيات!!..
اعلى

لقـدْ كَتَبْنـا .. وأرسَـلْنـا المَرَاسـيلا
وقـدْ
بَـكَيْنـا .. وبَلَّلْنـا المَـنـاديلا
قُـل للّذيـنَ
بأرضِ الشّـامِ قد نزلـوا
قتيلُكُـم لمْ
يَـزَلْ بالعشـقِ مـقتـولا
يا شـامُ ، يا
شـامَةَ الدُّنيا ، ووَردَتَها
يا مَـنْ
بحُسـنِكِ أوجعـتِ الأزاميلا
ودَدْتُ لو
زَرَعُـوني فيـكِ مِئـذَنَـةً
أو علَّقـونـي
على الأبـوابِ قِنديـلا
يا بلْدَةَ
السَّـبْعَةِ الأنهـارِ .. يا بَلَـدي
ويا قميصاً
بزهـرِ الخـوخِ مشـغولا
ويـا حِصـاناً
تَخلَّـى عَـن أعِنَّتِـهِ
وراحَ يفـتـحُ
معلـوماً ومـجهـولا
هـواكَ يا
بَـرَدَى كالسَّـيْفِ يسكُنُني
ومـا مَلكْـتُ
لأمـرِ الحـبِّ تَبديـلا
ما للدمشقية
الكانت حبيبتنا
لاتذكر الآن
طعم القبلة الأولى
أيّـامَ في
دُمَّـرٍ كُنّا .. وكـانَ فَمـي
على ضفائرِها
.. حَفْـراً .. وتَنزيـلا
والنهـرُ
يُسـمِعُنا أحلـى قـصائـدِه
والسَّـرْوُ
يلبسُ بالسّـاقِ الخَـلاخيلا
يا مَنْ على
ورقِ الصّفصَفاتِ يكتِبُني
شعراً ...
وينقشُني في الأرضِ أيلولا
يا مَنْ يعيدُ
كراريسي .. ومَدرَسَـتي
والقمحَ ،
واللّوزَ ، والزُّرقَ المواويلا
يا شـامُ إنْ
كنتُ أُخفـي ما أُكابِـدُهُ
فأجمَـلُ
الحبِّ حـبٌّ ـ بعدَ ما قيلا
اعلى

الشعر عندي هو
انتظار ما لا يُنتظر..
هذا هو (برنامج
العمل) الذي وضعته أمامي، ونفّذته بدقة منذ بداياتي الشعرية الأولى.
أن نقول للناس
ما يعرفونه بصورة سابقة، يعني البقاء في إطار الشرعية. أما أن نباغتهم بما ينتظرونه
ولا ينتظرونه، فهو كسر زجاج الشرعية.. والخروج إلى برية الشعر..
وأنا، بطبيعة
تركيبـي، ضد الشرعية.
فالشرعية في
نظري، هي مجموعة القناعات الشعرية التي أخذت شكل مقدّسات لا يجوز الاعتراض عليها أو
مناقشتها..
والشرعية، تعني
التوقف نهائيا في محطة تاريخية معينة، بحيث لا يسمح للداخلين أن يدخلوا.. وللخارجين
أن يخرجوا..
وهي تعني فيما
تعنيه، أن يُفرض على جميع الشعراء العرب، على اختلاف بيئاتهم، وثقافاتهم، وعصورهم،
نوع من الإقامة الجبرية في فندق عتيق ليس فيه مصعد.. ولا ثلاجة.. ولا جهاز تكييف..
وهي تعني
أخيرا، أن تصبح البلاغة وأشكال التعبير وثنا.. أو حجرا.. أو سجادة لا تُقبل الصلاة
إلا عليها.. أو طبقا من الثريد لا يستطيع أحد رفضه أو استبداله بطبق آخر..
وأنا لم أكن
أرفض الثريد لأنه ثريد.. ولكنني أرفض أي طعام جاهز يحاول أن يصبح في حياتي عادة أو
قدرا.
إن عبقرية
الشاعر تتجسد في قدرته الدائمة على اختراع كلام جديد لمواضيع قديمة.. فالحب مثلا
مؤسسة عتيقة إلا أنها تحتمل دائما كلاما جديدا.
لا قيمة لشعر
يعيد اكتشاف الأشياء المكتشفة، ويستعمل حجارة العالم القديم كما هي. الطبيعة تتحمل
الإعادة والتكرار، أما الشعر فلا يتحملها. الأرض تستطيع احتمال شجرتيْ زيتون
متشابهتين.. وسنبلتيْ قمح متشابهتين.. ولكنها لا تتساهل أبدا مع شاعرين يقولان نفس
الكلام..
هذه الحقيقة
كانت دائما تجلس على أصابعي وأنا أكتب..
كنت أمارس على
نفسي رقابة تصل إلى حد الوجع وأتساءل: هل هذه الكلمات التي أرسمها على الورقة تضيف
شيئا إلى أهرامات الكلمات التي قالتها البشرية منذ أقدم العصور؟
وإذا كانت لا
تضيف شيئا.. فما جدواها، وما جدواي؟
كنت أريد أن
يكون لي منـزل شعري صغير أرتبه على ذوقي.. وأوزع أثاثه على ذوقي.. وأختار ورق
جدرانه على ذوقي..
لم أكن أومن
بسياسة الاستئجار في الشعر. فالسكنى في بيوت الآخرين لا تُريح ولا تدفئ..
ويمكنني أن
أقرر بموضوعية تامة، بعد ثلاثين سنة من الكتابة، أنه أصبح لي بيت شعري صغير.. يعرفه
الناس من قرميده الأحمر.. وبابه المفتوح دائما للشمس والعصافير..
إن الوقوف في
وجه الشرعية.. أتعبني..
كان بإمكاني أن
أحترف مثل غيري السترة، وأتجنّب السير على سطح من المسامير المشتعلة..
إنني أرفض
السترة إذا كان معناها أن أرفع قبعتي لكل الموروثات، والأفكار التي وجدتُها على
سرير ولادتي يوم ولدت..
السترة موقف من
لا موقف له، ونقطة جبانة ومترددة لا تتخذ قرارا ولا تُغضب أحدا..
إنها جسد
يتعاطى المخدرات..
السترة سهلة
جدا. يكفي أن لا تفعل شيئا لتكون مستورا.
يكفي أن لا
تفكر، ولا تكتب، ولا تنشر كتابا، ولا تمشي في مظاهرة، ولا تدخل في حزب سياسي، ولا
تظهر مع امرأة في محل عام.. لتكون مستورا.
كل فعل إنساني
يحمل مشكلة أو يؤدي إلى مشكلة. والموت وحده هو الذي لا مشكلة فيه، كما يقول زوربا
اليوناني..
اعلى

كلَّ نهارٍ،
أجلس عند صديقي
الإيطالي ( روبرتو)
كل نهار .
أحمل تخطيطات
الشعرِ،
وآكلها بدل
الإفطار ..
صار (روبرتو )
يعرف وجهي
صار يقـيس
مساحة حزني بالأمتـار ..
كل نهار،
أمشي فوق الورق
اليـابس،
كل نهار .
أتحدث في لغة
الأعشاب،
وأفهم إحساس
الأشجار
كل نهار،
أصنع أملاً من
ألوان الطيف،
وأصنع شعـبـا
من أزهار ..
كل نهار،
أنوي فيه ركوب
البحر ..
تـقول الشرطة :
لا إبحار
كل نهار،
أبني وطنا أسكن
فيه
فتجرفـه
الأمطار ..
كل نهار،
ألبسُ ذات
المعطف،
أقطع ذات
الشارع،
أُشغل ذات
المقعـدِ،
أطلب ذات
القهـوةِ،
أشري صحفا من
بلدان الشرق الأوسط
لا أتحمس كي
أفتحها
فالأخبار هي
الأخبار
في القرن الأول
..أو في القرن العاشر..
الأخبار هي
الأخبار ..
كل نهار،
أجلس عند صديقي
( روبرتو )
كل نهار .
أطلب قدحا من
كونـياك فرنسا
أبلعـهُ
سيـفـاً من نـار
أكتـب فوق
الـفـوطة شعرا
تبكي منه فتـاة
البـار ..
كل نهار،
تجلس فوق سريري
امرأة
تخطفها مني
الأقـدار
كل امرأة تحمل
طفلا مني
يضربها الإعصار
كل نهار،
أكتب للحرية
شعرا
يمنعه حتى
الأحرار ..
يا سيدتي :
إن النملة تملك
وطنا .
إن الدودة
تملـك وطنا .
إن الضفدع
يملـك وطنا .
إن الفأرة
تملـك وطنا .
إن الأرنب
يملـك وطنا .
والسحلية،
والصرصار .
وأنا ما ملّكني
أحد وطنا
ولذا، أسكن يا
سيدتي
وطنا بالإيجار
..
اعلى

هل في العيون
التونسية شاطئ
ترتاح فوق
رماله الأعصاب ؟
أنا يا صديقة
متعب بعروبتي
فهل العروبة
لعنة وعقاب ؟
أمشي على ورق
الخريطة خائفا
فعلى الخريطة
كلنا أغراب
أتكلم الفصحى
أمام عشيرتي
وأعيد .. لكن
ما هناك جواب
لولا العباءات
التي التفوا بها
ما كنت أحسب
أنهم أعراب
يتقاتلون على
بقايا تمرة
فخناجر مرفوعة
وحراب
قبلاتهم عربية
.. من ذا رأى
فيما رأى قبلا
لها أنياب
يا تونس
الخضراء كأسي علقم
أعلى الهزيمة
تشرب الأنخاب ؟
وخريطة الوطن
الكبير فضيحة
فحواجز ..
ومخافر .. وكلاب
والعالم العربي
.. إما نعجة
مذبوحة أو حاكم
قصاب
والعالم العربي
يرهن سيفه
فحكاية الشرف
الرفيع سراب
والعالم العربي
يخزن نفطه
في خصيتيه ..
وربك الوهاب
والناس قبل
النفط أو من بعده
مستنزفون ..
فسادة ودواب
يا تونس
الخضراء كيف خلاصنا ؟
لم يبق من كتب
السماء كتاب
ماتت خيول بني
أمية كلها
خجلا .. وظل
الصرف والأعراب
فكأنما كتب
التراث خرافة
كبرى .. فلا
عمر .. ولا خطاب
وبيارق ابن
العاص تمسح دمعها
وعزيز مصر
بالفصام مصاب
من ذا يصدق ان
مصر تهودت
فمقام سيدنا
الحسين يباب
ما هذه مصر ..
فان صلاتها
عبرية ..
وإمامها كذاب
ما هذه مصر ..
فان سماءها
صغرت .. وان
نساءها أسلاب
إن جاء كافور
.. فكم من حاكم
قهر الشعوب ..
وتاجه قبقاب
بحرية العينين
.. يا قرطاجة
شاخ الزمان ..
وأنت بعد شباب
هل لي بعرض
البحر نصف جزيرة ؟
أم أن حبي
التونسي سراب
أنا متعب ..
ودفاتري تعبت معي
هل للدفاتر يا
ترى أعصاب ؟
حزني بنفسجة
يبللها الندى
وضفاف جرحي
روضة معشاب
لا تعذليني إن
كشفت مواجعي
وجه الحقيقة ما
عليه نقاب
إن الجنون وراء
نصف قصائدي
أوليس في بعض
الجنون صواب ؟!
فتحملي غضبي
الجميل فربما
ثارت على أمر
السماء هضاب
فإذا صرخت بوجه
من أحببتهم
فلكي يعيش الحب
والأحباب
واذا قسوت على
العروبة مرة
فلقد تضيق
بكحلها الأهداب
فلربما تجد
العروبة نفسها
ويضيء في قلب
الظلام شهاب
ولقد تطير من
العقال حمامة
ومن العباءة
تطلع الأعشاب
قرطاجة
..قرطاجة .. قرطاجة
هل لي لصدرك
رجعة ومتاب ؟
لا تغضبي مني
.. اذا غلب الهوى
ان الهوى في
طبعه غلاب
فذنوب شعري
كلها مغفورة
والله - جل
جلاله - التواب
اعلى

وداعاً .. أيها الدفترْ
وداعاً .. أيها
الدفترْ
وداعاً يا صديق
العمر، يا مصباحيَ الأخضرْ
ويا صدراً
بكيتُ عليه، أعواماً، ولم يضجَرْ .
ويا رفْضي ..
ويا سُخطي ..
ويا رعْدي ..
ويا برقي ..
ويا ألماً
تحولَ في يدي خِنْجَرْ ..
تركتكَ في
أمانِ الله ،
يا جُرحي الذي
أزهرْ
فإن سرقوكَ من
دُرْجي
وفضُّوا
خَتْمَكَ الأحْمَرْ
فلن يجدوا سوى
امرأةٍ
مبعثرةٍ على
دفترْ ....
اعلى

لكن هل يكفي هذا القرار الرومانسي لأقف على أقدامي في مدينة
شاطرة جدا.. وتاجرة جدا.. ووفية جدا لإرثها الفينيقي؟
فكّرت أن أؤسس دار نشر لا تنشر سوى انتاجي الشعري، وسميُتها (منشورات نزار قباني)،
فاعترض كثيرون على التسمية، واعتبروها جزءا لا يتجزأ من غروري.. ونرجسيتي..
لم أسمع النصيحة كعادتي لأن أصحاب شركات فورد، وبيجو، ورينو، وفيراري للسيارات،
وماركات شانيل، وغيرلان، ونينا ريتشي للعطور، ومحلات الصمدي، والبحصلي، وجروبي
للحلويات، ومصانع الشوربجي للغزل والنسيج، تحمل أسماء أصحابها و(ما في حدا أحسن من
حدا..).
وبدأت مرحلة التنفيذ، واستأجرت مكتبا صغيرا من غرفتين في شارع المعرض في قلب بيروت
التجاري، حيث يتجمّع أهم الناشرين اللبنانيين.
في البداية رحّب الناشرون اللبنانيون بزمالتي، وتعاملوا معي بكل حب واحترام،
وزاروني في مكتبي الجديد، ودعوني إلى منازلهم، وصار بيني وبينهم خبز وملح..
ولكن مرحلة شهر العسل مع بعضهم لم تدم طويلا، فحين زادت شعبيتي، وازداد انتشار كتبي
وتوزيعها، وازداد شحمي ولحمي.. أكلوا لحمي.. وزوّروا كتبي..
والذين يسمعون عن عبقرية بيروت في نشر الكتاب العربي، وقدرتها الخارقة على تصنيع
الكتاب، وإطلاقه، والتعريف به، ربما لا يعرفون أن عالم النشر في بيروت، أشبه
بالمجاهل الإفريقية.. حيث الناشر يأكل الناشر.. والزميل يفترس زميله.. وأصحاب
دكاكين الثقافة.. يسرقون أعمال المثقفين وجاكيتاتهم، وقمصانهم، وسراويلهم أيضا..
وإذا استثنينا عشرة بالمئة من الناشرين اللبنانيين، ممن يتحلّون بالشرف والثقافة
والقيم العالية، فإن التسعين بالمئة الباقية منهم.. جزّارون محترفون يتعاطون مع
الكتاب كما يتعاطى جزّارٌ وثني مع قطيع من الأغنام.. دون أن يراعي في عملية الذبح
أحكام الشريعة الإسلامية.. أو أية شريعة أخرى..
هؤلاء الناشرون ليس لهم جذور ثقافية أو اجتماعية.. فقد بدأوا المهنة بائعي جرائد
على أرصفة بيروت.. ثم انتقلوا من أسفل القفّة إلى غطائها، فأصبح لهم مكاتب مكيّفة
الهواء.. وسكرتيرات.. وفاكسات.. وصاروا يدخّنون السيجار الكوبي كما يفعل اللوردات
الإنكليز..
وإذا كان مطلوبا من الناشر أن يكون لديه حدّ أدنى من الثقافة التي تسمح له بقراءة
وتقييم المخطوطات التي تصل إليه، فإن هؤلاء الناشرين أُميّون بالوراثة، ولا يعرفون
إذا كان الكتاب العربي يُقرأ من اليمين.. أم يُقرأ من اليسار؟؟
انهم مجموعة من الضباع، تأكل كل ما في طريقها من كُتُب، وورق، وكرتون، ومطابع،
وأدباء.. وشعراء.. وروائيين.. وحقوق تأليف!!.
إن شهية هؤلاء لا حدود لها.. وهم لا يوفرون الأموات ولا الأحياء.. بدءا من كتاب
الأغاني، والعقد الفريد، وصبح الأعشى، ونهج البلاغة.. حتى روايات نجيب محفوظ،
وأعمال طه حسين.. وتوفيق الحكيم.. والعقاد.
وهم يسطون على كل شيء.. ابتداء من المصاحف الكريمة.. حتى كتب الطبخ.. والجنس..
والجريمة..
إلى هذه الغابة المتوحشة دخلت عام 1966.
ولا تزال عضّات الأفاعي، والعقارب، وأسماك القرش، مرسومة على كل زاوية من زوايا
جسدي..
وحتى أكون منصفا، أود أن أقول إن سيف التزوير لم يطلني وحدي، بل طال أي مؤلف رائج،
وأي كتاب يبيع أكثر من ثلاثمئة نسخة.
وليس هناك ميثاق شرف بين الناشرين اللبنانيين والناشرين العرب يمنعهم من تزوير كتب
بعضهم.. فكل الأعمال الأدبية مستباحة، ومهدور دمها.. على امتداد الخارطة العربية..
فالكتاب المصري مأكول، والكتاب السوري مأكول، والكتاب العراقي مأكول، والكتاب
الفلسطيني مأكول. وكم حاولت جامعة الدول العربية، والهيئة العامة للكتاب في
القاهرة، أن توقف هذه المذبحة الدامية، ولكنها فشلت في نزع سلاح المتقاتلين.. كأنما
(داحس والغبراء) الثقافية.. قدَرٌ مكتوب على جبين العرب.
ولا أكون مبالغا إذا قلت أن سلطة المزوّرين كانت ولا تزال أقوى من كل السلطات
التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.. بل هي أقوى من سلطة (الأنتربول).. ومحكمة العدل
الدولية..
انهم كالمافيات في جزيرة صقلية الإيطالية، لهم جيشهم، ورئاسة أركانهم، وقواتهم
المسلحة.. وهم لا يتورّعون عن قتل رجال الشرطة، والقضاة، والمحامين الذين
يلاحقونهم.
وربما كانت المرة الوحيدة التي انتصر فيها كاتب عربي على مزوّري كتبه، هي المرة
التي تدخلت فيها قوات الردع السورية عام 1976، بناء على شكوى رسمية تقدّمتُ بها إلى
قيادة قوات الردع لترفع عني سيف ميليشيات التزوير، باعتبار أن (الأمن الثقافي) لا
ينفصل عن الأمن العسكري، الذي أخذت قوات الردع السورية على عاتقها تثبيته في بدايات
الحرب الأهلية.
لقد اعتبر الإخوة السوريون آنئذ أن العدوان على كُتُبي، هو عدوان على تراث ثقافي
عربي – سوري، فتحرّكوا فورا لإنقاذ أعمالي الشعرية من مخالب المزوّرين، وحاصروا
أوكارهم، ومطابعهم، ومستودعاتهم، وصادروا أهراماتٍ من الكتب المزوّرة، وأرغموا
الفاعلين على دفع جميع حقوق التأليف المسروقة.
هذه حادثة من حوادث الردع الثقافي، لا بد لي من ذكرها في هذه السيرة الذاتية،
كنموذج لسلطة تدافع عن ثقافتها ومثقّفيها..
ويا ليت الدول العربية الأخرى، التي تسلّلت اليها جرثومة التزوير حتى وصلت إلى
كراسي المسؤولين عن شؤون الثقافة والإعلام، تقتدي بهذا الموقف السوري الحضاري
الكبير وتتحرك لحماية آلاف المبدعين العرب، من أسنان أسماك القرش التي لم تجد حتى
الآن من يردعُها، ويقتلعُ أسنانها المتوحشة..
ان السلطة الحقيقية هي التي تدافع عن مثقّفيها..
لا تلك التي تبيعهم في المزاد العلني..
هي السلطة التي تضع الكتاب في قائمة الكتب المقدّسة.. لا في صناديق النفايات!!..
بدأت في بيروت (على الحصيرة).. كما يقول المثل الشعبي.
لم يكن في المكتب الذي استأجرته، سوى طاولة، وكرسيين، وتلفون، ولوحة زيتية لرسّام
اسباني تمثل خيولا تركض في البرية..
كان منظر الخيول الراكضة أمامي، يثير حماسي، وطموحي، ويعلمني نشيد الحرية.. وكبرياء
الصهيل..
ورغم بساطة المكتب وتواضعه، فقد كنت أشعر أنني كسرى أنوشروان، أو هانيبعل، أو
يوليوس قيصر..
كنت أشعر، وأنا أرتشف قهوتي كل صباح، أنني ملك الملوك.. وأن كل شيء ما عدا الشعر..
هو باطل الأباطيل..
أعلى
|